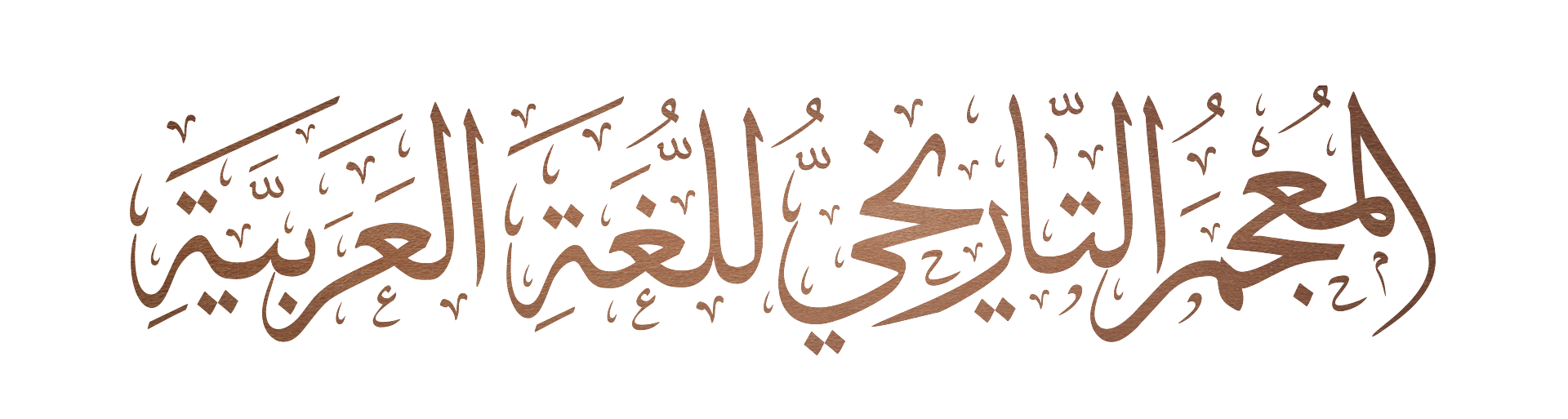
إجمالى عدد الكلمات : 53
وَرَدَ الجَذْرُ (ح ل ل ح ل ل ) في عَدَدٍ مِنَ النُّقوشِ العَربيّةِ الجَنوبِيّةِ، مِنْ بَيْنِها نَقْشٌ سَبَئِيٌّ يَعُودُ تاريخُهُ إلى القَرْنِ الثّالِثِ المِيلادِيِّ (CIH 334/22)، وَرَدَ فيهِ الاسْمُ (ح ل ل ḥll) أيْ: (أسْلابُ القَتيلِ)، فَجاءَ في النَّقْشِ: " و - ح م د م/ ب ذ ت/ .../ ب ت أ و ل ن/ ب و ف ي م/ و - ح ل ل م/ و -س ب ي م/ و -غ ن م م" أيْ: "حَمْدًا (لِلإلَهِ تَألُبَ لِمَنْحِهِ) عَودةً آمِنةً وحُليًّا وغَنائِمَ"
(Beeston, 1976: 48)
كَما وَرَدَ في عَدَدٍ مِنَ النُّقوشِ العَربيّةِ الشَّماليّةِ، مِنْ بَيْنِها نَقْشٌ ثَمودِيٌّ غَيرُ مُؤرَّخٍ، وَرَدَ فيهِ الفِعْلُ ( ح ل ل ḥll) أيْ: ( حَلَّ، سَكَنَ)، فَجاءَ في النَّقْشِ: "ه ت م ع ل و ي ح ل ل" أيْ: "حَلَّ هُتامُ (بْنُ) عَلَوِيّ". وجاءَ في الصَّفائِيّةِ بِمَعْنى خَيَّمَ، يُخَيِّمُ، تَخْيِيمًا.
)Al-Jallad and Jaworska, 2019: 85(الذييب، 2017أ: 39؛
النّظائِرُ السّامِيَّةُ:
احْتَفَظَتِ السَّاميَّاتُ بِهذا الجَذْرِ مِنَ العَرَبِيّةِ الأُمِّ، فَقَدْ وَرَدَ الجَذْرُ (ح ل ل):
في الآراميّة: وَرَدَ الفِعْلُ: חַלֵּיל (حَلّ۪ٮٰل) ḥallēl بِمَعْنى (دنس/ خرج عن كونه حرامًا) ويُوافِقُ الفِعْلَ العَرَبِيَّ (حَلَّل) مَبْنًى ومَعْنًى، ومِنْ مَجيئِهِ بِمَعْنى (دنس) ما وَرَدَ في تَرْجومِ أونكلوسَ: "וּדְלָא אִיתְמַסְכֶּן וְאֶגְנוֹב וַאַחֲלִיל שְׁמֵיהּ דֵאלָהָא"، أيْ: "لئلا أفتقر وأسرق وأدنس اسم الله".
(תר'، מש': ל, ט)
في العِبريّة: وَرَدَ الفِعْلُ: חִלֵּל (حِلّ۪ٮٰـل) ḥillēl بِمَعْنى (انْتَهَكَ الحُرْمةَ، أحَلَّ الحَرامَ) ويُوافِقُ الفِعْلَ العَرَبِيَّ (حَلَّلَ) مَبْنًى ومَعْنًى، ومِنْ مَجيئِهِ بِمَعْنى (أحَلَّ) ما وَرَدَ في سِفْرِ اللّاويينَ: "וְאֹכְלָיו עֲוֺנוֹ יִשָּׂא, כִּי אֶת-קֹדֶשׁ יְהוָה חִלֵּל"، أيْ: "ومَنْ طَعِمَهَا تَحَمَّلَ إثمَهُ، لِأنَّهُ حَلَّلَ ما حَرَّمهُ الرَّبُّ".
(וי' 19: 8)
في السُّرْيانيّة: وَرَدَ الفِعْلُ: ܐܰܚܶܠ (أَحّ۪ل) ʼaḥḥel بِمَعْنى (جَعَلَهُ حَلالًا ومُباحًا) ويُوافِقُ الفِعْلَ العَرَبِيَّ (أَحَلَّ) مَبْنًى ومَعْنًى، ومِنْ مَجيئِهِ بِمَعْنى (أحَلَّ) ما وَرَدَ في إنْجيلِ مَتّى: "ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ"، أيْ: "أَوَ مَا قَرَأْتُمْ في التَّوْرَاةِ أَنَّ الكَهَنَةَ في السَّبْتِ في الهَيْكَلِ يُحِلّونَ السَّبْتَ وهُمْ أَبْرِيَاءُ؟"
(ܡܬܝ ܝܒ: 5)
1. حَلَّ
فعل
1 - 1
* حَلَّ (كَنَصَرَ) فُلانٌ المَكانَ، وبِهِ يَحُلُّ حُلولًا، ومَحَلًّا، وحَلًّا، وحُلَلًا، وتَحْلالًا: نَزَلَهُ وسَكَنَهُ. فهْوَ حالٌّ وحِلٌّ (ج) حُلولٌ، وحُلّالٌ، وحُلَّلٌ.
وبَلِّغْ مُنْبِهًا وابْنَيْ خُنَيْسٍ***وسَعْدَ اللّاتِ والحَيَّ اليَماني
ومَنْ أَمْسى بِحَيِّ بَني صَريحٍ***إِلى حَرْسٍ وحَيِّ بَني عِدانِ
ومَنْ حَلَّ الثَّنِيَّةَ مِنْ كَلاعٍ***إلى بَطْنِ المَناقِبِ والمَثانِ
شعراء عمان في الجاهلية والإسلام. تح: أحمد محمّد عبيد، ص: 83.
إِنَّ مَحَلًّا وإِنَّ مُرْتَحَلًا***وإِنَّ في السَّفْرِ ما مَضى مَهَلا
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 26.
﴿وأَنْتَ حِلٌّ بِهَذا البَلَدِ﴾ (البلد: 2).
«الّذي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ القُرْآنِ إلى آخِرِهِ، كُلَّما حَلَّ ارْتَحَلَ».
مسند الدارمي. تح: حسين سليم أسد، ص: 2181.
وقَدْ أَرى بالجَوِّ حَيًّا حُلَلا***حِلًّا حِلالًا يَرْتَعونَ القُنْبُلا
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 26.
وعِنْدَ حُلولِ الشَّمْسِ بِالحَمَلِ انْتَهى***بِإِسْعادِكَ الإِبْدارُ لِلقَمَرِ السَّعْدِ
ديوان ابن الأبار. تح: عبد السّلام الهرّاس، ص: 172.
"كَما أَنَّ المُسافِرَ إِذا حَلَّ أَوِ ارْتَحَلَ، فقالَ: بِسْمِ اللهِ؛ كانَ المَعْنى: بِسْمِ اللهِ أَحِلُّ، وبِسْمِ اللهِ أَرْتَحِلُ".
سليمان بن عبدالله، تيسير العزيز الحميد. تح: أسامة العتيبي، ص: 111.
1 - 2
وــــــــــ على الحُكْمِ حَلاًّ وحُلولًا: أَذْعَنَ لَهُ.
ذَهَبَ الصُّلْحُ أَو تَرُدّوا كُلَيبًا***أَو تَحُلّوا عَلى الحُكومَةِ حَلَّا
ديوان مهلهل. تح: طلال حرب، ص: 60.
1 - 3
وــــــــــ عَنْ فُلانٍ: تَرَكَهُ وابْتَعَدَ عَنْهُ.
وثَقيلٍ قالَ: صِفْني***قُلْتُ: إِيش فيكَ أَصِفْ
كُلُّ ما فيكَ ثَقيلٌ***حُلَّ عَنّي وانْصَرِفْ
يوسف بن محمد الشربيني، هز القحوف. مطبعة بولاق، ص: 29.
"أَما حَلَفَ بِحَياةِ كُلِّ آلِهَتِهِ اللّاتينِيَّةِ نَسْلِ الأَوْغادِ حُلّوا عَنّي- ابْعُدوا".
ليو ولص، كتاب بزوغ النور على ابن حور. تر: كرنيليوس ڤانديك، مطبعة المقتطف، ص: 202.
1 - 4
وــــــــــ العُقْدَةَ حَلًّا: فكَّها ونَقَضَها، فهْوَ حَلّالٌ.
فصالَتْ مِنهُم الأَملاكُ فيهِمْ***بِمُرْهَفَةٍ تَحُلُّ عُرى المِتانِ
شعراء عمان في الجاهلية والإسلام. تح: أحمد محمّد عبيد، ص: 85.
﴿واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي﴾ (طه: 27).
«لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِها».
مسند أحمد. تح: شعيب الأرناؤوط، ج: 18، ص: 15.
فلا تَيْأَسا واسْتَغْوِرا اللهَ إِنَّهُ***إِذا اللهُ سَنّى حَلَّ عَقْدٍ تَيَسَّرا
[اسْتَغْورا: سَلا الغيرَة وهي الميرة]
أبو عبيد البكري، سمط اللآلي. تح: عبد العزيز الميمني، ج: 1، ص: 537.
تَلومُ ابْنَةُ السَّعْدِيِّ في حَلِّ عُقْدَةٍ***شَرَيْتُ بِها وُدَّ العَشيرَةِ أَوْ مَجْدا
ديوان بشار بن برد. تح: إحسان عباس، ص: 267.
"يُقالُ سَبَتَتِ المَرْأةُ شَعْرَها: إذا حَلَّتْهُ وأرْسَلَتْهُ".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 22، ص: 7.
"أيْ بِأَنْ حَلَّ عَنْهُ عُقْدَةَ الصَّمْتِ، الَّتي أَوْجَبَها الاسْتِغْناءُ بِالأَغْيارِ، وعَدَمُ رُؤْيَةِ الافْتِقارِ".
الشّرقاوي، المنح القدسيّة. تح: أحمد المزيدي، ص: 65.
1 - 5
وــــــــــ فُلانًا، وإِلَيْهِ، وبِهِ، وعَلَيْهِ حَلًّا، وحَلَلًا، وحُلولًا: نَزَلَ بِدِيارِهِ وجاوَرَهُ.
رَحْبُ الفِناءِ لَوْ أَنَّ النّاسَ كُلَّهُمُ***حَلّوا إِلَيْهِ إِلى أَنْ يَنْقَضِي الأَبَدُ
ما زالَ في سَيْبِهِ سَجْلٌ يَعُمُّهُمُ***ما دامَ في الأَرضِ مِنْ أَوْتادِها وتِدُ
ديوان زهير بن أبي سلمى. دار الكتب العلمية، ص: 44.
مَتى أَدْعُ مِنهُمْ ناصِريْ تَأْتِ مِنْهُمُ***كَراديسُ مَأْمونٌ عَلَيَّ خُذولُها
رِعالًا كَأَمْثالِ الجَرادِ لِخَيلِهِمْ***عُكوبٌ إِذا ثابَتْ سَريعٌ نُزولُها
فإِنّي بِحَمْدِ اللهِ لَمْ أَفتَقِدْكُمُ***إِذا ضَمَّ هَمّامًا إِلَيَّ حُلولُها
كتاب الصبح المنير في أشعار أبي بصير الأعشى، والأعشَين الآخرين. ص: 123.
لَيْثُ غابٍ فيهِ لِلْ***أَقْرانِ حُكْمٌ واعْتِسارُ
فإِذا حَلَّ بِقَوْمٍ***فبِهِمْ حَلَّ البَوارُ
إبراهيم النّجّار، شعراء عبّاسيّون منسيّون. ج: 5، ص: 99.
"وحَلَّهُ واحْتَلَّ بِهِ واحْتَلَّهُ: نَزَلَ بِهِ (…)، وكَذلِكَ حَلَّ بِالقَوْمِ وحَلَّهُمْ واحْتَلَّ بِهِمْ، واحْتَلَّهُمْ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 295.
حَلَلْتُ بِهِ مُسْتَنْصِرًا بِجَنابِهِ***وعاهَدْتُ نَفْسي أَنَّني لا أَريمُهُ
عَلى قَبْرِهِ الزّاكي وَقَفْتُ مَطامِعي***فمَنْ نالَني بالضَّيْمِ أَنْتَ خَصيمُهُ
ديوان ابن الخطيب. تح: محمّد مفتاح، ج: 2، ص: 552.
مَدَدْتُ كَفَّ الرَّجا أَرْجو مَراحِمَهُ***وقَدْ حَلَلْتُ بِهِ في شَهْرِهِ الحُرُمِ
مُحَمَّدُ المُصْطَفى مِشْكاةُ رَحْمَتِنا***مِصْباحُ حُجَّتِنا في بِعْثَةِ الأُمَمِ
زينب فواز العاملي، الدر المنثور، موسسة هنداوي، ص: 519.
1 - 6
وــــــــــ بفُلانٍ مَكانًا: جَعَلَهُ يَنْزِلُ به.
دِيارُ الَّتي كادَتْ ونَحْنُ عَلى مِنًى***تَحُلُّ بِنا لَوْلا نَجاءُ الرَّكائِبِ
ديوان قيس بن الخطيم. تح: إبراهيم السامرائي، وآخر، ص: 31.
"حتّى كادَتْ تَحُلُّ بِنا لِقُرْبِها مِنْ قُلوبِنا، لَوْلا أَنَّ رَكائِبَنا أَسْرَعَتْ ومَضَتْ بِنا مِنْ هَذا المَوْضِعِ".
ابن الأنباري، كتاب الأضداد. تح: أبو الفضل إبراهيم، ص: 287.
"وحَلَّ بِهِ: جَعَلَهُ يَحُلُّ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 295.
1 - 7
وــــــــــ العَطاءَ: بَذَلَهُ ويَسَّرَهُ. (ولَمْ يُسْتَعْمَلْ هَذا الفِعْلُ بِهَذا المَعْنى مِنْ قَبْلُ، واسْتُعْمِلَ المُشْتَقُّ مِنْهُ)
"اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مُفْتَسَحًا في عَدْلِكَ، واجْزِهِ مَضاعَفاتِ الخَيْرِ مِنْ فضْلِكَ لَهُ، مُهَنِّئاتٍ غَيْرَ مُكَدِّراتٍ، مِنْ فوْزِ ثَوابِكَ المَضْنونِ، وجَزْلِ عَطائِكَ المَحْلولِ".
محمد النميري، كتاب الإعلام. تح: حسين شكري، ص: 53.
"وأَمّا قَوْلُهُ: "وجَزْلِ عَطائِكَ المَحْلولِ" فإِنَّهُ يَعْني بِالمَحْلولِ: المَبْذولِ".
الطبري، تهذيب الآثار. تح: علي إبراهيم مصطفى، ج: 2، ص: 371.
1 - 8
وــــــــــ الجامِدَ: فكَّكَهُ وأَذابَهُ.
"فتَراهُ كَيْفَ يَرُضُّهُ ويُفَتِّتُهُ، ثمّ إٍنْ مانَعَهُ بَعْضَ المُمانَعَةِ، ووافَقَ مِنْهُ بَعْضَ الجوعِ كَيْفَ يَبْتَلِعُهُ وهُوَ واثِقٌ بِاسْتِمْرائِهِ وهَضْمِهِ، أَوْ بِإِذابَتِهِ وحَلِّهِ".
الجاحظ، كتاب الحيوان. تح: عيون السود، ج: 1، ص: 354.
"ويُقالُ: إِذا شُرِبَ مِنْهُ يَسيرٌ جِدًّا قَدْرَ أَرْبَعِ شَعيراتٍ مَحْلولاتٍ بِماءٍ، سَكَّنَ الأَوْرامَ الحارَّةَ والدَّمَ".
يوسف التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة. دار الكتب العلمية، ص: 385.
"ولَمْ نَزَلْ نَرْشُفُ مِنْها ذَوْبَ المِسْكِ ومَحْلولَ السَّبَجِ حَتّى جاءَتْنا قَصَباتُ السَّبْقِ لِلسُّرورِ تُنادي ما عَلى مَنْ أَحْرَزَ قَصَباتٍ وتاهَ مِنْ حَرَجٍ".
البربير، المفاخرات والمناظرات. تح: الطيان، ص: 43.
1 - 9
وــــــــــ الإِقْطاعَ عَنْ فُلانٍ: اعْتَصَرَهُ مِنْهُ ورَدَّهُ لِلدَّوْلَةِ.
"وفي هَذِهِ السَّنَةِ شَغَبَ الدَّيْلَمُ عَلى مُعِزِّ الدَّوْلَةِ (...) فاضْطُرَّ إِلى خَبْطِ النّاسِ اسْتِخْراجِ الأَمْوالِ مِنْ غَيْرِ وُجوهِها، فأَقْطَعَ قُوّادَهُ وخَواصَّهُ وأَتْراكَهُ ضياعَ السُّلْطانِ وضِياعَ المُسْتَتِرينَ (...) وبَقِيَ اليَسيرُ مِنْهُ مِنَ المَحلولِ فضَمَّنَ واسْتَغْنى عَنْ أَكْثَرِ الدَّواوينِ".
مسكويه، تجارب الأمم. تح: سيد كسروي حسن، ج: 5، ص: 281.
"وتَوَجَّهَ الأَميرُ عَلاءُ الدّيْنِ الطُّنْبُغا إِلى الأَبْوابِ السُّلْطانِيَّةِ (...) وخَلَعَ عَلَيْهِ السُّلْطانُ عَلى عادَتِهِ تَشْريفًا وحياصَةً، وأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وأَسْكَنَهُ بِقَلْعَةِ الجَبَلِ، وأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ مِائَةِ فارِسٍ مِنْ جُمْلَةِ الإِقْطاعِ المَحْلولِ عَنِ الأَميرِ سَيْفِ الدّيْنِ أَرَغون".
النويري، نهاية الأرب. تح: مفيد قميحة وآخرين، ج: 33، ص: 166.
"إِذا كانَ لِلمَيِّتِ شَيْءٌ مِنَ الصُّرِّ والحَبِّ ووَرَدَ ذلِكَ عَنِ السِّنينَ الماضيةِ في حَياتِهِ، وفي السَّنَةِ الّتي ماتَ فيها فإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ نَصيبَهُ مِنْهُ، وإنْ كانَ مَبَرَّةً مِنَ السُّلْطانِ صارَ نَصيبُهُ في حُكْمِ المَحْلولِ".
قدري باشا، قانون العدل والإنصاف. تح: عبد الله نذير، ص: 174.
1 - 10
وــــــــــ الإشْكالَ ونَحْوَهُ: أَزالَ تَعْقيدَهُ وأَوْضَحَهُ.
"وامْتَرى امْتِراءً إِذا اسْتَخْرَجَ الشُّبَهَ المُشْكِلَةَ مِنْ غَيْرِ حَلٍّ لَها".
أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة. تح: جمال مدغمش، ص: 149.
"وفي حَلِّ هذا الإِشْكالِ كِتابٌ لَطيفٌ مُحَرَّرٌ، مُنْتَظَمٌ مِنْ عِدَّةِ كُتُبٍ، ومُرْبٍ عَلَيْها فوائِدَ".
أبو شامة المقدسي، البسملة. تح: عدنان الحموي، ص: 107.
"وها أَنا أَذْكُرُ ذلِكَ بِعِبارَةٍ مَحْلولَةٍ، يَفْهَمُها المُبْتَدِئُ كَما يَفْهَمُها المُنْتَهي".
إدريس الودغيري، التوضيح و البيان. تح: عبد العزيز العمراوي، ص: 253.
1 - 11
وــــــــــ السُّؤالَ: أَجابَ عَنْهُ.
"وهُوَ مِمّا يَعْسُرُ دَفْعُهُ عَلى الخُصوم، ويَصْعُبُ حَلُّهُ عَلى أَرْبابِ الفُهومِ".
الآمديّ، غاية المرام. تح: أحمد المزيدي، ج: 1، ص: 213.
"يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ جَوابَ سُؤالٍ مُقَدَّرٍ ناشِئٍ مِنْ إِثْباتِ تَوَحُّدِه سُبْحانَهُ في الأُلوهِيَّةِ (...) كَأَنَّهُ قيلَ إِذا كانَ اللهُ تَعالى هُوَ الإِلهُ الخالِقُ المُتَصَرِّفُ فلِمَ خَلَقَ أُولئِكَ الكَفَرَةَ ولَمْ يَصْرِفْهُمْ عَمّا يَقولونَ (...) ووَجْهُ حَلِّ السُّؤالِ النّاشِئِ مِمّا تَقَدَّمَ، بِناءً عَلى ما يُشيرُ إِلَيْهِ هَذا الجَوابُ الإِجْماليُّ، أَنَّهُ تَعالى خَلَقَ الكَفَرَةَ، بَلْ جَميعَ المُكَلَّفينَ عَلى حَسَبِ ما عَلِمَهُمْ مِمّا هُمْ عَلَيْهِ في أَنْفُسِهِم".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: محمّد معتز، ج: 17، ص: 60.
1 - 12
وــــــــــ الكَلامَ المَنْظومَ: جَعَلَهُ نَثْرًا بِأَلْفاظٍ جديدَةٍ غالبًا، مَعَ المُحافَظَةِ عَلى المَعْنى.
"وهذا المَعْنى المُشارُ إِلَيْهِ في وصْفِ القَلَمِ أَوْرَدْتُهُ بِعِبارَةٍ أُخْرى عَلى وجْهٍ آخَر، ونَبَّهْتُ عَلَيْهِ في كِتابِ (الوَشْيِ المَرْقومِ في حَلِّ المَنْظومِ)، وهذا كِتابٌ أَلَّفْتُهُ في صِناعَةِ حَلِّ الشِّعْرِ وغَيْرِهِ".
ابن الأثير الكاتب، المثل السائر. تح: أحمد الحوفي، وآخر، ج: 2، ص: 37.
"أَقولُ: إِنَّهُ هُنا في مَقامِ تَعْظيمٍ لِما أَتى بِهِ في فنَّ الكِتابَةِ مِنْ حَلِّ المَنْظومِ والآياتِ الكَريْمَةِ".
الصفدي، نصرة الثائر على المثل السائر. تح: محمد سلطاني، ص: 101.
"كِتابُ (الوَشْيِ المَرْقومِ في حَلِّ المَنْظومِ): هُوَ مِنْ خيرَةِ كُتُبِ الأَدَبِ، رَتَّبَهُ عَلى مُقَدِّمَةٍ وثَلاثَةِ فُصولٍ؛ الأَوَّلُ في حَلِّ الشِّعْرِ، والثّاني في حَلِّ آياتِ القُرآنِ، والثّالِثِ في حَلِّ الأَخْبارِ النَّبَوِيَّةِ".
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية. ص: 841.
1 - 13
وــــــــــ الوَقْفَ: أَزالَ عَنْهُ صِفَةَ الوَقْفيَّةِ؛ فأَمْكَنَ الانْتِفاعُ بِهِ كسائِرِ الأَمْلاكِ بِالبَيْعِ وغَيْرِهِ.
"رَحْبةُ آقوش: هذِهِ الرَّحْبَةُ بِحارَةِ بَرْجوانَ تِجاهَ قاعَةِ الأَميرِ جَمالِ الدّينِ آقّوشَ الرّوميِّ. الّتي حَلَّ وقْفَها بَهاءُ الدّينِ مُحَمَّدُ بنُ البُرْجيِّ، ثُمَّ بيعَتْ مِنْ بَعْدِهِ".
المقريزي، المواعظ والاعتبار. تح: أيمن فؤاد سيد، ج: 3، ص: 157.
"وَقَفَها عَلى مَدْرَسَتِهِ الّتي بِالجَمّاليَّةِ ثُمَّ حَلَّ وقْفَها جَمالُ الدّينِ يوسُفُ".
علي مبارك باشا، الخطط التوفيقية الجديدة. ج: 3، ص: 21.
1 - 14
وــــــــــ المُعادَلَةَ الرِّياضِيَّةَ: أَوْجَدَ قيمَةَ أَوْ قِيَمَ المَجْهولِ فيها (مِثْلَ: س) الّتي تجْعَلُ طَرَفَيْها مُتَساوِيَيْنِ.
"حَلُّ المُعادَلَةِ هُوَ تَبْيينُ مِقْدارِ مَجْهولِها، أَوْ مَقاديرِ مَجْهولاتِها إِنْ كانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلى مُجْهولاتٍ مُتعَدِّدَةٍ، بِواسِطَةِ البَحْثِ عَنْ ذلِكَ، فإِذا وُجِدَتْ تِلْكَ المَقادِيْرُ انْحَلَّتِ المُعادَلَةُ".
ماير، كتاب الجبر والمقابلة، ترجمة: محمد بيومي، مطبعة بولاق، 1256ه، ص: 56.
1 - 15
وــــــــــ الحَريرَ: اسْتَلَّ خُيوطَهُ بَعْدَ فكِّ شَرانِقِ القّزِّ وطَبْخِها لِإذابَةِ المادَّةِ الصِّمْغيَّةِ المُلْتَصِقَةِ بِها.
"دَرَسَ صِناعَةَ حَلِّ الحَريرِ دَرْسًا مُدَقَّقًا بِالنَّظَرِ والعَمَلِ، وظَلَّ عِشرينَ سَنَةً يَبْحَثُ ويَصْنَعُ الآلاتِ ويُغَيِّرُها ويُبَدِّلُها حَتّى اهْتَدى إِلى آلةٍ وافِيَةٍ بِالمُرادِ"
مجلة المقتطف، العدد: 3، آذار 1902م، ج: 27، ص: 207.
1 - 16
وــــــــــ الشَّرِكَةَ ونَحْوَها: أَوْقَفَ نَشاطَها، وأَلْغى سِجِلَّها التِّجارِيَّ الرَّسْمِيَّ بِقَرارٍ قَضائِيِّ أَوْ إِدارِيٍّ. (مح)
"حَكَمَتِ المَحْكَمَةِ ثانِيَةً بِحَلِّ شَرِكَةِ الزَّيْتِ، فادَّعى رُكْفِلَرُ أَنَّهُ أَذْعَنَ لِحُكْمِه، غَيْرَ أَنَّ إِذْعانَهُ كانَ وهْميًّا؛ فإِنَّهُ أَبْدَلَ أَسْهُمَ الشَّرِكَةِ بِأَسْهُمٍ أُخْرى".
مجلة المقتطف، عدد تموز (يوليو) 1901، ج: 26، ص: 676.
1 - 17
وــــــــــ كِيانًا ذا سُلْطَةٍ وصَلاحِيّاتٍ: أَلْغاهُ وأَبْطَلَ سُلْطَتَهُ.
"وقَدْ كانَ سَبَبُ حَلِّ المَجْلِسِ على ما هُوَ مَشْهورٌ مَوْقِفَ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ نَفْسِهِ مِنْ قَضِيَّةِ رِئاسَةِ الجُمْهورِيَّةِ؛ فإِنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ رَشَّحَ نَفْسَهُ لِرئاسَةِ الجُمْهورِيَّةِ وأَيَّدَهُ في تَرْشيحِهِ أَكْثَرُ النُّوابِ".
مجلة المنار، العدد: 7، مج: 34، 1935، ص: 555.
1 - 18
o وحَلَّ فُلانٌ زَبْنًا عَنْ قَوْمِهِ وزِبْنًا: تَباعَدَ عَنْ بُيوتِهِمْ.
"حَلَّ فُلانٌ زَبْنًا عَنْ قَوْمِهِ وزِبْنًا: تَباعَدَ عَنْ بُيوتِهِمْ".
ابن دريد، الجمهرة. تح: بعلبكي، ص: 335.
1 - 19
وــــــــــ (كَنَصَرَ، وضَرَبَ) الأَمْرُ والعَذابُ بِفُلانٍ، وعَلَيْهِ، يَحُلُّ ويَحِلُّ حُلولًا: وقَعَ بِهِ.
﴿كُلوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ولا تَطْغَوْا فيهِ فيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ﴾ (طه: 81).
ورُوِيَ عنِ: النَّبِيِّ ﷺ (ت: 11ه=632م):
«إذا فعلَتْ أُمَّتي خمْسَ عشْرةَ خَصلةً حَلَّ بها البلاءُ»
سنن التّرمذي. تح: شعيب الأرنؤوط وآخر، ج: 4، ص: 274.
وإِذا تَحُلُّ بِنا الحَوادِثُ مَنْ لَنا***بِالوَحْيِ مِنْ رَبٍّ سَميعٍ نَسْمَعُ
محمد بن داود الأصبهاني، الزهرة. تح: ابراهيم السامرائي، ص: 507.
"فأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلى حائِطٍ مِنْ حيطانِها لِيَسْتَريحَ مِمّا حَلَّ بِهِ مِنَ الهَوْلِ والإِعْياءِ".
ابن المقفع، كليلة ودمنة. المطبعة الأميرية، ص: 95.
"والمُوَحِّدُ المُعَذَّبُ في شُغُلٍ عَنْ هذا بِالعِذابِ الّذي قَدْ حَلَّ بِهِ، وإنَّما العَرَقُ الّذي يَظْهَرُ لِمَنْ حَلَّتْ بِهِ الرَّحْمَةُ".
القرطبي، مختصر التذكرة القرطبي. تح: فتحي الجندي، ص: 24.
ولَسْنا نُبَرّي النَّفْسَ مِنْ أَمْرِ سوئِها***ولَوْلاهُ ما حَلَّتْ عَلَيْنا الفَجائِعُ
عبد العزيز آل معمر، منحة القريب المجيب. تح: محمد السكاكر، ص: 49.
1 - 20
وــــــــــ المَرْأةُ لِلأَزْواجِ حِلاًّ، وحُلولاً، وحَلالاً: زالَ المانِعُ الّذي كانَتْ مُتَّصِفَةً بِهِ، وجازَ تَزَوُّجُها.
﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ (البَقَرَةُ: 230).
«لا تَحِلُّ لي، يَحْرُمُ مِنِ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخي مِنَ الرِّضاعَةِ».
صحيح البخاريّ. تح: صدقي العطّار، ص: 636.
"إِنَّها لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
مالك بن أنس، الموطأ. تح: الأعظمي، ج: 2، ص: 770.
"لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّها أَبَدًا، ولا تَحِلُّ لأَبيهِ، ولا لابْنِهِ، ولا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".
مالك بن أنس، الموطأ. تح: الأعظمي، ج: 2، ص: 764.
"ولَوْ نَكَحَ المُسْلِمُ حَرْبيَّةً، ففي إِرْقاقِها وَجْهانِ، فإِنْ أَجَزْناهُ فأُرِقَّتْ، فإِنْ كانَ قَبْلَ الدُّخولِ، انْفَسَخَ النِّكاحُ؛ إذ لا تَحِلُّ الأَمَةُ الكِتابِيَّةُ لِمُسْلِمٍ، وإِنْ كانَ بَعْدَ الدُّخولِ، ففي انْفِساخِهِ وَجْهانِ".
العز ابن عبد السَّلام، الغاية في اختصار النهاية. تح: إياد خالد الطباع، وآخر، ج: 8، ص: 286.
"إنْ أُريدَ بِالنِّكاحِ فِي الآيَةِ الوَطْءُ كانَ مَجازًا عَقْلِيًّا؛ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ الفِعْلِ مِنْها، وإِنْ أُريدَ بِهِ العَقْدُ كانَ مَجازًا لُغَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ حَقيقَةُ الوَطْءِ فحَمْلُ الآيَةِ عَلى أَحَدِهِما تَرْجيحٌ بِلا مُرَجِّحٍ بَلْ قَدْ يُقالُ إنَّ حَمْلَها عَلى الوَطْءِ أَنْسَبُ بِالواقِعِ، فإِنَّ الـمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لا تَحِلُّ بِدونِ وَطْءِ المُحَلِّلِ، اللَّهُمَّ إلّا أَنْ يُقالَ: الـمُرَجِّحُ كَثْرَةُ الاسْتِعْمالِ".
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار. تح: عادلعبد الوجود وآخر، ج: 4، ص: 63.
1 - 21
وــــــــــ لِفُلانٍ وعَلَيْهِ الأَمْرُ: وجَبَ.
«فمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفاعَةُ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 11، ص: 128.
شُلَّتْ يَمينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا**حَلَّتْ عَليْكَ عُقوبَةُ المُتَعَمِّدِ
سيف بن عمر، كتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل. تح: قاسم السامرائي، ص: 365.
"وحَلَّتِ العُقوبَةُ عَلَيْهِ تَحِلُّ: وجَبَتْ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 28.
1 - 22
وــــــــــ (كَضَرَبَ) الشَّهْرُ يَحِلُّ حِلًّا، وحَلالًا: أُبيحَ فيهِ ما يَحْرُمُ في غَيْرِهِ مِنْ قَتالٍ ونَحْوِهِ، فهُوَ حِلٌّ.
قَتَلوا كُلَيْبًا ثُمَّ قالوا أَرْبِعوا***كَذَبوا ورَبِّ الحِلِّ والإِحرامِ
ديوان المهلهل. تح: أنطوان القوال، ص: 80.
ونَحْنُ النّاسِئونَ عَلى مَعَدٍّ***شُهورَ الحِلِّ نَجْعَلُها حَراما
ديوان الكميت. تح: محمّد نبيل طريفي، ص: 421.
"والنَّسَأَةُ: الذينَ كانوا يَنْسَؤونَ الشُّهورَ عَلى العَرَبِ في الجاهِلِيَّةِ، فيُحِلُونَ الشَّهْرَ مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ، ويُحَرِّمُونَ مَكانَهُ الشَّهْرَ مِنْ أَشْهُرِ الحِلِّ".
ابن إسحاق، السيرة النبوية. تح: أحمد فريد المزيدي، ص: 42.
"وكانَ جُمْلَةُ ما يَعْتَقِدونَهُ مِنَ الدّينِ تَعْظيمُ الأَشْهُرِ الحُرُمِ الأَرْبَعَةِ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ فيها مِنَ القِتالِ، وكانَتْ قبائِلُ مِنْهُمْ يَسْتَبيحونَها فإِذا قاتَلوا فى شَهْرٍ حَرامٍ، حَرَّموا مَكانَهُ شَهْرًا مِنْ أَشْهُرِ الحِلِّ، ويَقولونَ: نُسِئَ الشَّهْرُ".
النويري، نهاية الأرب. تح: مفيد قميحة وآخرين، ج: 1، ص: 155.
"ذلِكَ أَنَّ العَرَبَ كانَتْ إِذا انْصَرَفَتْ مِنَ المَوْسِمِ فأَرادَتْ حَرْبًا أو غَزْوًا أَتَتِ النَّسيئَةَ فأَحلَّتَ لَها شَهْرًا مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ، وجَعَلَتْ مَحَلَّهُ شَهْرًا مِنْ أَشْهُرِ الحِلِّ".
المختار الكنتي، فتح الودود. تح: مأمون محمد، ص: 120.
1 - 23
وــــــــــ الأَمْرُ: صارَ جائِزًا مُباحًا.
حَرُمَتْ كاسٌ عَلى ناذِرِها***فلَقَدْ طابَتْ بِأَنْ حَلَّ العُقارْ
شعر الفند الزماني. تح: حاتم الضامن، ص: 14.
﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ﴾. (البقرة:228)
«هُوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
مالك بن أنس، الموطأ. تح: الأعظمي، ص: 30.
وإنْ يَرْجِعوا عَنْ كُفْرِهِمْ وعُقوقِهِمْ***فما طَيِّباتُ الحِلِّ مِثْلُ الخَبائِثِ
ديوان أبي بكر الصِّدِّيق. تح: راجي الأسمر، ص: 22.
"ولا تَمَنَّ ما لا يَحِلُّ لَكَ".
جعفر الصادق، مصباح الشريعة "منسوب له". ص: 48.
قُلوبُنا أَوْعِيَةٌ فكُلَّما***طابَ الوِعى قَدْ طابَ ما قَدْ حَلَّ لَهْ
العز ابن عبد السَّلام، زُبَدُ خلاصة التّصوّف. تح: أحمد عبد الرّحيم السّايح، وآخر، ص: 165.
"عَلى أَنَّ المَقْصودَ الأَهَمَّ مِنْ بِعْثَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، بَيانُ الحِلِّ والحُرْمَةِ، والصِّحَّةِ والفَسادِ، ونَحْوِ ذلِكَ".
محمد مصطفى الرومي ، منتهى الكلام. تح: حسن آل أيوب، ص: 295.
1 - 24
وــــــــــ اليَمينُ: بَرَّتْ.
لَمْ أَرَ خَيْلًا مِثْلَها يَوْمَ أَدْرَكَتْ***بَني شَمَجي خَلْفَ اللُّهَيْمِ على ظَهْرِعَشِيَّةَ قَطَّعْنا قَرائِنَ بَيْنِنا***بِأَسْيافِنا والشّاهِدونَ بَنو بَدْرِفأَصْبَحْتُ قَدْ حَلَّتْ يَميني وأَدْرَكَتْ***بَنو ثُعَلٍ تَبْلي وراجَعَني شِعْري
شعر طيِّئ وأخبارها في الجاهلية والإسلام. تح: وفاء السنديوني، ص: 465.
أَحَلَّ هُرَيْمٌ يَوْمَ بابِلَ بِالقَنا***نُذورَ نِساءٍ مِنْ تَميمٍ فحَلَّتِ
ديوان الفرزدق. تح: علي فاعور، ص: 103.
"فلَمّا كانَ بِالسَّحَرِ خَرَجَ أَبو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍ فمَرّ بِالعُرَيْضِ، وبَيْنَهُ وبَيْنَ المَدينَةِ نَحْوُ ثَلاثَةِ أَمْيالٍ، فقَتَلَ بِهِ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ وأَجيرًا لَهُ، وحَرَّقَ أَبْياتًا هُناك وتِبْنًا، ورَأى أَنَّ يَميْنَهُ قَدْ حَلَّتْ، ثُمَّ ولّى هارِبًا".
ابن سعد، الطبقات الكبرى. تح: علي محمد عمر، ج: 2، ص: 27.
"وحَلَّتِ اليَمينُ: بَرَّتْ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير. تح: عبد الشناوي، ص: 147.
1 - 25
وــــــــــ فُلانٌ اليَمينَ حِلًّا، وحَلًّا: كَفَّرها، أَو فعَلَ ما يُخْرِجُهُ مِنْ حِنْثِها.
حِلًّا أَبَيْتَ اللَّعْنَ حِـلْ***ـلًا إِنَّ فيما قُلْتَ آمَهْ
ديوان عبيد بن الأبرص. تح: أشرف عدرة، ص: 109.
حَلَلْتُ بِهِ وِتْرِي ولَمْ أَنْسَ ذَخْلَهُ***إِذا ما تَناسى ذَحْلَهُ كُلُّ عَيْهَبِ
ابن هشام، السيرة النبوية. تح: عمر تدمري، ج: 2، ص: 254.
"وإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ في صَرْفِهِ إِلى الفِعْلِ ولا إِلى نَفْسِ الطَّلاقِ فلا أَعْرِفُ في ذلِكَ نَصَّ رِوايَةٍ. والّذي يُوجِبُهُ النَّظَرُ عِنْدي أَنْ يَكون مَصْروفًا إِلى الفِعْلِ إِذا قَصَدَ بِهِ حَلَّ اليَمينِ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 5، ص: 222.
"وقَدِ اخْتَلَفَ مُتَأَخِّرو المَذْهَبِ في الاستِثْناءِ هَلْ هُوَ حَلٌّ لِليَمينِ المُنْعَقِدَةِ، أَو ْمانِعٌ لَها مِنَ الانْعِقادِ".
ابن بزيزة، روضة المستبين. تح: عبد اللّطيف زكّاغ، ص: 642.
1 - 26
وــــــــــ الدَّيْنُ حُلولًا، ومَحِلًّا: انْتَهى أَجَلُهُ وحانَ وقْتُ أَدائِهِ.
يا عَبْلَ قَدْ هامَ الفُؤادُ بِذِكْرِكُمْ***وأَرى دُيوني ما يَحِلُّ قَضاها
ديوان عنترة. تح: حمدو طمّاس، ص: 187.
"فلَمّا كانَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ خَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ في جَنازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، ومَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ في نَفَرٍ مِنْ أَصْحابِهِ، فلَمّا صَلَّى عَلى الجِنازَةِ، ودَنا مِنْ جِدارٍ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ أَتَيْتُهُ، فنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَليظٍ".
الفسوي، المعرفة والتاريخ. تح: أكرم العمري، ج: 1، ص: 302.
«إنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجالٍ مَضْروبَةٍ، وأَرْزاقٍ مَقْسومَةٍ، وآثارٍ مَبْلوغَةٍ، لا يُعَجَّلُ مِنْها شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ، ولا يُؤَخَّرُ مِنْها شَيْءٌ بَعْدَ حِلِّهِ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 7، ص: 40.
"والدَّنانيرُ والدَّراهِمُ إنْ حَلَّتْ آجالُها فلا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ لَمْ تَحِلَّ وكانَتْ آجالُهُما واحِدَةً فلا خَيْرَ فيهِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ إلى أَجَلٍ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 3، ص: 183.
"لِلحَجْرِ أَرْبَعَةُ أَحْكامٍ: التَّصَرُّفُ في المالِ باِلتَّفْويتِ، والثّاني: حُلولُ دَيْنِهِ، وبَيْعُ مالِهِ وقِسْمَتُهُ عَلى الغُرَماءِ...".
ابن بزيزة، روضة المستبين. تح: عبد اللّطيف زكّاغ، ص: 1117.
"أَمّا الجاهِلِيُّ فكانَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ لِلرَّجُلِ أَوْ يُدايِنُهُ، فإِذا حَلَّ الأَجَلُ يُلْزِمُهُ، فيقولُ لَهُ: إِمّا أَنْ يَقْضِيَهُ ناجِزًا، وإِمّا أَنْ يَزيدَ لَهُ في الثَّمَنِ إِلى أَجَلٍ".
المختار الكنتي، فتح الودود. تح: مأمون محمد، ص: 471.
1 - 27
وــــــــــ المُحْرِمُ: خَرَجَ مِنْ إحْرامِهِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ، وجازَ لَهُ ما كانَ مَمْنوعًا مِنْهُ. فهُوَ حَلالٌ، وحِلٌّ.
﴿وإِذا حَلَلْتُمْ فاصْطادوا﴾. (المائدة:2)
«إِذا أَهَلَّ الرَّجلُ بِالحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فطافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ فقَدْ حَلَّ وهْيَ عُمْرَةٌ».
سنن أبي داود. تح: شعيب الأرناؤوط، وآخرين، ج: 3، ص: 200.
"كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ في ما بَيْنَ مَكَّةَ والمَدينَةِ وهُمْ مُحْرِمونَ، وأَنا رَجُلٌ حِلٌّ على فرَسٍ".
البخاري، الصحيح. تح: العطّار، ص: 447.
"ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ ناسٍ لِحُرْمِهِ ولا مُريدَ غَيْرِهِ، فقَدْ حَلَّ، ولَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةً".
تفسير ابن جريج. تح: علي عبدالغني، ص: 116.
وبَعْدَ تَمامِ الحَجِّ والنُّسْكِ كُلِّها***حَلَلْنا وباقي عيسِنا قَدْ أَنَخْناهُ فمَنْ شاءَ وافى الصَّيْدَ والطّيبَ والنِّسا***فقَدْ تَمَّ حَجٌّ لِلْإِلَهِ حَجَجْناهُ
ابن رُشَيْد البغدادي، القصيدة الذهبية. دار ابن الجوزي، ص: 68.
"قوله: (أَنْ نُحْرِمَ إِذا تَوَجَّهْنا إِلى مِنًى) فيه دَليلٌ عَلى أَنَّ مَنْ حَلَّ مِنَ إِحْرامِهِ يُحْرِمُ بِالحَجَّ إِذا تَوَجَّهَ إِلى مِنى".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد حلاق، ج: 9، ص: 307.
1 - 28
وــــــــــ الهَدْيُ حِلًّا، وحِلَّةً، وحُلولًا: وجَبَ نَحْرُهُ وذلِكَ بِبُلوغِهِ مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ.
﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَروا وصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ والهَدْيَ مَعْكوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (الفتح: 25).
"لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لَما سُقْتُ الهَدْيَ ولَكِنَّنِي لَبَّدْتُ رَأْسي وسُقْت هَدْيي فلَيْسَ لي مَحِلٌّ دُونَ مَحِلِّ هَدْيي».
الشافعي، الأم. تح: محمد زهري النجار، ج: 2، ص: 127.
"إنْ نَأْخُذْ بِكِتابِ اللَّهِ، فإنَّهُ يَأْمُرُنا بِالتَّمامِ، قالَ تَعالى: ﴿وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ".
مسند أبي داود. تح: التركي، ج: 1، ص: 416.
"ويَحِلُّ الهَدْيُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى".
ابن عباد، المحيط. تح: آل ياسين، ج: 2، ص: 314.
"إِنْ تَلِفَ الهَدْيُ المَنْذورُ أَوِ الأُضْحِيَةُ المَنْذورَةُ قَبْلَ المَحِلِّ بِتَفْريطٍ لَزِمَهُ ضَمانُهُ".
النووي، المجموع شرح المهذب. تح: المطيعي، ج: 8، ص: 333.
1 - 29
وــــــــــ مِنَ الأَمْرِ حِلًّا، فهْوَ في حِلٍّ مِنْهُ: أَصْبَحَ طَلْقًا مِنْهُ وغَيْرَ مُلْزَمٍ بِهِ.
"هِيَ المَرْأَةُ تَكونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ منها، فيُريدُ طَلاقَها ويَتَزَوَّجُ غَيْرَها، تَقولُ لَهُ: أمْسِكْني ولا تُطَلِّقْني، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْري، فأنْتَ في حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ والقِسْمَةِ لي، فذلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَصّالَحا بيْنَهُما صُلْحًا والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾".
البخاري، الصحيح. تح: العطّار، ص: 377.
"إِنّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُفْشِيَ سِرَّ مَنْ اسْتَكْتَمَنيهِ، (...) ولَكِنّي أُطالِبُ الّذي اسْتَوْدَعَنيهِ أَنْ يَجْعَلَني في حِلِّ مِنْ ذِكْرِهِ لَكَ".
ابن المقفع، كليلة ودمنة. المطبعة الأميرية، ص: 175.
"وكَذلِكَ فعَلَ مَعَ كُلِّ مَنْ أَعادَ إِلَيْهِ مالَهُ؛ طَلَبَ أَنْ يَجْعَلَ والِدَهُ في حِلٍّ".
ابن العميد، أخبار الأيوبيين. مكتبة الثقافة الدينية، ص: 14.
"وأَمّا التّحَلُّلُ فهُوَ مَصْدَرُ تَحَلَّلَ طَلَبَ مِنْ رَبِّ الحَقِّ أَنْ يَجْعَلَهُ في حِلٍّ مِنْهُ".
محمد سالم المجلسي، لوامع الدرر. ج: 10، ص: 305.
1 - 30
وــــــــــ فُلانٌ: عَدا.
"وحَلَّ: إِذا عَدا".
الأزهري، تهذيب اللغة. الدار المصرية، ج: 3، ص: 444.
1 - 31
وــــــــــ فُلانٌ: خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ إِلى الحِلِّ.
"وأَحَلَّ المُحْرِمُ لُغَةٌ في حَلَّ، وأَحَلَّ: إذا خَرَج من شهورِ الحُرُمِ، أَوْ مِنْ ميثاقٍ كانَ عَلَيْهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الفارابي، ديوان الأدب. تح: أحمد مختار، ج: 3، ص: 162.
1 - 32
وــــــــــ الرَّجُلُ المَرْأَةَ: تزَوَّجَها بَعْدَ أَنْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا بِقَصْدِ إِباحَةِ رُجوعِها إِلى زَوْجِها السّابِقِ.
"لَعَنَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةً: آكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، وكاتِبَهُ، وشاهِدَيْهِ، والحالَّ، والمُحَلَّلَ لَهُ، ومانِعَ الصَّدَقَةِ، والواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ".
مسند أحمد. تح: شعيب الأرناؤوط، ج: 2، ص: 67.
"المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ يُقالُ: هُوَ أَنْ يُطْلِّقَ الرَّجُلُ امْرْأَتَهُ ثَلاثًا فيَتَزَوَّجُها رَجُلٌ آخَرُ عَلى شريطَةِ أَنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ مُواقَعَتِهِ إِيّاها لِتَحِلَّ للزَّوْجِ الأَوَّلِ، يُقالُ: حَلَلْتُ لَهُ امْرأَتُهُ فأَنا حالٌّ، وهُوَ مَحْلولٌ لَهُ والمُحَلُّ لَهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
أبو عبيد الهروي، الغريبين، تح: أحمد المزيدي، ج: 2، ص: 486.
2. حَلَّ
فعل
2 - 1
* حَلَّ (كَفَرِحَ) البَعيرُ ونَحْوُهُ يَحَلُّ (بفَتْحِ الحاءِ) حَلَلًا: أَصابَتْهُ رَخاوَةٌ في قَوائِمِهِ. فهْوَ أَحَلُّ. (ج) حُلٌّ.
كَأَنَّ في رِجْلِها لَمّا مَشَتْ رَوَحًا***ولا يُرى قَفَدٌ فيها ولا حَلَلُ
ديوان نابغة بني شيبان. تح: عمر الطّبّاع، ص: 98.
*لَيْسَ بِراعي نَعْجاتٍ كَوْعَلِ*
*أَحَلَّ يَمْشي مِشْيَةَ المُخَبَّلِ*
الشيباني، كتاب الجيم. تح: الأبياري، ج: 1، ص: 196.
"والأَحَلُّ: الّذي في رِجْلِهِ اسْتِرْخاءٌ، وهُوَ مَذْمومٌ في كُلِّ شَيْءٍ إِلّا في الذِّئْبِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 301.
2 - 2
وــــــــــ المَرأةُ: قَلَّ لَحْمُ عَجُزِها وفَخِذَيْها. فهِيَ حَلّاءُ.
"وحَلَّتِ المَرْأَةُ: رَسَحَتْ فهْيَ حَلّاءُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
السرقسطي، كتاب الأفعال. تح: حسين شرف، ج: 1، ص: 341.
3. حُلَّ
فعل
3 - 1
* حُلَّ فُلانٌ وغَيْرُهُ: ضَعُفَ وقَلَّ لَحْمُهُ. فهُوَ مَحْلولٌ (ج) مَحالِيلُ.
«انْظروا إِلى فُلانٍ أَتانا بِفَصيلٍ مَحْلولٍ».
الماوردي، الحاوي. تح: علي معوّض وآخر، ج: 3، ص: 266.
"المَحْلولُ هُوَ الهَزيلُ الَّذي قَدْ حُلَّ جِسْمُهُ".
الماوردي، الحاوي. تح: علي معوّض وآخر، ج: 3، ص: 266.
فكَيْفَ أَمْضي في الهَوى***والجِسْمُ مَحْلولُ القُوى
ديوان البارودي. مؤسسة هنداوي، ص: 297.
4. أَحَلَّ
فعل
4 - 1
* أَحَلَّ المُحْرِمُ: خَرَجَ مِنْ إحْرامِ الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ.
زَعَموا أَنَّني أَديهِ أَلا لا***لا ورَبِّ الإِحْرامِ والإِحْلالِ
ديوان بني أسد. تح: محمّد عليّ دقّة، ج: 2، ص: 177.
«يا أيُّها النّاسُ، أَحِلّوا؛ فلَوْلا الهَدْيُ الّذي مَعِيَ لفَعَلْتُ مِثْلَ ما تَفْعَلونَ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 22، ص: 142.
"طيَّبْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ لإحْرامِهِ حينَ أَحْرَمَ، ولِإحْلالِهِ حينَ أَحَلَّ".
سنن ابن ماجه. تح: ناصر الدين الألباني، ج: 3، ص: 53.
"والحِلُّ: الرَّجُلُ الحَلالُ الّذي خَرَجَ مِنْ إِصْراحِهِ، والفِعْلُ أَحَلَّ إِحْلالًا".
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 28.
"يَلْزَمُهُ الحَجُّ ويَصيرُ غَيْرَ قارِنٍ، ولا يَكونُ عَلَيْهِ دَمُ القِرانِ ويَكونُ عَلَيْهِ دَمٌ لِما أَخَّرَ مِنْ حِلاقِ رَأْسِهِ فِي عُمْرَتِهِ، ويَكونُ عَلَيْهِ دَمٌ لِمُتْعَتِهِ إِنْ كَانَ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وإِنْ كانَ إحْلالُهُ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الحَجِّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 401.
"فإِنْ كانَ قَدْ أَحْرَمَ قَبْلَ الطَّوافَيْنِ فهُوَ قَارِنٌ بِلا تَرَدُّدٍ، وإِنْ كانَ إِنَّما أَهَلَّ بالحَجِّ بَعْدَ الطَّوافِ بالبَيْتِ وبِالجَبَلَيْنِ وهُوَ لَمْ يَكُنْ حَلَّ مِنْ إحْرامِهِ: فهَذا يُسَمّى مُتَمَتِّعًا؛ لأَنَّهُ اعْتَمَرَ قَبْلَ الإِهْلالِ بِالحَجِّ، ويُسَمّى قارِنًا لأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ إِحْلالِهِ مِنْ العُمْرَةِ".
ابن تيمية، فقه الحج. تح: سيّد الجميليّ، ص: 121.
"فالبَحْرُ لَهُ عُمومانِ؛ عُمومُ حِلِّ حَيَواناتِهِ، وعُمومُ حَيِّهِ ومَيِّتِهِ، وعُمومٌ ثالِثٌ لِلمُحِلِّ والمُحْرِمِ".
عبد الرحمن السعدي، الأجوبة السعدية. ج: 1، ص: 64.
4 - 2
وــــــــــ الشَّهْرُ: صارَ حَلالًا، وذلِكَ بِانْقِضاءِ شَهْرٍ حَرامٍ قَبْلَهُ، ودُخولِ أَشْهُرِ الحِلِّ.
إِنَّ الرِّكابَ لَتَبْتَغي ذا مِرَّةٍ***بِجُنوبِ نَخْلَ إِذا الشُهورُ أَحَلَّتِ
محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء. ج: 1، ص: 199.
أَحَلَّتْ شُهورُ الحِرْمِ بَيْني وبَيْنَها***وجُرِّعَ بِالغَيْظِ الغَيورُ المُحَنَّقُ
محمّد بن المبارك، منتهى الطّلب. تح: محمد طريفي، ص: 338.
"أَحَلَّتْ: صارَتْ حَلالًا، إِذا دَخَلَ الشَّهْرُ الّذيْ يَحِلُّ فيهِ الغَزْوُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ثعلب، شرح شعر زهير بن أبي سلمى. تح: قباوة، ج: 1، ص: 248.
4 - 3
وــــــــــ الشّاةُ والنّاقَةُ: دَرَّ لَبَنُها بأَكْلِ العُشْبِ بَعْدَ أَنْ كانَ قَليلًا. فهِيَ مُحِلٌّ. (ج) مَحالُّ.
غُيوثٌ تَلتَقي الأَرْحامُ فيها***تُحِلُّ بِها الطَّروقَةُ واللِّجابُ
[الطَّروقَةُ: صِفَةٌ لِلنّاقَةِ، واللِّجابُ: النِّعاجُ الّتي قَلَّ لَبَنُها]
فجِىءْ بِقُرَيْعٍ والجِذاعُ تَسوقُها***إِذا اسْتَلَأَتْ أَغْنامُها وأَحَلَّتِ
الشيباني، كتاب الجيم. تح: الأبياري، ج: 2، ص: 123.
"وأَحَلَّتِ الشّاةُ والنّاقَةُ وهِيَ مُحِلٌّ: دَرَّ لَبَنُها، وقيلَ: يَبِسَ لَبَنُها ثُمَّ أَكَلَتِ الرَّبيعَ فدَرَّتْ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 301.
4 - 4
وــــــــــ: نَزَلَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها مِنْ غَيْرِ نِتاجٍ.
"وشاةٌ مُحِلٌّ: قَدْ أَحَلَّتْ إِذا نَزَلَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها من غَيْرِ نِتاجٍ ولا وِلادٍ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 28.
4 - 5
وــــــــــ فُلانٌ: خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ إِلى الحِلِّ.
"أَحَلَّ الرَّجُلُ: إِذا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ إِلى الحِلِّ، ومِنْ يَمينٍ كانَتْ عَلَيْهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
القاسم بن سلام، الغريب المصنف. تح: صفوان داوودي، ج: 2، ص: 532.
4 - 6
وــــــــــ فُلانٌ: خَرَجَ مِنْ الشَّهْرِ الحَرامِ.
"يُقالَ: أَحْرَمَ إِذا دَخَلَ في الشَّهْرِ الحَرامِ، وأَحَلَّ إِذا خَرَجَ مِنْهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
أبو عمرو الشيباني، شرح المعلقات التسع. تح: عبد المجيد همّو، ص: 187.
4 - 7
وــــــــــ فُلانٌ بِفُلانٍ: عَرَّضَهُ لِلعُقوبَةِ وجَعَلَهُ مُسْتَحِقًّا لَها.
"أَنْتَ مُحِلٌّ بِقَوْمِكَ، وفاضِحٌ عَوْرَتَكَ".
ابن الجوزي، المنتظم. تح: محمد عطا، ج: 3، ص: 332.
«ما فَشى في قَوْمٍ الرِّبا والزِّنا إِلّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقابَ اللَّهِ».
عبد الملك بن حبيب الأندلسي، كتاب الربا. تح: نذير أوهاب، ص: 52.
"فمَنْ خالَفَ أَمْرَهَ أَنْزَلَ بِهِ ما يَتَّعِظُ بِهِ مَنْ سِواهُ، وأَنْ يَحْذَروا جَميعًا التَّوْريَةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِتَقْليدِهِ عَمَلًا ونَسْبِهِ إِلى غَيْرِهِ، فيَنالُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِمّا أَحَلَّ بِنَفْسِهِ مِنْ نَكيرِ أَميرِ المُؤْمِنينَ وغَيْرِهِ ما لا صَلاحَ لَهُ بَعْدَهُ".
ابن زبر الربعي، جزء فيه شروط النصارى. تح: أنس العقيل، ص: 41.
"وأَحَلَّ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ إِذا اسْتَوْجَبَ العُقوبَةَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 301.
4 - 8
وــــــــــ فُلانٌ بِفُلانٍ: اسْتَباحَ قِتالَهُ في الشَّهْرِ الحَرامِ.
"أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ".
ابن الأثير، النهاية. تح: علي بن حسن الحلبي، ص: 227.
"يَقولُ: مَنْ تَرَكَ الإِحْرامَ وأَحَلَّ بِكَ فقاتَلَكَ؛ فأَحْلِلْ أَنْتَ بِهِ فقاتِلْهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 351.
4 - 9
وــــــــــ الشَّيْءَ: أَباحَهُ، وجَعَلَهُ حَلالًا.
وحَرَّمْتُ السِّباءَ وإِنْ أُحِلَّتْ***بِشَوْرٍ أَوْ بِمِزْجٍ أَوْ لِصابِ
ديوان تأبّط شرًّا وأخباره. تح: علي ذو الفقار، ص: 68.
فذَكِّرْهُمُ بِاللهِ أَوَّلَ وهْلَةٍ***وإِحْلالَ أَحْرامِ الظِّباءِ الشَّوازِبِوقُلْ لَهُمُ واللَّهُ يَحْكُمُ حُكْمَهُ***ذَروا الحَرْبَ تَذْهَبْ عَنْكُمُ في المَراحِبِ
ديوان صيفي بن الأسلت. تح: حسن باجوده، ص: 65.
﴿وأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة:275).
«ما أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ».
الحاكم، المستدرك. تح: مصطفى عبد القادر، ج: 2، ص: 214.
"لُحومُ الإبِلِ والشُّحومِ، لَمّا بُعِثَ عيسى أَحَلَّها لَهُمْ".
تفسير ابن جريج. تح: علي عبدالغني، ص: 69.
"أَحَلَّ لَكُمُ الغَنائِمَ وبَسَطَ لَكُمْ في المَلاذِّ".
الرّسعني، رموز الكنوز. تح: دهيش، ج: 2، ص: 404.
"مُحَصِّلُ الِاسْتِدْلالِ أَنَّ اللَّهَ تَعالَى أَحَلَّ الِابْتِغاءَ الصَّحيحَ مُلْصَقًا بِالمالِ، فمُقْتَضى هذا أَنْ لا يَكونَ الِابْتِغاءُ المُنْفَكُّ عَنِ المالِ صَحيحًا لا أَنْ يَكونَ صَحيحًا ومُسْتَوْجِبًا لِثُبوتِ ما نَفى أَوْ سَكَتَ عَنْهُ مِنَ المَهْرِ".
محمد مصطفى الرومي، منتهى الكلام. تح: حسن آل أيوب، ص: 126.
4 - 10
وــــــــــ النَّذْرَ واليَمينَ: أَبَرَّ بِهِما، أَوْ كَفَّرَهُما.
لِلَّهِ عَينا مَنْ رَأى مِثْلَ مالِكٍ***عَقيرَةَ قَوْمٍ أَنْ جَرى فرَسانِفلَيْتَهُما لَمْ يَشْرَبا قَطُّ قَطْرَةً***ولَيْتَهُما لَمْ يَجْريا لِرِهانِأَحَلَّ بِهِ أَمْسِ الجُنَيْدِبُ نَذْرَهُ***فأَيُّ قَتيلٍ كانَ في غَطَفانِ
المفضل الضبي، أمثال العرب. تح: إحسان عباس، ص: 93.
أَحَلَّ هُرَيْمٌ يَوْمَ بابِلَ بِالقَنا***نُذورَ نِساءٍ مِنْ تَميمٍ فحَلَّتِ
ديوان الفرزدق. تح: علي فاعور، ج: 1، ص: 103.
"أَحَلَّ الرَّجُلُ: إِذا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ إِلى الحِلِّ، ومِنْ يَمينٍ كانَتْ عَلَيْهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
القاسم بن سلام، الغريب المصنف. تح: صفوان داوودي، ج: 2، ص: 532.
4 - 11
وــــــــــ أَحْمالَهُ: أَنْزَلَها.
تَبَدَّلَ بَعْدَ الصِّبى حِكْمَةً***وقَنَّعَهُ الشَّيْبُ مِنْهُ خِماراأَحَلَّ بِهِ الشَّيْبُ أَثْقالَهُ***وما اغْتَرَّهُ الشَّيْبُ إِلاّ اغْتِرارا
ديوان الأعشى. تح: محمود الرضواني، ج: 1، ص: 186.
"وأَحَلَّ: أَنْزَلَ، والإِحْلالُ: الإِنْزالُ".
البغدادي، خزانة الأدب. تح: عبد السلام هارون، ج: 3، ص: 375.
4 - 12
وــــــــــ اللهَ: أسْلَمَ لَهُ وشَهِدَ بِوَحْدانِيَّتِهِ.
«أَحِلّوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ».
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق. تح: عمر العمروي، ج: 67، ص: 85.
4 - 13
وــــــــــ فُلانٌ المَرْأَةَ: تَزَوَّجَها ثُمَّ طَلَّقَها لِتَحِلَّ لِزَوْجِها السّابِقِ الّذي طَلَّقَها ثَلاثًا.
"لعَنَ رَسولُ اللهِ ﷺ الواصِلَةَ، والمَوْصولَةَ، والمُحِلَّ، والمُحَلَّلَ لَهُ، والواشِمَةَ، والمَوْشومَةَ، وآكِلَ الرِّبا، ومُطْعِمَهُ"
مسند أحمد. تح: شعيب الأرنؤوط، ج: 7، ص: 412.
"ومَعْنى المُحِلِّ: القاصِدُ بِالتَّزْويجِ لَها إِلى التَّحْليلِ، وهُوَ لا رَغْبَةَ لَهُ فيها، ولا يُريدُ التَّمَسُّكَ بِها". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن قتيبة، المسائل والأجوبة. تح: مروان العطية، ص: 304.
"أَمّا الصِّحَّةُ؛ فلِأَنَّهُ عَقْدٌ خَلا عَنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ، أَشْبَهُ ما لَوْ طَلَّقَها لِغَيْرِ الإِحْلالِ".
ابن المنجى، الممتع في شرح المقنع. تح: دهيش، ج: 3، ص: 612.
"ونِكاحُ المُحلِّلِ: وهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَها بِشَرْطِ أنَّهُ يَتَزَوَّجُها عَلى أَنَّهُ إِذا أَحَلَّها لِلْأَوَّلِ (فَلا نِكاحَ بَيْنَهُما) وهُوَ حَرامٌ باطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»".
مصطفى السّيوطيّ، مطالب أولي النّهى. المكتب الإسلامي، ج: 5، ص: 125.
4 - 14
وــــــــــ الحُرْمَةَ: انْتَهَكَها.
"وأَمّا ما سَأَلْتَني أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بِرَأْيي في ما أَنا فيهِ، فإِنَّ رَأْيي جِهادُ المُحِلّينَ حَتّى أَلْقى اللَّهَ".
ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة. تح: علي شيري، ص: 75.
"ويُقالُ: المُحِلُّ الّذي لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ ولا حُرْمَةٌ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 350.
في حَرامٍ مِنَ الشُّهورِ أُحِلَّتْ***حُرْمَةُ اللهِ والحَرامُ حَرامُ
ديوان السيد الحميري. تح: ضياء حسين الأعلمي، ص: 175.
"وكانَ بِاليَمَنِ ما عُلِمَ مِنْ ابْنِ مَهْديِّ الضَّلالِ، ولَهُ ثَأْرٌ طالِبُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لِأَنَّهُ سَبى الشَّرائِفَ الصالِحاتِ (...) وأَخَذَ أَمْوالَ الرَّعايا المَعْصومَةَ وأَجاحَها، وأَحَلَّ الفُروجَ المُحَرَّمَةَ".
ابن واصل، مفرج الكروب. تح: جمال الدين الشيال وآخران، ج: 3، ص: 294.
"وتَجْويزُ مُقاتَلَةِ (المُحِلّينَ) في الأَشْهُرِ الحُرُمِ، هُوَ دِفاعٌ عَنِ النَّفْسِ، وضَرورَةٌ واجِبَةٌ".
جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج: 8، ص: 477.
4 - 15
وــــــــــ فُلانًا: حَلَقَ لَهُ شَعْرَهُ.
"وأَحْلَلْتُ الرَّجُلَ: حَلَقْتُهُ".
سعيد بن محمد السرقسطي، كتاب الأفعال. تح: حسين شرف، ج: 1، ص: 342.
4 - 16
وــــــــــ العُقْدَةَ: حَلَّها.
فواللهِ ما فارَقْتُ عُهْدَةَ عَقْدِهِ***وواللهِ ما أَحْلَلْتُ عُقْدَةَ عَهْدِهِ
ابن معصوم المدني، أنوار الربيع. تح: شاكر هادي، ج: 3، ص: 340.
"والطَّلاقُ: إِحْلالُ العَقْدِ، يُقالُ: طَلَقَتْ -بِفَتْحِ اللّامِ- تَطْلُقُ فهْيَ طالِقٌ وطالِقَةٌ".
السمين الحلبي، الدر المصون. تح: أحمد الخراط، ج: 2، ص: 436.
"الحَمْدُ لِلَّهِ الّذي أَحَلَّ العُقْدَةَ مِنْ لِسانِي فجَعَلَ الكَلِماتِ تَسْري بَيْنَ يَدَيَّ عَلى هَذِهِ الأَوْراقِ".
محمد علاء المراكبي، 51 وصية لتستمتع بالحياة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص: 7.
4 - 17
وــــــــــ فُلانًا المَكانَ، وبِهِ: أَنْزَلَهُ فيهِ.
سَمَوا في المَعاليْ رُتْبَةً فوْقَ رُتْبَةٍ***أَحَلَّتْهُمُ حَيْثُ النَّعائِمُ والنَّسْرُ
الشعراء الجاهليون الأوائل. دار المشرق، ص: 190.
أَهْلي فِداءٌ لِامْرِئٍ غَيْرِ هالِكٍ***أَحَلَّ اليَهودَ بالحِسِيِّ المُرَنَّمِ
ابن هشام، السيرة النبوية. تح: عمر تدمري، ج: 3، ص: 148.
﴿الّذِيْ أَحَلَّنا دارَ المُقامَةِ مِنْ فضْلِهِ لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ ولا يَمَسُّنا فيها لُغوبٌ﴾ (فاطر: 35).
*****
"فلَمْ يَبْرَحْ يُوَفّيهِمْ ذلِكَ ويَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ أَشْرافِ العَرَبِ حَتّى ورَدَ بِهِمُ الشّامَ وأَحَلَّهُمْ قُراها".
محمد بن حبيب، المنمق. تح: أبو جعفر البغدادي، ج: 1، ص: 43.
"فلَمّا وصَلَ الكوفَةَ فشا الخَبَرُ إِلى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيادٍ، لَعَنَهُ اللهُ، وأَحَلَّهُ دارَ الخِزْيِ".
ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية. ص: 114.
4 - 18
وــــــــــ اللهُ الأَمْرَ عَلى فُلانٍ: أَوْجَبَهُ.
«إنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى يَقولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ، فيَقولونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنا وسَعْدَيْكَ (...) قالوا: يا رَبِّ، وأَيُّ شَيْءٍ أفْضَلُ مِنْ ذلِكَ؟ فيَقولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُم رِضْواني، فلا أَسْخَطُ علَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».
البخاري، الصحيح. تح: العطّار، ص: 1649.
"وأَحَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ: أَوْجَبَهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المخصص. تح: جفال، ج: 4، ص: 366.
"وأَمّا قَوْلُ المُسْلِمِ: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ) فهُوَ إِخْبارٌ لِلمُسَلَّمِ عَلَيْهِ بِسَلامَتِهِ مِنْ غَيْلَةِ المُسَلِّمِ وغِشِّهِ ومَكْرِهِ ومَكْروهٍ يَنالُهُ مِنْهُ، فيَرُدُّ الرّادُّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذلِكَ: أَيْ فعَلَ اللهُ ذلِكَ بِكَ، وأَحَلَّهُ عَلَيْكَ".
ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة. تح: يوسف البكري، وآخر، ص: 418.
4 - 19
وــــــــــ العِقابَ بِفُلانٍ: أَنْزَلَهُ بِهِ.
"أَلا إِنَّهُ أَخو جُفاةٍ، فأَوْرَدَهُمُ النّارَ، وأَوْرَثَهُمُ العارَ، واللهُ مُحِلٌّ بِهِمُ الذُّلَّ والصَّغارَ".
ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج: 5، ص: 189.
"فكَذلِكَ هَؤُلاءِ المُشْرِكُونَ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ حينَ نَزَلَ بِهِمْ أَمْرُ اللَّهِ، وحَلَّ بِهِمْ سَخَطُهُ، أَوْلِياؤُهُمُ الّذينَ اتَّخَذوهُمْ مِنْ دونِ اللَّهِ شَيْئًا، ولَمْ يَدْفَعوا عَنْهُمْ ما أَحَلَّ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سَخَطِهِ بِعِبادَتِهِمْ إِيّاهُمْ".
الطبري، جامع البيان. تح: عبد الله التركي، ج: 18، ص: 404.
"وقيلَ شَبَّهَ بِالسَّوْطِ ما أَحَلَّ بِهِمْ في الدُّنْيا، إِشْعارًا بِأَنَّهُ بِالقياسِ إِلى ما أَعَدَّ لَهُمْ في الآخِرَةِ مِنَ العَذابِ كالسَّوْطِ إِذا قيسَ إِلى السَّيْفِ".
تفسير البيضاوي. تح: محمّد صبحي وآخر، ج: 1، ص: 531.
"﴿فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتالُ﴾ لِعَدُوِّهِمُ الّذي تَسَبَّبَ لَهُمُ الاغْتِرابَ، وأَحَلَّ بِهِمْ العَجَبَ العُجابَ، ﴿تَوَلَّوا﴾ وأَعْرَضُوا عَنْ مُقاتَلَتِهِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 3، ص: 378.
4 - 20
وــــــــــ فُلانًا مِنَ الأَمْرِ: جَعَلَهُ في حِلٍّ مِنْهُ.
إِذا ما كُنْتَ طالِبَ كُلِّ ذَنْبٍ***ولَمْ تُحْلِلْ أَخاكَ مِنَ العِتابِتَباعَدَ مَنْ تَباعَدَ بَعْدَ قُرْبٍ***وصارَ بِكَ الزَّمانُ إلى اجْتِنابِ
شعر سابق البربري. تح: بدر أحمد ضيف، ص: 104.
"لَوْ حَلَّلَتِ الأَمَةُ زَوْجَها مِنْ يَوْمِها ولَيْلَتِها ولَمْ يُحْلِلْهُ السَّيِّدُ حَلَّ لَهُ، ولَوْ حَلَّلَهُ السَّيْدُ ولَمْ تُحْلِلْهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَها دونَ السَّيِّدِ".
الشافعي، الأم. تح: محمد زهري النجار، ج: 5، ص: 11.
"وكانَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَيّامٍ أَطْلَقَهُ، وفَكَّ قَيْدَهُ، وخَلَعَ عَلَيْهِ، وأَطْلَقَ لَهُ أُلوفَ دَراهِمَ، واسْتَحَلَّهُ فأَحَلَّهُ".
ابن العديم، بغية الطلب. تح: سهيل زكار، ص: 4593.
"لَوْ قالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اجْعَلْني في حِلٍّ مِنْ كُلِّ حَقِّ لَكَ عَلَيَّ، وأَحَلَّهُ الآخَرُ، فإِذا كانَ صاحِبُ الحَقِّ عالِمًا بِما لَهُ مِنْ حَقِّ عَلى ذلِكَ الشَّخْصِ بَرِئَ حُكْمًا وديانَةً".
حيدر عليّ، درر الحكّام شرح مجلة الأحكام. تح: تعريب: فهمي الحسينيّ، ج: 2، ص: 416.
4 - 21
وــــــــــ فُلانًا مَنْزِلَةً: وضَعَهُ فيها.
وما كُنْتُ حَجّامًا ولَكِنْ أَحَلَّني***بِمَنزِلَةِ الحَجّامِ نَأْيي عَنِ الأَهْلِ
يزيد بن مفرغ الحميري. تح: عبدالقدوس أبو صالح، ص: 194.
"فالواجِبُ عَلى المَلِكِ الّذي أَحَلَّهُ اللهُ المَحَلَّ الجَليلَ، وأَنْزَلَهُ المَنْزِلَةَ الرَّفيعَةَ، أَنْ يَتَوقّى ما نَهاهُ اللهُ عَنْهُ".
الماوردي، نصيحة الملوك. تح: خضر محمد، ج: 1، ص: 230.
"فزادَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ فضيلَةٍ، وأَحَلَّهُ المَنْزِلَةَ الرَّفيعَةَ الجَليلَةَ".
اليافعي، مرآة الجنان. تح: خليل المنصور، ج: 4، ص: 242.
"فهَلْ إِذا قيلَ: إِنَّ فُلانًا قَدْ أَحَلَّهُ السُّلْطانَ مَحَلَّ كَرامَتِهِ، ودارَ حُكومَتِهِ، وأَنْزَلَهُ المَنْزِلَ اللّائِقَ بِهِ، كانَ ذلِكَ دَليلًا عَلى أَنَّ أُولَئِكَ الخَدَمَ أَعْلى دَرَجَةً مِنْهُ؟ لا أَظُنُّكَ تَقولُ ذلِكَ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: عمّار بكور، ج: 13، ص: 133.
4 - 22
وــــــــــ فلانًا مَحَلَّ فُلانٍ: اسْتَبْدَلَهُ بِهِ.
"مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّمْتَ أَشْرَفُ مَرْتَبَةً وأَرْفَعُ مَنْزِلَةً مِنَ الكَلامِ، فقَدْ حَكَمَ عَلى الكَلامِ بِالنُّقْصانِ، وأَحَلَّ العِيَّ مَحَلَّ البَيانِ".
الوطواط، غرر الخصائص الواضحة. تح: إبراهيم شمس الدين، ص: 184.
"وإِنْ كانَ الفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إِلى ثَلاثَةِ مَفْعولينَ، فلا يَخْلو أَنْ تُخْبِرَ عَنِ الأَوَّلِ، أَوْ عَنِ الثّاني، أَوِ عَنِ الثّالِثِ ولا يَجوزُ حَذْفُ هَذا الضَّميرِ؛ لِأَنَّ الّذي أُحِلَّ مَحَلَّهُ هَذا الضَّميرُ لا يَجوزُ حَذْفُهُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الفاعِلِ، والفاعِلُ لا يُحْذَفُ".
ابن عصفور، شرح جمل الزّجّاجي. تح: فوّاز الشّعّار، ج: 3، ص: 104.
"وقَدْ أُحِلَّ احْتِياطِيُّ الجَيْشِ حينًا مَحَلَّ رِجالِ السُّخْرَةِ".
يوسف نحاس، الفلاح: حالته الاقتصادية والاجتماعية. ص: 115.
5. حالَّ
فعل
5 - 1
* حالَّ فُلانٌ فُلانًا: حَلَّ مَعَهُ في دارِهِ.
"لَمْ يُرِدْ بِالحَليلَةِ ههُنا امْرَأَتَهُ، إنَّما أرادَ جارَتَهُ؛ لِأَنَّها تُحالُّهُ في المَنْزِلِ".
الأزهري، تهذيب اللغة. الدار المصرية، ج: 3، ص: 440.
"والحَليلُ الزَّوْجُ، والحَليلَةُ الزَّوْجَةُ، وهُما أَيْضًا مَنْ يُحالُّكَ في دارٍ واحِدَةٍ" .
الرازي، مختار الصحاح. تح: يوسف الشيخ، ص: 63.
"وحالَّهُ مَحالَّةً: نَزَلَ مَعَهُ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 188.
5 - 2
وــــــــــ: تَحَلَّلَهُ وسَمَحَ لَهُ.
"ولَوْ كانَ الغاصِبُ امْتَلَخَ ذَلِكَ مِنْ شَجَرَةٍ امْتِلاخًا فلَكَ أَخْذُهُ بِحِدْثانِ ذلِكَ (...) فلَوِ امْتَلَخَ دالَّةً لا تَعَدِّيًا فإِنَّهُ يَتَحالَلُ مِنْكَ، فإِنْ حالَلْتَهُ، وإِلّا فقيمَةُ العودِ مَكْسورًا حَدَثَ القِيامُ أَوْ تَأَخَّرَ".
القرافي، الذخيرة. تح: محمد حجي، ج: 8، ص: 325.
6. حَلَّلَ
فعل
6 - 1
* حَلَّلَ فُلانٌ: جَبُنَ ونَكَصَ. (وانْظُرْ ه ل ل).
ونَحْنُ عَلى شَراحيلِ بنِ عَمْرٍو***شَهَرْنا البيضَ غَيْرَ مُحَلِّلينا
شرح هاشميّات الكميت. تح: داود سلّوم، وآخرين، ص: 283.
"يُقالُ: حَلَّلَ وهَلَّلَ: إِذا جَبُنَ وكاعَ".
شرح هاشميّات الكميت. تح: داود سلّوم، وآخرين، ص: 283.
6 - 2
وــــــــــ بِالمَكانِ: نَزَلوا فيهِ وقْتًا يَسيرًا جِدًّا.
فلَبَّثَها الرّاعي قَليْلًا كَلا ولا***بِلَوْذانَ أَوْ ما حَلَّلَتْ بالكَراكِرِ
ديوان الرّاعي النّميريّ. تح: واضح الصّمد، ص: 146.
"نَزَلْنا تَحْليلًا؛ أَيْ: قَدْرَ ما مَسَسْنا مِنَ الأَرْضِ؛ وما كانَ نُزولُنا إلا تَحْليلًا". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الشيباني، كتاب الجيم. تح: الأبياري، ج: 1، ص: 152.
6 - 3
وــــــــــ النّاسُ وغَيْرُهُمْ المَكانَ: حَلّوهُ ونَزَلوهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةِ.
مُهَفْهَفَةٌ بَيْضاءُ غَيْرُ مُفاضَةٍ***تَرائِبُها مَصْقولَةٌ كالسَّجَنْجَلِكَبِكْرِ مُقاناةِ البَياضِ بِصُفْرَةٍ***غَذاها نَميرُ الماءِ غَيْرُ مُحَلَّلِ
ديوان امرئ القيس وملحقاته. تح: أنور عليان، وآخرين، ص: 232.
"ويُقالُ: غَيْرُ مُحَلَّلٍ؛ أَيْ غَيْرُ مَنْزولٍ عَلَيْهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 350.
6 - 4
وــــــــــ فُلانٌ العُقْدَةَ: حَلَّها.
ونارٍ قَدْ حَضَأْتُ بُعَيْدَ هَدْءٍ***بِدارٍ ما أُريدُ بِها مُقاماسِوى تَحْليلِ راحِلَةٍ وعَيْرٍ***أُكالِئُهُ مَخافَةَ أَنْ يَناما
ديوان تأبّط شرًّا وأخباره. تح: علي شاكر، ص: 256.
بِدانيَةٍ مِنَ الآفاتِ نَزْهٍ***بَراءٍ لا يُرى فيها سَقيمُسَواعِدُها تُحَلَّبُ لا تُصرَّى***بِها الأَيْديْ مُحَلَّلَةً تَحومُ
ديوان أميّة بن أبي الصَّلْت. تح: سجيع جميل الجبيلي، ص: 120.
"دَخَلْتُ عَلى رَسولِ اللهِ ﷺ وهْو يُصَلّي مُحْتَبِيًا، مُحَلَّلَ الأَزْرارِ".
الطبراني، المعجم الكبير. ج: 11، ص: 152.
حَسْبي وحَسْبُ الَّتي كَلِفْتُ بِها***مِنّي ومِنْها الحَديثُ والنَّظَرُأَو قُبْلَةٌ في خِلالِ ذاكَ ولا***بَأْسَ إِذا لَمْ تُحَلَّلِ الأُزُرُ
بشار بن برد، ديوان بشار بن برد. تح: إحسان عباس، ج: 1، ص: 316.
"ولَحَظْتُ التَّحْليلَ بِحَلِّ ما عَقَدَهُ".
ابن الخطيب، الإحاطة. تح: يوسف طويل، ج: 2، ص: 285.
يا رَبِّ حَلِّلْ عُقْدَةَ الآزالِ***بِعَوارِضٍ تَهْمي بِعَذْبِ زُلالِ
الهادي المبروك الدالي، أدب إفريقيا فيما وراء الصحراء. ص: 73.
6 - 5
وــــــــــ حُرْمَةَ الشَّيْءِ: انْتَهَكَها.
تَدارَكْتَ أَصْحابَ الحَظيرَةِ بَعْدَما***أَصابَهُمُ مِنّا حَريقُ المُحَلِّلِوَأَتْبَعْتَ بَيْنَ المَشْعَرَيْنِ سِقايَةً***لِحُجّاجِ بَيْتِ اللهِ أَكْرَمَ مَنهَلِ
حاتم الضامن، عشرة شعراء مقلون. جامعة بغداد، ص: 42.
لِأَنّا حَجَجْنا حَجَّةً جاهِليَّةً***مُحَلِّلَةً لَمْ تُبْقِ شَرْقًا ولا غَرْباوإِنّا تَرَكْنا بَيْنَ زَمْزَمَ والصَّفا***جَنائِزَ لاَ نُبْقي سِوى رَبِّها رَبّا
ديوان الزنادقة. تح: جمال جمعة، ص: 177.
6 - 6
وــــــــــ فُلانًا مِنَ الأَمْرِ: جَعلَهُ في حِلِّ مِنْهُ.
وكَأْسٌ لا تُصَدِّعُ شارِبيها***يَلَذُّ بِحُسْنِ رُؤيَتِها النَّديمُ تُصَفَّقُ في صِحافٍ مِنْ لُجَيْنٍ***ومِنْ ذَهَبٍ مُبارَكَةٌ رَذومُإِذا بَلَغوا الّتي أُجْروا إِلَيْها***تَقَبَّلَهُمْ وحُلِّلَ مَنْ يَصومُ
ديوان أميّة بن أبي الصَّلْت. تح: سجيع جميل الجبيلي، ص: 123.
«أَلا وإنَّ أَحَبَّكُمْ إليَّ مَنْ أخَذَ حَقًّا إنْ كانَ، أَوْ حَلَّلَني فلَقيتُ اللهَ وأَنا طَيِّبُ النَّفْسِ».
الطبري، تاريخ الأمم والملوك. دار الكتب العلمية، ج: 2، ص: 227.
"فإِنْ تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ ما يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِ المالِ، فعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ المالِ، فإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ فلا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ أَبى أَنْ يُحَلِّلَهُ فعَلَيْهِ أَنْ يُكافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ إِنْ كانَ ذلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكافَأَةً".
مالك بن أنس، الموطأ. تح: محمد مصطفى الأعظمي، ج: 6، ص: 293.
"وهَلْ يَنْفَعُهُ التَّحْليلُ المُطْلَقُ أَمْ لا؟ فيهِ خِلافٌ، والصَّحيحُ أَنَّهُ لا يَنْفَعُ؛ فإِنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ بِمَظْلِمَةٍ لَها قَدْرٌ وبالٌ رُبَّما لَمْ تَطِبْ نَفْسُ المَظْلومِ في التَّحَلُّلِ مِنْها".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 11، ص: 452.
"وَيُنْدَبُ لِمَنْ سُئِلَ التَّحْليلَ أَنْ يُحَلِّلَ ولا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ وفَضْلٌ، وكانَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ -واقْتَدى بِهِمْ والِدي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ والرِّضْوان- يَمْتَنِعونَ مِنَ التَّحْليلِ مَخافَةَ التَّهاوِنِ بِأَمْرِ الغيبَةِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: غيّاث الحاج وآخرين، ج: 25، ص: 387.
6 - 7
وــــــــــ فُلانٌ المَرْأَةَ: تَزَوَّجَها لِيُحِلَّها لِزَوْجِها الأَوَّلِ الّذي طَلَّقَها ثَلاثًا.
«لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ».
ابن أبي شيبة، المصنف. تح: كمال الحوت، ج: 7، ص: 292.
"المُحَلِّلُ مَلْعونٌ".
ابن أبي شيبة، المصنف. تح: كمال الحوت، ج: 3، ص: 552.
"إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأةَ لِيُحَلِّلَها، ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يُمْسِكَها فلا يَحِلُّ لَهْ أَنْ يُمْسِكَها حَتّى يَتَزَوَّجَها بِنِكاحٍ جَديدٍ".
الترمذي، الجامع. تح: بشار عواد، ج: 2، ص: 415.
"ومِنْ شَواذِّ الفِقْهِ أَنَّ مُحَلِّلَها مَأْجورٌ إِذا كانَ مُطَلِّقُها مَشْغوفًا بِها".
ابن بزيزة، روضة المستبين. تح: عبد اللّطيف زكّاغ، ص: 808.
"ووَجَدْنا كُلَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً ثَلًاثا فإِنَّهُ مُحَلِّلٌ، ولَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّحْليلَ أَوْ لَمْ يَنْوِهْ، فإِنَّ الحِلَّ حَصَلَ".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد حلاق، ج: 12، ص: 141.
6 - 8
وــــــــــ الأَمْرَ أَوِ الشَّيْءَ: أَباحَهُ.
فلَفَفْتُ بَيْنَهُمُ لِغَيْرِ هَوادَةٍ***إِلّا لِسَفْكٍ لِلدِّماءِ مُحَلَّلِ
ديوان الهذليين. تح: محمّد محمود الشنقيطي، ج: 2، ص: 89.
"﴿وَإِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ مِنَ القُرآنِ في تَحْليلِ ما حَرَّموهُ ﴿قالوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا﴾".
تفسير مقاتل. تح: عبد الله شحاتة، ج: 1، ص: 155.
تُحَلِّلُ لِلأَحْداقِ قَتْلَ بَني الهَوى***كَأنَّ دَمَ العُشّاقِ غَيْرُ مُحَرَّمِ
ديوان ابن الأبار. تح: عبد السّلام الهرّاس، ص: 303.
"وهكَذا مَنْ حَرَّمَ حَلالًا، أَوْ حَلَّلَ حَرامًا، فإِنَّهُ يَدْخُلُ في المُسْرِفينَ، ويَخْرُجُ عَنِ المُقْتَصِدينَ".
الشوكاني، فتح القدير. دار المعرفة، ج: 1، ص: 471.
6 - 9
وــــــــــ الأَمْرَ مِنْ فُلانٍ: سأَلَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْهُ.
«مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مالِهِ فلْيُحَلِّلْها مِنْ صاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حينَ لا يَكونُ دِينارٌ ولا دِرْهَمٌ».
البيهقي، السنن الكبرى. تح: محمد عطا، ج: 6، ص: 137.
6 - 10
وــــــــــ اليَمينَ والنَّذْرَ تَحْليلًا، وتَحِلَّةً، وتَحِلًّا: أَبَرَّ بِهِما، أَوْ خَرَجَ مِنْ حَرَجِهِما بِكَفّارَةٍ أَوِ اسْتِثْناءٍ.
﴿قَدْ فرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ واللَّهُ مَوْلاكُمْ وهُوَ العَليمُ الحَكيمُ﴾ (التحريم: 2).
قَدِ اعْتَرَفَتْ نَفْسٌ عُلَيَّةُ داؤُها***بِطولِ ضَنًى مِنْها إِذا لَمْ تُساعِفِفإِنْ يُطْلِقُ الرَّحْمَنُ قَيْدي فأَلْقَها***نُحَلِّلْ نُذورًا بِالشِّفاهِ الرَّواشِفِ
شرح ديوان الفرزدق. تح: إيليا الحاوي، ج: 2، ص: 89.
"إِذا لَمْ يَقْصُدِ الحالِفُ تَحْليلَ يَمينِهِ بِما لا يَجِبُ فهُوَ بارٌّ حَتّى إِذا قَصَدَ القَضاءَ عَلَيْهِ بِذلِكَ وكانَ بِسَبَبِهِ فقَدْ حَنَثَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ وجْهِ القَضاءِ الَّذي حَلَفَ عَلَيْهِ".
ابن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة. تح: أبو الفضل الدمياطي، ج: 3، ص: 303.
"وفي حَواشي ابْنِ بَرِّيٍّ:
تَخْدي عَلى يَسَرات، وهِيَ لاحِقَةٌ***ذَوابِل، وقْعُهُنَّ الأَرضَ تَحْلِيلُ
أَيْ قَليلٌ كَما يَحْلِفُ الإِنْسانُ عَلى الشَّيْءِ أَن يَفْعَلَهُ فيَفْعَلُ مِنْهُ اليَسيرَ يُحَلِّلِ بِهِ يَمينَهُ".
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 299.
"أَيْ شَرَعَ لَكُمْ تَحْليلَ أَيْمانِكُمْ، وبَيَّن لَكُمْ ذلِكَ".
الشوكاني، فتح القدير. دار المعرفة، ص: 1505.
6 - 11
وــــــــــ المُصَلّي نَفْسَهُ مِنَ الصَّلاةِ ونَحْوِها: خَرَجَ مِنْ إِحْرامِها.
«مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتَحْريمُها التَّكْبيرُ، وتَحْليلُها التَّسْليمُ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 2، ص: 292.
"هُو في الصَّلاةِ ما لَمْ يَخْرُجُ مِنْها بالتَّحْليلِ، وهُوَ التَّسْليمُ".
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح. تح: فضل الرحمن دين محمد، ج: 2، ص: 179.
"وأَمّا الَّذي في آخِرِ الصَّلاةِ وهُوَ سَلامُ التَّحْليلِ فاخْتَلَفَ أَصْحابُنا فيهِ".
النووي، صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة، ج: 4، ص: 154.
"فالتَّحْريمُ مَحْصورٌ في التَّكْبيرِ، والتَّحْليلُ مَحْصورٌ في التَّسْليمِ".
عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود. ج: 1، ص: 102.
6 - 12
وــــــــــ الحِقْدَ ونَحْوَهُ: أَذْهَبَهُ.
تُحَلِّلُ أَحْقادي إِذا ما لَقيتُها***وَتَبْقى بِلا ذَنْبٍ عَلَيَّ حُقودُها
ديوان كُثيِّر عزّة. تح: إحسان عباس، ص: 201.
"إنَّ أَخي وابْنَ عَمّي، وإِنْ كانَ عاتِبًا عَلَيَّ، فهْوَ أَرْأَفُ بي وأَرَقُّ عَليَّ مِنَ الأَباعِدِ، ومِنْ أَمْثالِهِمْ في هذا: الحَفائِظُ تُحَلِّلُ الأَحْقادَ".
القاسم بن سلاّم، كتاب الأمثال. تح: عبد المجيد قطامش، ص: 328.
"فأَمَرَ بِطاعَتِهِ وطاعَةِ رَسولِهِ، ويَدْخُلُ في ذلِكَ جَميعُ الدّينِ، ونَهى عَنِ التَّنازُعِ الّذي يوجِبُ تَفَرُّقَ القُلوبِ، وحُدوثَ العَداواتِ المُحَلِّلَةِ لِلمَعْنَوياتِ".
مجموع مؤلفات عبد الرحمن السعدي. ج: 23، ص: 435.
6 - 13
وــــــــــ المُحْرِمَ مِنْ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ: حَمَلَهُ عَلى تَرْكِ الإِحْرامِ والتَّحَلُّلِ مِنْهُ.
"إِذا اشْتَرى الرَّجُلُ جارِيَةً مُحْرِمَةً بِالحَجِّ، وهْوَ لا يَعْلَمُ بِهِ، ثُمَّ عَلِمَ، فلَيْسَ هَذا عَيْبًا؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَها".
محمد بن الحسن، الأصل. تح: أبو الوفا الأفغاني، ج: 5، ص: 182.
"ولا فرْقَ [في سُقوطِ النَّفَقَةِ بِالإِحْرامِ بِغَيْرِ الإِذْنِ بَيْنَ أَنْ يَكونَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ كَما لا فرْقَ] في نُشوزِها بِخُروجِها مِنَ المَنْزِلِ بَيْنَ أَنْ يَكونَ الزَّوجُ حاضِرًا أَوْ مُسافِرًا، ولا بَيْنَ أَنْ يَكونَ ما أَحْرَمَتْ بِهِ فرْضًا -وقُلْنا: لَهُ أَنْ يُحَلِّلَها مِنْهِ- أَوْ تَطَوُّعًا".
ابن الرفعة، كفاية النبيه. تح: مجدي باسلوم، ج: 15، ص: 202.
"لا بُدَّ فِي العَيْبِ أَنْ لا يَتَمَكَّنَ مِنْ إزالَتِهِ بلا مَشَقَّةٍ؛ فخَرَجَ إحْرامُ الجارِيَةِ، ونَجاسَةُ ثَوْبٍ لا يَنْقُصُ بِالغَسْلِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ تَحْليلِها وغَسْلِهِ".
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار. تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخر، ج: 7، ص: 169.
6 - 14
وــــــــــ الشَّيْءَ: جَعَلَهُ يَتَفَرَّقُ وتَتَفَكَّكُ أَجْزاؤُهُ.
"وقَدْ تُحيطُ بِالقَمَرِ دائِرَةٌ أَيْضًا مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ المُحَلِّلِ لِلبُخارِ".
كتاب الآثار العلوية لأرسطو طاليس بترجمة ابن البطريق. تح: كازيمير بترايتس، ص: 89.
"فإِذا بَلَغَتِ الأَجْسادُ نِهايَتَها مِنَ التَّحْليلِ والتَّلْطيفِ، ظَهَرَتْ لَها هُنالِكَ قُوَّةٌ تُمْسِكُ وتَغوصُ وتَقْلِبُ وتَنْفُذُ".
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون. تح: خليل شحادة، ج: 1، ص: 700.
"الأَبْعاضُ الجِسْمانِيَّةُ دائِمَةُ التَّحَلُّلِ والتَّبَدُّلِ (...) والبَدَنُ مُرَكَّبٌ مِنَ الأَعْضاءِ المُرَكَّبَةِ، وهْيَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الأَعْضاءِ البَسيطَةِ مِثْلُ اللَّحْمِ والعَظْمِ، فيَكونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلَ الآخَرِ في الاسْتِعْدادِ للتَّحَلُّلِ؛ فإِذا كانَتِ الأَجْزاءُ كُلُّها مُتَساوِيَةً في ذلِكَ كانَتْ نِسْبَةُ المُحَلِّلاتِ إلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ الأَجْزاءِ كَنِسْبَتِهِ إلى الجُزْءِ الآخَرِ.
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: عمّار بكور، ج: 13، ص: 456.
6 - 15
وــــــــــ فُلانًا الحُلَّةَ: أَلْبَسَهُ إِيّاها.
لَبِسْتَ عَلَيْكَ عِطافَ الحَياءِ***وحَلَّلَكَ المَجْدَ بَنْيُ العَلاءِ
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 531.
"وحَلَّلَهُ الحُلَّةَ: أَلْبَسَهُ إِيّاها". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 303.
6 - 16
وــــــــــ الشَّيْءَ: أَذابَهُ بِخَلْطِهِ بِالماءِ ونَحْوِهِ مِنْ كُلِّ ما يَزيدُهُ مُيوعَةً ورِقَّةً.
"ومِمّا يُعالَجُ بِهِ القُمَّلُ أَنْ يُطْلى أُصولُ ريْشِهِ بِالزَّيْبَقِ المُحَلَّلِ بِدُهْنِ البَنَفْسَجِ".
الجاحظ، كتاب الحيوان. تح: عيون السود، ج: 2، ص: 132.
6 - 17
وــــــــــ الأَمْراضَ والأوْجاعَ: عالَجَها ودَفَعَها عَنِ البَدَنِ.
"الرّابِعُ: حينَ انْحِطاطِهِ، وهو حينَ يَقْوى العُضْو عَلى تَحْليلِ المَرَضِ ونَفْيهِ عَنْهُ، ويَتَّجِهُ العَليلُ إِلى البُرْءِ".
ثابت بن قرة الحراني، كتاب البصر والبصيرة. تح: محمد رواس قلعه جي، وآخر، ص: 89.
"ويُخْرِجُ الرِّياحَ مِنَ الجَوْفِ، ويَقْطَعُ الخامَ الغَليظَ، ويُحَلِّلُ أَوْجاعَ المَفاصِلِ".
يوسف بن عمر التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة. دار الكتب العلمية، ص: 48.
"أَطْنَبَ أَطِبّاؤُهُمْ بِفَوائِدِهِ الدَّوائيَّةِ؛ فذَكَروا أَنَّ مَطْبوخَهُ يَنْفَعُ الصُّداعَ البارِدَ، وخُصوصًا الشَّقيقَةَ، ويُصَفّي الصَّوْتَ، ويُحَلِّلُ أَوْرامَ الحَلْقِ".
أحمد قدامة، قاموس الغذاء والتداوي بالنبات. دار النفائس، ص: 185.
6 - 18
وــــــــــ الشَّيْءَ الصُّلْبُ: صَهَرَهُ ولَيَّنَهُ.
"وزَهْرُ الأُقْحُوانِ يُحَلِّلُ صَلابَتَهُ، ويُحَلِّلُ الأَوْرامَ الصُّلْبَةَ العارِضَةَ للرَّحِمِ إذا جُلِسَ فيهِ".
الرازي، الحاوي في الطب. تح: محمد إسماعيل، ص: 1414.
"والمُتَّخَذُ بِخَلٍّ يَفْتَحُ سُدَدَ الطِّحالِ، ويُحَلِّلُ صَلابَتَهُ".
يوسف بن عمر التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة. دار الكتب العلمية، ص: 296.
"ومِمّا امْتازَ بِهِ الصّينيّونَ تَحْليلُ مُرَكَّباتِ النُّحاسِ والرَّصاصِ والتّوتيا والقَصْديرِ والزِّرْنيخِ والفِضَّةِ والذَّهَبِ، ويسْبِكونَ مِنْها ما شاؤوا آتينَ فيها بِالفُنونِ العَجيبَةِ".
مجلة المقتطف، عدد آب (أغسطس) 1900، ج: 25، ص: 128.
6 - 19
وــــــــــ ما في البَدَنِ: جَعَلَ الجِسْمَ يَسْتَفْرِغُهُ بالتَّعَرُّقِ والإِسْهالِ ورَفْعِ الحَرارَةِ ونَحْوِ ذلِكَ.
"الغَرَضُ في الاسْتِسْقاءِ الأَوَّلِ لِشِفاءِ الوَرَمِ الصُّلْبِ الّذيْ في الكَبِدِ وفي سائِرِ الأَحْشاءِ، وتَحليلِ الرُّطوبَةِ مِنَ البَطْنِ بِالإِسْهالِ والأَضْمِدَةِ وإِدْرارِ البَوْلِ".
الرازي، الحاوي في الطب. تح: محمد إسماعيل، ص: 1184.
"كَماشير: صِمْغٌ يشبه الجاوْشيرَ، وقُوَّتُهَ حارَّةٌ في الدَّرَجَةِ الرّابِعَةِ، يُنْزِلُ الحَيْضَ، ويَطْرَحُ الوَلَدَ، ويُخْرِجُ الجَنينَ، ولا مِثْلَ لَهُ في طَرْحِ الوَلَدِ وإِسْهالِ الماءِ. وخاصّيَّتُهُ: الإِذابَةُ والتَّحْليلُ، ويُنْزِلُ البَوْلَ".
يوسف بن عمر التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة. دار الكتب العلمية، ص: 311.
"والتَّحَلُّلُ عِنْدَ الأَطِبّاءِ اسْتِفْراغٌ غَيْرُ مَحْسوسٍ كانْدِفاعِ الأَبْخِرَةِ، ومَحْسوسٌ كَتَحَلُّبِ العَرَقِ وانْتِفاضِ سائِرِ الفَضَلاتِ، ويُطْلَقُ أَيْضًا عَلى البُحْرانِ الَّذي تَطولُ مُدَّتُهُ ويَنْتَهي إلى الصِّحَّةِ، ويُقالُ لَهُ التَّحليلُ أَيْضًا".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
6 - 20
وــــــــــ الشَّيْءَ (في المَنْطِقِ): أَبْدَلَ بِهِ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمادَّتِهِ وحَدِّهِ، لِلتَّعبيرِ عَنْهُ.
"وإِبْدالُ ما عَنْهُ رُكِّبَ الشَّيْءُ بَدَلَ الشَّيْءِ يُسَمّى تَحْليلَ ما عَنْهُ رُكِّبَ؛ وهذا يُشْبِهُ إِبْدالَ اللَّفْظِ المُرَكَّبِ الدّالِّ عَلى الشَّيْءِ مَكانَ ذلِكَ الشَّيْءِ".
الفارابي، الألفاظ المستعملة في المنطق. تح: محسن مهدي، ج: 1، ص: 89.
6 - 21
وــــــــــ الشَّيْءَ: رَدَّهُ إِلى بَسائِطِهِ الأَوَّليَّةِ المُكَوِّنَةِ لَهُ.
"الغِناءُ إِشارَةٌ إِلى أَلْحانٍ مُؤْتَلِفَةٍ، واللَّحْنُ مُؤَلَّفٌ مِنْ نَغَماتٍ مُتَناسِبَةِ وأَبْياتٍ مُتَّزِنَةٍ، والأَبْياتُ مُؤَلَّفَةٌ مِنَ المَفاعيلِ، والمَفاعيلُ مِنَ الأَوْتادِ،(...)، وعَلى هَذِهِ المِثالات يُعْتَبَرُ طَريقُ التَّحْليلِ حَتّى يَتَّضِحَ أَنَّ الأَشْياءَ المُرَكَّبَةَ مِنْ ماذا هِيَ مُرَكَّبَةٌ ومُؤَلَّفَةٌ؛ فعِنْدَ ذلِكَ يَعْرِفُ حَقيقَتَها".
رسائل إخوان الصفا. مؤسسة هنداوي، ج: 1، ص: 347.
"وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذا سَلَّمَ لَكَ وُجودَ الجَوْهَرِ الفَرْد الَّذي يَنْتَهي إِلَيْهِ تَحْليلُ التَّرْكيبِ، لَمْ يُسَلِّمْ لَكَ أَنَّ الجَواهِرَ مُسْتَوِيَةٌ في الحَقيقَةِ".
ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية. تح: محمد اللاحم، ج: 4، ص: 96.
"كَما نُحَلِّلُ المُرَكَّباتِ في المَعامِلِ الكيميائيَّةِ إِلى عَناصِرِها كَتَحْليلِ الماءِ إِلى أُكْسوجينَ وأُودْروجينَ، هكَذا نُحَلِّلُ الأَعْدادَ إِلى عَوامِلِها الأَوَّلِيَّةِ".
طنطاوي جوهري المصري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم، مطبعة الحلبي، ج: 24، ص: 62.
6 - 22
وــــــــــ الأَمْرَ: دَرَسَهُ وكَشَفَ خَباياهُ.
"وقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ أَوْغَلَ وحَلَّلَ وداخَلَ، غَيْرَ أَنَّهُ حادَ عَنْ مَحَجَّةِ الفُقهاءِ في كَثيرٍ مِنَ المَسائِلِ، وسَلَكَ طَريقَ المُتَكَلِّمينَ الّذينَ هُمْ أَجانِبُ عَنِ الفِقْهِ ومَعانيهِ".
منصور بن محمد السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول. تح: محمد حسن هيتو، ج: 1، ص: 31.
"وهذِهِ المُقَدِّماتُ المَذْكورَةُ إِذا بَحَثْنا عَنْها، وتَصَفَّحْنا جَميعَ المَعْلوماتِ بِالاسْتِقْراء، والتَّركيبِ والتَّحليلِ، وغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الأُمورِ الصِّناعِيَّةِ، وجَدْناها في نَفْسِ الباحِثِ والتَّصَفُّحِ والاسْتِقْراءِ".
ابن سبعين، الكلام على المسائل الصقلية. تح: محمد شرف الدين، ص: 37.
"عَلى أَنَّ الشّاعِرَ الجاهِلِّيَ في مادِّيَّتِهِ لا يُعْنى كَثيرًا بِوَصْفِ أَخْلاقِ المَرْأَةِ، وعَرْضِ نَفْسِيَّتِها، وتَحْليلِ عَواطِفِها، كَما لا يُعْنى بِتَصْويرِ لَواعِجِ نَفْسِهِ، وتَلَمُّسِ خَفاياها".
بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. دار نظير عبود، ص: 68.
6 - 23
وــــــــــ الإِشْكالَ: حَلَّهُ.
"وإِنَّما تَكَلَّمْنا عَلى قِصَّةِ ابْن صَيّادٍ مَعَ كَوْنِ المَقامِ لَيْسَ مَقامَ الكَّلامِ عَلَيْها، لِأَنّها مِنَ المُشْكِلاتِ المُعْضِلاتِ الّتي لا يَزالُ أَهْلُ العِلْمِ يَسْأَلونَ عَنْها، فأَرَدْنا أَنْ نَذْكُرَ هَهُنا ما فيهِ تَحْليلُ ذلِكَ الإِشْكالِ، وحَسْمُ مادَّةِ ذلِكَ الإِعْضالِ".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد صبحي حلاق، ج: 13، ص: 549.
6 - 24
وــــــــــ مادَّةً (في عُلومِ الكيمياءِ والطِبِّ ونَحْوِهِما): عَزَلَ مُكَوِّناتِها لِمَعْرِفَةِ طَبيعَتِها ونِسَبِها.
"وفي القَرْنَ الحادِي عَشَرَ مِنَ الهِجْرَةِ ظهَرَ المُعَلِّمُ مارِقْراقُ، (...)، وفيهِ نَشَأَ المُعَلِّمُ رُوَيْلُ الفَرَنْساوِيُّ، وأَلَّفَ كِتابًا في تَحْليلِ البَوْلِ والدَّمِ؛ فكانَ أبًا لِلكيمْيا الحَيَوانِيَّةِ".
بيرون الحكيم، الجواهر السنية في الأعمال الكيماوية، تر: محمد بن عمر التونسي، مطبعة بولاق، ص: 8.
6 - 25
وــــــــــ النَّصَّ الأَدَبِيَّ: اسْتَخْدَمَ مَنهَجًا ما لِوِصَفِهِ وتَقْويمِهِ؛ وبَيانِ أُسْلوبِ صاحِبِهِ، والعَوامِل المُحيطَةِ الّتي أَثّرتْ فيهِ عِنْدَ كِتابَتِهِ.
"هذا الكِتابُ الثّاني مِنْ (أُدَباءِ العَرَبِ)، يَشْتَمِلُ عَلى خَصائِصِ آدابِ العَبّاسِيِّينَ وعُلومِهِمْ، وميزاتِ شُعَرائِهِمْ وكُتّابِهِمْ، مع اسْتِفاضَةٍ في النَّقْدِ والتَّحْليلِ".
بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية. دار نظير عبود، ص: 3.
6 - 26
وــــــــــ المِقْدارَ الجَبْرِيَّ إِلى العَوامِلِ (في الرّياضيّاتِ): فكَّهُ إِلى مُكَوِّناتٍ أَبْسَطَ عِنْدَ ضَرْبِها مَعًا تُعْطي المِقْدارَ الأَصْلِيَّ؛ كَتَحْليلِ العَدَدِ إِلى عَوامِلِه الأَوَّلِيَّةِ.
"تَحْليلُ العَدَدِ إِلى عَوامِلِه الأَوَّليَّةِ هُوَ عِبارَةٌ عَنْ إيجادِ أَعْدادٍ أَوَّليَّةٍ إِذا ضُرِبَتْ في بَعْضِها يَنْتُجُ العَدَدُ المَفْروضُ".
محمد أفندي شكري، اللآلئ السنية في الأصول الحسابية، مطبعة أمين هندية، ص: 105.
6 - 27
وــــــــــ الشَّيْءَ المَوْضِعَ: أَحَلَّهُ فيهِ.
مُحلِّلُ القَلْبِ أَنْغامًا وأَلْحانا***ومُلْهِمُ الوَحْيِ إِسرْارًا وإعْلاناومُوْقِظُ النَّفْسِ إنْ طافَتْ بها سِنَةٌ***وأَنْتَ تَهْمِسُ بِالأَنْغامِ وَسْنانا
ديوان سيد قطب. دار الوفاء للطباعة والنشر، ص: 228.
7. احْتَلَّ
فعل
7 - 1
* احْتَلَّ العِقابُ: ثَبَتَ ووَجَبَ.
"أَمّا بَعْدُ، فمُنْصِتٌ سامِعٌ لِواعِظٍ نَفْعُهُ إِنْصاتُهُ، وصامِتٌ ذو لُبٍّ شَغَلَ قَلْبَهُ بِالفِكْرِ في أَمْرِ اللهِ حَتّى أَبْصَرَ، فعَرَفَ فضْلَ طاعَتِهِ عَلى مَعْصِيَتِهِ، وشَرَفَ نَهْجِ ثَوابِهِ عَلى احْتِلالٍ مِنْ عِقابِهِ".
ابن هلال الثقفي، الغارات أو الاستنفار والغارات. تح: عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ص: 94.
7 - 2
وــــــــــ فُلانٌ: ضَعُفَ واعْتَلَّ.
*إِمّا تَرَيْني قائِمًا في جِلِّ*
*جَمِّ الفُتوقِ خَلَقٍ هِمِلِّ*
*مُحاذِرًا أَبْغُضُ عَنْ تَحْتَلّي*
*عِنْدَ اعْتِلالِ دَهْرِكِ المُعْتَلِّ*
["عَنْ" هُنا لُغَةٌ في "أَنْ" وهُوَ مِمّا يُسَمّونَهُ عَنْعَنَةَ تَميمِ].
الجاحظ، البيان والتبيين. تح: عبد السلام هارون، ج: 3، ص: 56.
7 - 3
وــــــــــ فُلانٌ المَكانَ وبِهِ: نَزَلَ بِهِ وأَقامَ.
يا دارَ عَمْرَةَ مِنْ مُحْتَلِّها الجَرَعا***هاجَتْ لِيَ الهَمَّ والأَحْزانَ والوَجَعا
ديوان لقيط بن يعمر. تح: محمد ألتونجي، ص: 102.
«أَهلُ الشّامِ وأَزْواجُهُمْ وذُرِّياتُهِمْ وعَبيدُهُمْ وإِماؤُهُمْ إلى مُنْتَهى الجَزيرَةِ مُرابِطونَ في سَبيلِ اللهِ فمَنِ احْتَلَّ مِنْها مَدينَةً مِنْ المَدائِنِ فهُوَ في رِباطٍ، ومَنْ احْتَلَّ مِنْها ثَغْرًا مِنَ الثُّغورِ فهُو في جِهادٍ».
علي بن محمد الربعي، فضائل الشام ودمشق. تح: صلاح الدين المنجد، ص: 11.
حَلَّتْ سُلَيْمى بَطْنَ وجْرَةَ فالرَّجا***واحْتَلَّ أَهْلُكَ بِالسِّخالِ إِلى القُرى
شعر عبدة بن الطبيب. تح: يحيى الجبوري، ص: 90.
*ما احْتَلَّ في أَظْلالِكُمْ مِنْ راجِ*
*إِلّا نَجا بِحَبْلِ النّاجيْ*
رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب. تح: وليم البروسي، ج: 3، ص: 33.
"وبِهِ سُمِّيَ الإِكْليلُ، وهِيَ مَنْزِلَةٌ مِنْ مَنازِلِ القَمَرِ لإِحاطَتِها بِالقَمَرِ إِذا احْتَلَّ بِها".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 6، ص: 126.
"احْتَلَّ المَكانَ وبِهِ احْتِلالًا نَزَلَ بِهِ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 186.
7 - 4
وــــــــــ فُلانًا، وبِهِ، ومَعَهُ: نَزَلَ بِهِ.
قَرِّبْ رِباطَ الجَوْنِ مِنّي فإِنَّهُ***دَنا الحِلُّ واحْتَلَّ الجَميعَ الزَّعانِفُ
شعر همدان وأخبارها. تح: حسن أبو ياسين، ص: 298.
وأُكْرِمُ عِرْضي إِذا احْتُلَّ بي***بِكومِ العِشارِ لِمَشْيٍ بِها
ديوان الأعشى. تح: محمود الرضواني، ج: 1، ص: 12.
"حَلَّ بِالقَوْمِ وحَلَّهُمْ واحْتَلَّ بِهِمْ، واحْتَلَّهُمْ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المخصص. تح: جفال، ج: 3، ص: 312.
"كانَ كاتِبًا ثَرْثارًا، أَديبًا لَوْذَعِيًّا، كَثيرَ النَّظْمِ والنَّثْرِ. كَتَبَ عَنْ أَميرِ المُسْلمينَ أَبي يوسُفَ يَعْقوبَ، وابْنِهِ أَبي يَعْقوبَ، واحْتَلَّ مَعَهُما بِظاهِرِ غَرْناطَةَ".
ابن الخطيب، الإحاطة. تح: يوسف علي طويل، ج: 4، ص: 344.
7 - 5
وــــــــــ فُلانٌ البَعيرَ ونَحْوَهُ: حَلّ عَنْهُ رِباطَهُ.
"لَمْ يَحُدَّ لَنا مالِكٌ في ذلِكَ حَدًّا؛ إِلّا أَنَّهُ إِذا احْتَلَّهُ عَنْ مَرْبِطِهِ وسارَ بِهِ وصارَ في يَدَيْهِ قُطِعَ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 4، ص: 538.
7 - 6
وــــــــــ السُّلْطَةَ والمَكانَةَ ونَحْوَهُما: شَغَلَها.
"وأَمّا المُوْجَزُ ففيهِ ما لا يَحْسُنُ بِمُتَتَبِّعِ الأَدَبِ، والنّاظِرِ في النَّسَبِ جَهْلُهُ؛ فذَكَرَ فيهِ مَنْ يُنْسَبُ إِلى بَطْنٍ وقَبيلٍ، وشَريفَ كُلِّ قَوْمِ وشاعِرَهُمْ، ومَنِ احْتَلَّ السُّلْطَةَ فيهِمْ، واسْتَولى عَلى الرِّئاسَةِ مِنْهُمْ".
حمزة الأصفهاني، التنبيه على حدوث التصحيف. تح: محمد طلس، ص: 126.
"سَلامٌ كَريمٌ طَيِّبٌ (...) يَخُصُّ مَقامَكُمْ الّذيْ تَزَيَّنَ بِالكَمالِ وتَزَيّا، واحْتَلَّ مَرْتِبَةَ المَجْدِ الصُّراحِ والحَسَبِ الوَضّاحِ".
ابن الخطيب، ريحانة الكتاب. تح: محمد عبد الله عنان، ج: 2، ص: 34.
"وتَعَرَّفَ مُطْرانُ بِكبارِ رِجالِ مِصْرَ في القاهِرَةِ، وسَرْعانَ ما احْتَلَّ مَكانَةً بارِزَةً في هَيْئَةِ المُجْتَمَع ِالمِصْريِّ بِأَخْلاقِهِ الكَريمَةِ".
إسماعيل أدهم، شعراء معاصرون. دار المعارف،ج: 2، ص: 245.
7 - 7
وــــــــــ الجَيْشُ البَلَدَ: اسْتَوْلَى عَلَيْهِ بِالقُوَّةِ
"فبِأَيْدي عَساكِرِهِ الحُصونُ الجَبَليَّةُ جَميعًا، ومِنْها القَلْعَةُ الّتي احْتَلَّها الإِسْبانِيّونَ في البَدْءِ عَلى جَبَلِ الشّاراتِ".
بطرس البستاني، معارك العرب في الأندلس. دار مارون عبون، ص: 106.
8. انْحَلَّ
فعل
8 - 1
* انْحَلَّ الشَّيْءُ المَعْقودُ: تَفَكَّكَتْ عُقَدُهُ.
"فتَلافَيا أَمْرَكُما قَبْلَ انْتِكاثِ العَهْدَ، وانْحِلالِ العَقْدِ، وتَشَتُّتِ الأُلْفَةِ".
أبو علي القالي، الأمالي. ج: 1، ص: 123.
«يَعْقِدُ الشَّيْطانُ عَلى قافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاثَ عُقَدٍ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَويلًا فارْقُدْ (...) قال: وإذا اسْتَيْقَظَ فذَكَرَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ انْحَلَّتْ عُقْدُةٌ، فإِذا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتانِ، فإِذا صَلّى انْحَلَّتِ العُقَدُ وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشيطًا».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 12، ص: 258.
ولا تَكُ واثِقًا بِالدَّهْرِ يَوْمًا***فإِنَّ الدَّهْرَ مُنْحَلٌّ النِّظامِ
ديوان عليّ بن أبي طالب. تح: عبد العزيز الكرم، ص: 93.
"فإِذا فعَلوا ذلِكَ فسَدَ أَمْرُهُمْ، وانْحَلَّ اعْتِقادُ النّاسِ فيهِمْ".
الحسن العباسي، آثار الأول في ترتيب الدول. تح: عبد الرحمن عميرة، ص: 127.
"وقَدْ انْحَلَّ بِهذا عِصامُ قِرْبَةِ مَنْ قالَ إنَّه لَوْ كَفى في التَّوحيدِ الاخْتِصاصُ في الواقِعِ فلا إلهَ إلّا الرَّحْمُنُ أيضًا تَوْحيدٌ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 1، ص: 225.
8 - 2
وــــــــــ الشَّيْءُ: انْعَدَمَ وانْتَفى.
"بَلْ لَيْلَةُ الخَميسِ، فيَغْفِرُ لِلمُؤْمِنينَ ويُمْلي لِلكافِرينَ، ويَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ حَتّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ".
عبد الله بن وهب، الجامع في الحديث. تح: مصطفى أبو الخير، ص: 376.
"فعِنْدَ الصَّفْوِ مِنْ مُفارَقَةِ الكَدَرِ، تَعيشُ الأَرْواحُ عيشَةَ الأَبَدِ الّذي لا يَصِلُ إِلَيْهِ انْحِلالٌ ولا اضْمِحْلالٌ".
الواقدي، فتوح الشّام. تح: عبد اللّطيف عبد الرّحمن، ج: 1، ص: 287.
"وبِهذا يَنْحَلُّ ما قيلَ: إِنَّهُمْ إِنْ كانوا قَدْ آمَنوا بِكَوْنِ أَبيهِمْ رَسولًا حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعالى، فكَيْفَ اعْتَرَضوا، وكَيْفَ زَيَّفوا طَريقَتَهُ وطَعَنوا فيما هُوَ عَلَيْهِ؟ وإنْ كانوا مُكَذِّبينَ بِذلِكَ فهوَ يوجِبُ كُفْرَهُمْ والعياذُ بِاللهِ تَعالى، وهُوَ مِمّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، ووَجْهُ الانْحِلالِ ظاهِرٌ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 12، ص: 221.
8 - 3
وــــــــــ جِسْمُ فُلانٍ أَو قُواهُ: ضَعُفَ.
"فاغْتَمَّ لُقْمانُ لِمَوْتِهِ، وجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَديدًا، وانْحَلَّ جِسْمُهُ".
ابن هشام الحميري، التيجان في ملوك حمير. تح: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ص: 373.
"وكانَ بِالقُرْبِ مِنْهُمْ بازٌ قَدْ كَبِرَ وخَرِفَ، وضَعُفَتْ قُوَّتُهُ عَنِ الصَّيْدِ، وانْحَلَّ جِسْمُهُ، وتَناثَرَ ريشُهُ مِنْ قِلَّةِ المَعيشَةِ".
رسائل إخوان الصفا. مؤسسة هنداوي، ج: 2، ص: 468.
"ولا شَكَّ أنَّ المَطْعَمَ، والمَشْرَبَ، والمَلْبَسَ مِنَ الأُمورِ الضَّروريَّةِ لِلإنْسانِ؛ الّتي تُصانُ بِها حَياتُه، وجِسْمُهُ، وتَحْفَظُها من الانْحِلالِ، والتَّغَيُّرِ".
المناوي، الإتحافات السنية. تح: عبد القادرالأرناؤوط، وآخر، ص: 139.
"أَطْوارُ النُّمُوِّ في الرَّجُلِ ثَلاثَةٌ، وهِيَ: طَوْرُ التَّسْنينِ، وطَوْرُ البُلوغِ، وطَوْرُ الانْحِلالِ".
مجلة المقتطف، المجلد 29، عدد شهر أيلول (سبتمبر) 1904م، ص: 801.
8 - 4
وــــــــــ السِّعِرُ: نَزَلَ.
"وانْحَلَّ السِّعْرُ عِنْدَ دُخولِ الغَلّاتِ".
الطبري، تاريخ الرسل والملوك. تح: أبو الفضل إبراهيم، ج: 11، ص: 357.
"وفيهِ قَدِمَ الطَّواشيُّ مُرْجانُ الهِنْديُّ الخازِنْدارُ مِنَ الصَّعيدِ بِغِلالٍ كَثِيرَةِ؛ وقَدِ انْحَلَّ السِّعرُ فبيعَ الإِرْدَبُّ القَمْحُ بِمائَتَينِ وسَبْعينَ دِرْهَمًا".
المقريزي، السلوك. تح: محمد عطا، ج: 6، ص: 408.
8 - 5
وــــــــــ الإشْكالُ: ظَهَرَ حَلُّهُ واتَّضَحَ.
"لَوْ كانَ كُلُّ عِلْمٍ مُحْتاجًا إلى المَنْطِقِ، لَكانَ المَنْطِقُ مُحْتاجًا إلى نَفْسِهِ، أو إلى مَنْطِقٍ آخَرَ يَنْحَلُّ بِهِ".
ابن سينا، الإشارات والتنبيهات. تح: نصر الدين الطوسي، ج: 1، ص: 9.
"إِذا عَلِمْتَ ذلِكَ انْحَلَّ إِشْكالُ قَوْلِهِ".
ابن قيم الجوزية، شفاء العليل. تح: الحساني حسن عبد الله، ج: 1، ص: 33.
"وببَيانِ الأَصْلِ انْحَلَّ إِشْكالانِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 2، ص: 366.
8 - 6
وــــــــــ الشَّيْءُ (في الماءِ ونَحْوِهِ): ذابَ وانْماعَ.
"المُخْتارُ مِنْهُ هُوَ الرَّزينُ الحادُّ الرّائِحَةِ، الهَشُّ السَّهْلُ الانْحِلالِ في الماءِ".
ابن سينا، القانون في الطب. تح: محمد الضناوي، ج: 1، ص: 366.
"والجَيِّدُ مِنْهُ ما كانَ حَديثًا قَوِيَّ الرّائِحَةِ، خالِصَها، لَيْسَ فيهِ مِنْ رائِحَةِ الحُموضَةِ شَيْءٌ، سَريْعُ الانْحِلالِ بِالماءِ".
يوسف بن عمر التركماني، المعتمد في الأدوية المفردة. دار الكتب العلمية، ص: 27.
"وعِنْدَ اسْتِعْمالِهِ يُنْقَعُ في الماءِ السّاخِنِ حَتّى يَنْحَلَّ، ويُضافُ إِلَيْهِ السُّكَّرُ".
محمد شفيق غربال وآخرون، الموسوعة العربية الميسرة. ص: 2585.
8 - 7
وــــــــــ الشَّيْءُ: تَفَسَّخَ وتَحَلَّلَ.
"افْهَمْ أَنَّ المَوْتَ زَمانَةٌ مُطْلَقَةٌ في جَميعِ الأَعْضاءِ بِبُطَلانِ قُواها (...) ولَعَلَّهُ لَمْ يَبْقَ فيكَ مِنْ تِلْكَ الأَجْسامِ شيْءٌ، بَلِ انْحَلَّ كُلُّها وحَصَلَ بِالغِذاء بَدَلُها".
الأمام الغزالي، الأربعين في أصول الدين. تح: محمد بشير الشقفة، ص: 270.
"حَضَرَ مَعَ المُباشِرينَ في نَوْبَةِ لولو غُلام قُنْدُسَ سَنَة ثَلاثٍ وثَلاثينَ وسَبْعِ مِئَةٍ، وسَلَّمَهُمْ المَلِكُ النّاصِرُ مُحَمَّدٌ إِلَيْهِ، فتَوَلّى عِقابَهُمْ، وصَبَّ عَلى هَذا بَهاءُ الدّينِ سَوْطَ عَذابِ، انْحَلَّ بِهِ جَسَدُهُ وأَذابَ".
الصفدي، أعيان العصر. تح: علي أبوزيد، وآخرين، ج: 2، ص: 29.
"وقالَ آخَرونَ إِنَّ المَوادَّ الآليَّةَ تَخْتَلِفُ في صِفاتِها عَنِ المَوادِّ غَيْرِ الآليَّةِ؛ بِدَليلِ كَوْنِها أَسْرَعَ مِنَ المَوادِّ غَيْرِ الآلِيَّةِ انْحِلالًا".
مجلة المقتطف، العدد 12، أيلول (سبتمبر)، 1893م، ج: 12، ص: 795.
8 - 8
وــــــــــ أخْلاقُ فُلانٍ: اشْتَدَّ فسادُها؛ فتَحرَّرَ مِنْ كُلِّ قَيْدٍ تُمْليهِ المُروءَةُ أَوِ الدّينُ.
"الفَلْسَفَةُ رَأْسُ السَّفَهِ والانْحِلالِ، ومادَّةُ الحَيْرَةِ والضَّلالِ، ومَثارُ الزَّيْغِ والزَّنْدَقَةِ".
ابن الصلاح، فتاوى ومسائل ابن الصّلاح. تح: عبد المعطي قلعجي، ج: 0، ص: 209.
"وإِذا عُرِفَ ضَعْفُ أُصولِ النُّفاةِ لِلصِّفاتِ فيما يُنَزِّهونَ عَنْهُ الرَّبَّ، فهَؤُلاءِ الرّافِضَةُ طافوا عَلى أَبْوابِ المَذاهِبِ، وفازوا بِأَخَسِّ المَطالِبِ، فعُمْدَتُهُم في العَقْليّاتِ عَلى عَقْلِيّاتٍ باطِلَةٍ، وفي السَّمْعِيّاتِ عَلى سَمْعِيّاتٍ باطِلَةٍ؛ ولِهذا كانوا مِنْ أَضْعَفِ النّاسِ حُجَّةً، وأَضْيَقِهِمْ مَحَجَّةً، وكانَ الأَكابِرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ مُتَّهَمينَ بِالزَّنْدَقَةِ والانْحِلالِ".
ابن تيمية، منهاج السنة النبوية. تح: محمد رشاد سالم، ج: 2، ص: 565.
"وشُغِفوا بِهِ إِذْ رَأَوْهُ يُلائِمُ روحَ الشَّرْقِ، في حِرْمانِهِ الحُرِّيَّةِ، ومُكابَدَتَهِ الأَذى والضَّيْمِ، وفي انْحِلالِ أَخْلاقِهِ".
بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث. دار نظير عبود، ص: 388.
8 - 9
وــــــــــ الأملاكُ: صارَتْ بِلا صاحِبٍ وآلَتْ لِلدَّوْلَةِ.
"وتَقَدَّمَ في ذلِكَ الوَقْتِ شَخْصٌ مِنَ المَماليكِ السُّلْطانِيَّةِ اسْمُهُ لاجينُ الزَّبينيُّ (...) وضَمَّ إِلَيْهِ جَماعَةً مِنَ الخاصِكيَّةِ، واسْتَمالَهُمْ بِالخُشْداشِيَّةِ، فأَخَذَ لَهُمُ الإِقْطاعاتِ، واسْتَنْجَزَ لَهُمُ الصّلاتِ فكانَ كُلّما انْحَلَّ بِديوانِ الجّيْشِ المَنْصورِ إقْطاعٌ لَهُ صورَةٌ يُسارِعُ إلى أَخْذِهِ لِمَنْ يَخْتارُ".
بيبرس الدويدار، زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تح: دونالد ريتشاردز، ج: 1، ص: 164.
8 - 10
وــــــــــ المُعادَلَةُ الرِّياضِيَّةُ: أَمْكَنَ إِيْجادُ قِيْمَةِ المَجْهولِ أَوِ المَجْهولاتِ فيها، وإِلّا كانَتْ مُعادَلَةً غَيْرَ قابِلَةٍ لِلحَلِّ.
"حَلُّ المُعادَلَةِ هُوَ تَبْيينُ مِقْدارِ مَجْهولِها، أَوْ مَقاديرِ مَجْهولاتِها إِنْ كانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلى مُجْهولاتٍ مُتعَدِّدَةٍ، بِواسِطَةِ البَحْثِ عَنْ ذلِكَ، فإِذا وُجِدَتْ تِلْكَ المَقادِيْرُ انْحَلَّتِ المُعادَلَةُ".
ماير، كتاب الجبر والمقابلة، تر: محمد بيومي، مطبعة بولاق، ص: 56.
8 - 11
وــــــــــ العُنْصُرُ المُشِعُّ (في الفيزياءِ): فقَدَتْ نُوى ذَرّاتِهِ غَيْرُ المُسْتَقِرَّةِ طاقَتَها تِلْقائيًّا عَنْ طَريقِ انْبِعاثِ الإشْعاعاتِ النَّوَوِيَّةِ أَوِ الجُسَيْماتِ؛ فيَتَحَوَّلُ إِلى عُنْصُرٍ آخَرَ.
"أَمّا الجَديدُ في هذِهِ التَّجارِبِ فهْوَ أَنَّ عُنْصُرَ الأُورانيومِ -عَلى ما يَعْلَمُ قُرّاءُ المُقتَطَفِ- أَثْقَلُ العَناصِرِ إِطْلاقًا، وهُوَ عُنْصُرٌ مُشِعٌّ يَنْحَلُّ مِنْ تَلْقاءِ نَفْسِهِ انْحِلالًا بَطيئًا فتَنْطَلِقُ مِنْهُ طاقَةٌ في خِلالِ هذا الانْحِلالِ".
مجلة المقتطف، العدد: 4، نيسان (أبريل) 1939م، ج: 94، ص: 467.
8 - 12
وــــــــــ عَنْهُ: فارَقَهُ.
*أَنْعَظَ حَتَّى انْحَلَّ عَنْهُ جُلُّهُ**كَأَنَّ حُمَّى خَيْبَرٍ تُعِلُّهُ*
ليلى الأخيليّة، ديوان ليلى الأخيليّة. تح: واضح الصّمد، ص: 99.
"إِذا حَدَثَ بِصاحِبِ البَلْغَمِ الأَبْيَضِ اخْتِلافٌ قَوِيٌّ انْحَلَّ مَرَضُهُ عَنْهُ".
الرازي، الحاوي. تح: محمد إسماعيل، ص: 1215.
"وانْحَلَّ العَسْكَرُ عَنِ الحِصْنِ إِذْ ذاكَ".
ابن عذاري، البيان المغرب. تح: بشار عواد وآخر، ج: 2، ص: 135.
"وبِهَذا يَنْحَلُّ عَنِ العَبْدِ الإِشْكالُ، ويَتَّسِعُ قَلْبُهُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ إِثْباتِ عُمومِ مَشيئَةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ وشُمولِهِما لِأَفْعالِ العِبادِ، مَعَ وُقوعِها شَرْعًا وحِسًّا وعَقْلًا بِاخْتِيارِهِمْ".
مجموع مؤلفات عبد الرحمن السعدي. ج: 6، ص: 616.
8 - 13
وــــــــــ يَمينُ فُلانٍ، وعَنْهُ: سَقَطَ إلزامُها عَنْهُ.
"وتَنْحَلُّ اليَمينُ بوجودِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ".
محمد بن الحسن، المخارج في الحيل. ص: 121.
"وعَلى هذا إذا قالَ لِآخَرَ إنِ ابْتَدَأْتُكَ بِكَلامٍ فعَبْدي حُرٌّ، فالْتَقَيا فسَلَّمَ كُلٌّ عَلى الآخَرِ مَعًا لا يَحْنَثُ وانْحَلَّتْ يَمينُهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ بَعْدَ ذلِكَ ابْتِداءً".
ابن الهمام، شرح فتح القدير. دار الفكر، ج: 5، ص: 134.
"فإِنِ ارْتَجَعَ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَمَّتْ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ عَنْهُ الإيْلاءُ، وإِلّا أُلْغِيَتْ".
[الإِيلاءُ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِقَصْدِ إِيذائِها]
8 - 14
وــــــــــ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ: انْفَصَلَ عَنْهُ.
"وأَمّا العَرَقُ فيَعْرِضُ لَهُمْ بِسَبَبِ ضَعْفِ القُوَّةِ لِأَنَّ الغِذاءَ يَنْحَلُّ مِنْ أَبْدانِهِمْ، ويَتَشَوَّقونَ إِلى السُّعالِ".
الرازي، الحاوي. تح: محمد إسماعيل، ص: 718.
"قوقانا: جَبَلٌ في بِلادِ الأَتْراكِ، (...) قائِمُ الجِهاتِ لا يُصْعَدُ مِنْهُ إِلى شَيْءٍ البَتَّةَ، وإِنْ صُعِدَ لَمْ يُتَوَصَّلْ إِلى قِمَّتِهِ لِكَثْرَةِ الثَّلْجِ المُنْعَقِدِ فيهِ، وأَنَّهُ لا يَنْحَلُّ مِنْهُ أَبَدًا".
ابن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار. تح: إحسان عباس، ص: 484.
8 - 15
وــــــــــ فُلانٌ عَنْ وِثاقِهِ: أَفْلَتَ وخَرَجَ مِنْهُ.
"هذِهِ الحَوانيتُ وضَرْبُ هؤُلاءِ عَلى السِّنْداناتِ، طِلَسْمٌ عَلى البَيْوَراسْفِ لِئلّا يَنْحَلَّ عَنْ وِثاقِهِ، وإِنَّهُ لَدائِبٌ بِلَحْسِ سَلاسِلِهِ وأَغْلالِهِ".
[بَيْوَراسْفُ (الضَّحّاكُ): مَلِكٌ أُسْطوريٌّ فارِسيٌّ]
ابن الفقيه، كتاب البلدان. تح: يوسف الهادي، ص: 553.
"وأَمّا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ رَأْيٌ أَوْ هَوًى فإِنَّهُ يَنْحَلُّ عَنْ رِبْقَةِ الشّارِعِ إِذا عايَنَ الجَبْرَ، ويَقولونَ ما يَقولُهُ المُشْرِكونَ".
ابن تيمية، دقائق التّفسير. تح: محمّد الجليند، ج: 5-6، ص: 135.
والمَوْجُ كالخَيْلِ الجَوامِحِ أُطْلِقَتْ***وانْحَلَّ عَنْها مِقْوَدٌ ولِجامُتَجْري السَّفائِنُ فوْقَهُ وكَأَنَّها***والرّيحُ تَدْفَعُ بِالشِّراعِ حَمامُ
ديوان علي الجارم. دار الشّروق، ص: 311.
8 - 16
وــــــــــ الشَّيْءُ إِلى شَيْءٍ آخَرَ: آلَ إِلَيْهِ.
"فإِذا وقَفَتْ أُمورُهُ قَبَضَ عَلى وزيرِهِ واسْتَبْدَلَ بِهِ، فلا يَلْبَثُ الأَمْرُ أَنْ يَعودَ مِنَ الالْتِياثِ، والانْحِلالِ إِلى أَسْوأَ ما كانَ".
مسكويه، تجارب الأمم. تح: سيد كسروي، ج: 5، ص: 392.
"وكَما أَنَّ السَّكْتَةَ تَنْحَلُّ إِلى فالِجٍ، فكَذلِكَ كَثيرٌ مِنَ الصَّرَعِ يَنْحَلُّ إِلى فالِجٍ".
ابن سينا، القانون في الطب. تح: محمد الضناوي، ج: 1، ص: 122.
"ولَوْ قالَ: (إِنْ رَكِبْتِ فأَنْتِ طالِقٌ) (...) انْحَلَّ إِلى مَنْعِها مِنَ الرُّكوبِ".
أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحرير الفتاوى. تح: عبد الرحمن الزواوي، ج: 2، ص: 756.
"كَماءِ البَحْرِ وإِنْ كانَ مُتَغَيِّرَ الطَّعْمِ، وما يَنْعَقِدُ مِنْهُ المِلْحُ، ويَنْحَلُّ إِلَيْهِ البَرَدُ".
سعيد بن محمّد الحضرميّ، شرح المقدّمة الحضرميّة. دار المنهاج، ص: 72.
8 - 17
وــــــــــ أَجْزاءُ الشَّيْءِ المُرَكَّبِّ إِلى مُكَوِّناتِهِا: لَحِقَتْ بِها وعادَتْ إِلَيْها.
"كُلُّ شَيْءٍ مُرَكَّبٍ مِنْ بَسائِطَ فإِنَّهُ يَنْحَلُّ إِلى بَسائِطَ، والإِنْسانُ مُرَكَّبٌ مِنْ سَبَبَيْنِ رَوْحانيٍّ وجِسْمانِيٍّ، ونَحْنُ نَرى الإِنْسانَ إِذا ماتَ لَحِقَ جِسْمُهُ بِجِسْمانِيِّ مِثْلِهِ فكَذَلِكَ رَوْحانِيَّتُهُ يَجِبُ أَنْ تَلْحَقَ بِرَوْحانِيٍّ مِثْلِها".
البطليوسي، رسائل في اللّغة. تح: وليد محمّد السراقبيّ، ص: 372.
"كُلُّ شَيْءٍ مُرَكَّبٌ مِنَ البَسائِطِ فإِنَّهُ يَنْحَلُّ إِلى بَسائِطَ".
ابن سبعين، الكلام على المسائل الصقلية. تح: محمد شرف الدين، ص: 191.
"إنَّ بَدْءَ الإنْسانِ ونَحْوِهِ لَيْسَ اخْتِراعًا مَحْضًا وإِخْراجًا مِن كَتْمِ العَدَمِ إلى الوُجودِ في الحَقيقَةِ؛ لِما أَنَّهُ مَخْلوقٌ مِنَ التُّرابِ وسائِرِ العَناصِرِ، والظّاهِرُ أَنَّ فناءَهُ لَيْسَ عِبارَةً عَنْ صَيْرورَتِهِ عَدَمًا مَحْضًا، بَلْ هُوَ عِبارَةٌ عَنِ انْحِلالِهِ إِلى ما تَرَكَّبَ مِنْهُ، ورُجُوعُ كُلِّ عُنْصُرٍ إلى عُنْصُرِهِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 20، ص: 331.
8 - 18
وــــــــــ اللَّفْظُ (عِنْدَ النُّحاةِ) إِلى آخَرَ: أُوِّلَ بِهِ.
"هذِهِ عِلَّةُ امْتِناعِ الجَمْعِ فيهِ؛ لِأَنَّكَ لَوْ جَمَعْتَهُ كانَ جَمْعًا لِواحِدٍ مِنْ لَفْظِهِ، ولا يُؤَكِّدُهُ مَعْنى الجَمْعِ إِلّا بِجَمْعٍ لا يَنْحَلُّ إِلى الواحِدِ".
السهيلي، نتائج الفكر في النحو. تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخر، ص: 225.
"﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ أيْ يَوْمَ إذْ غُشِيَتْ، والتَّنْوِينُ عِوَضٌ مِنَ الجُمْلَةِ، ولَمْ تَتَقَدَّمْ جُمْلَةٌ تَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ التَّنْوينُ عِوَضًا مِنْها، لَكِنْ لَمّا تَقَدَّمَ لَفْظُ الغاشِيَةِ، وأَلْ مَوْصولَةٌ بِاسْمِ الفاعِلِ، فتَنْحَلُّ لِلَّتي غَشِيَتْ، أَيْ لِلدّاهِيَةِ الَّتي غَشِيَتْ؛ فالتَّنْوِينُ عِوَضٌ مِنْ هذِهِ الجُمْلَةِ الَّتي انْحَلَّ لَفْظُ الغاشِيَةِ إلَيْها".
أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط. عادل عبد الموجود وآخرين، ج: 8، ص: 457.
"والواوُ لِلْعَطْفِ، وما بَعْدَهُ قيلَ: مَعْطوفٌ عَلى الأَمْرِ الّذي يَنْحَلُّ إِلَيْهِ المَصْدَرُ مَعَ أَنْ؛ أَيْ أَنْ أَقْسِطوا، والمَصْدَرُ يَنْحَلُّ إِلى الماضي والمُضارِعِ والأَمْرِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: فادي المغربيّ وآخرين، ج: 9، ص: 79.
9. تَحالّ
فعل
9 - 1
* تَحالَّ الرَّجُلانِ: أَحَلَّ كُلٌّ مِنْهُما الثّاني مِمّا يُطالِبُهُ بِهِ، وأَبْرَأَهُ مِنْهُ.
«أَمّا إِذْ فعَلْتُما ما فعَلْتُما فاقْتَسِما، وتَوَخَّيا الحَقَّ، ثمَّ استَهِما، ثُمَّ تَحالّا».
سنن أبي داود. تح: شعيب الأرناؤوط، وآخرين، ج: 5، ص: 438.
"يَصْطَلِحانَ عَلى ما أَحَبّا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ ورِقٍ أَوْ عَرَضِ، ويَتَحالّانِ".
مالك بن أنس، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 3، ص: 396.
"هذا الحَديثُ أَخْرَجَهُ أبو داودَ، وفيهِ أَيْضًا دَليلٌ عَلى ما ذَكَرْنا مِنْ جَوازِ البَراءَةِ عَنِ الدُّيونِ المَجْهولَةِ؛ إذِ الأَشْياءُ الدّارِسَةُ الأَظْهَرُ أَنَّها تَكونُ مَجْهولَةً، ولِأَنَّ النّاسَ ما زالوا قَديمًا وحَديثًا يَتَحالَلونَ عِنْدَ المُعاقَداتِ وعِنْدَ المَوْتِ، مَعَ جَهالَةِ قَدْرِ ما يَقَعُ التَّحالُلُ مِنْهُ".
ابن التركماني، الجوهر النقي، دار الفكر، ج: 6، ص: 66.
9 - 2
وــــــــــ القَوْمُ: حَلَّ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ.
"أَخْصَبَ جَنابُ الحِجازِ الشّامِيِّ فمالَتْ لِذلِكَ الخِصْبِ بَنو فزارَةَ وبَنو مُرَّةَ، فتَحالّوا جَميعًا بِهِ".
أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني. تح: إحسان عباس، وآخرين، ج: 2، ص: 204.
"تَحالَّ القَوْمُ: حَلَّ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ".(وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم. تح: حسين بن عبد الله وآخرين، ج: 3، ص: 1305.
9 - 3
وــــــــــ القَوْمُ: أنْزَلوا أَمْتِعَتَهُمْ مُتَقارِبينَ بَعْدَ تَرْحالٍ.
" فلَمْ يُفْقَدْ حَتّى تَحالَّ النّاسُ عِنْدَ المَساءِ".
معمر بن المثنى، كتاب النقائض. تح: محمد إبراهيم حور وآخر، ص: 903.
10. تَحَلَّلَ
فعل
10 - 1
* تَحَلَّلَتِ العُقْدَةُ والحَبْوَةُ: انْحَلَّتْ.
ولَقَدْ نَكونُ إِذا تَحَّلَّلَتِ الحُبا***مِنّا الرَّئِيْسُ ابْنُ الرَّئيسِ الـمَقْنَعُ
[الحبوة من الاحتباء وهو: أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشُدّه عليها]
ديوان الأفوه الأوديّ. تح:محمّد ألتّونجي، ص: 94.
10 - 2
وــــــــــ المُحْرِمُ: خَرَجَ مِنْ إِحْرامِهِ، وأُبيحَ لَهُ ما كانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ مِنْ مَحْظوراتِ الإحْرامِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ.
«مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ مِنْكُمْ فإنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدى فلْيَطُفْ بِالبَيْتِ والصَّفا والمَرْوَةِ ولْيَتَحَلَّلْ».
البيهقي، السنن الكبرى. تح: محمد عطا، ج: 5، ص: 24.
"لا يُنْحَرُ دونَ يَوْمِ النَّحْرِ، ولا يَتَحَلَّلُ دونَ يَوْمِ النَّحْرِ".
محمد بن الحسن الشيباني، الجامع الصّغير وشرحه النّافع الكبير. عالم الكتب، ص: 157.
"وفيهِ دَليلٌ لِجَوازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنَ العُمْرَةِ، وقَبْلَ الإِحْرامِ بِالحَجِّ".
النووي، صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة، ج: 9، ص: 98.
"ولا يَجوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ تَمامِ نُسُكِهِ كَما تَقَدَّمَ".
مصطفى السّيوطيّ، مطالب أولي النّهى. المكتب الإسلامي، ج: 2، ص: 320.
10 - 3
وــــــــــ فُلانٌ: ضَعُفَ وانْحَلَّتْ قُواهُ.
"لَمّا كانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمينَ يُقاتِلُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكينَ، وآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِن ورائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فأَسْرَعْتُ إلى الّذي يَخْتِلُهُ، فرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَني، وأَضْرِبُ يَدَهُ فقَطَعْتُها، ثُمَّ أخَذَني فضَمَّني ضَمًّا شَديدًا، حتّى تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَرَكَ، فتَحَلَّلَ، ودَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ".
البخاري، الصحيح. تح: العطّار، ص: 1052.
"فإِنْ قيلَ: ما الجَوابُ عَنْ حَديثِ «الماءُ مِنَ الماءِ»؟ قُلْنا إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلى المَعْهودِ المَعْروفِ الّذي يَخْرُجُ بِلَذَّةٍ، ويُوْجِبُ تَحَلُّلَ البَدَنِ وفُتورَهُ".
محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع. تح: عمر الحفيان، ص: 334.
10 - 4
وــــــــــ الشَّيْءُ: تَفَكَّكَتْ أَجْزاؤُهُ وتَفَسَّخَتْ.
قامَتْ تَراءى لَنا والعَيْنُ ساجِيَةٌ***كَأَنَّ إِنْسانَها في لُجَّةٍ غَرِقُكَأَنَّهُ حينَ مارَ المَأْقَيانِ بِهِ***دُرٌّ تَحَلَّلَ مِنْ أَسْلاكِهِ نَسَقُ
ديوان كُثيِّر عزّة. تح: إحسان عباس، ص: 467.
"أَوْ قَدْ كانَ يابِسًا فأُخِذَتْ حَرارَتُهُ؛ فلِذلِكَ كانَ بارِدًا يابِسًا صَعْبٌ عَلى النّارِ أَنْ تُحَلِّلَهُ بِالإِضافَةِ إِلى ما تَحَلَّلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الطّبائِعِ، فقَدِ انْقَلَبَتِ الحَرارَةُ إِلى البُرودَةِ".
رسائل جابر بن حيان. تح: أحمد فريد المزيدي، ص: 495.
"ولِرَشيدِ الدّينِ أَبي حُليقَةَ مِنَ الكُتُبِ (...) مَقالَةٌ في ضَرورَةِ المَوْتِ، ذُكرَ في هذِهِ المَقالَةِ أنَّ الإنْسانَ (لَمّا) لَمْ يَزَلْ يَتَحَلَّلُ مِنْ بَدَنِهِ بِالحَرارَةِ الّتي في داخِلِهِ، وبِحَرارَةِ الهَواءِ الّذي مِنَ الخارِجِ، كانَتْ نِهايَتُهِ إِلى الفَناءِ بِهذَيْنِ السَّبَبَيْنِ".
ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء. تح: نزار رضا، ص: 597.
"إنَّ في الحَرَكَةِ -كَما قيلَ- بَرَكَةً؛ أَيْ: بَرَكَةٌ في الجِسْمِ بِالسَّيْرِ بِما يُعيدُهُ السَّيْرُ مِنْ صِحَّتِهِ؛ لِخُروِجِ فضَلاتِهِ، وتَحَلُّلِ مَوادِّهِ الّتي تَسْتَرْخيهِ وتُذَيِّلُهُ".
سيدي المختار الكنتي، فتح الودود. تح: مأمون محمد أحمد، ص: 585.
10 - 5
وــــــــــ المُصَلِّي: خَرَجَ مِنْ صَلاتِهِ.
"وأَمّا الّذي يَتَكَلَّمُ ساهيًا فلا يَقْصِدُ التَّحَلُّلَ مِنْ صَلاتِهِ، ولَوْ قَصَدَ ذلِكَ لَأَبْطَلَ صَلاتَهُ".
أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ. تح: محمد عطا، ج: 2، ص: 86.
"احْتَجَّ عُلَماؤُنا وغَيْرُهُمْ بِهذِهِ الآيَةِ ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ عَلى أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ التَّطَوِّعِ -صَلاةً كانَ أَوْ صَوْمًا- بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ لا يَجوزُ؛ لِأَنَّ فيهِ إبْطالَ العَمَلِ، وقَدْ نَهى اللهُ عَنْهُ".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 19، ص: 287.
"ولَوْ نَسِيَ سُجودَ السَّهْوِ، وشَرَعَ في صَلاةٍ أُخْرى ثُمَّ ذَكَرَهُ يَقْضيهِ بَعْدَ فراغِها إِذا سَلَّمَ مِنْها، (...)، ولا يَصيرُ بِهِ، أَيْ السُّجودُ المَقْضِيُّ، عائِدَ الصَّلاةِ عَلى الصَّحيحِ مِنَ المَذْهَبِ لِحُصولِ التَّحَلُّلِ بِالسَّلامِ".
مصطفى السّيوطيّ، مطالب أولي النّهى. المكتب الإسلامي، ج: 1، ص: 534.
10 - 6
وــــــــــ خُلُقُ فُلانٍ: فسَدَ. (مح)
"وتَخَنّثَ الشُّبّانُ والرِّجالُ ضُروبًا مِنَ التَّخَنُّثِ بِهذا الاخْتِلاط وهذا الابْتِذال، وتَحَلَّلَتْ فيهِمْ طِباعُ الغَيْرَةِ".
الرافعي، وحي القلم. تح: درويش الجويدي، ج: 1، ص: 196.
10 - 7
وــــــــــ فُلانٌ مِنْ يَمينِهِ: خَرَجَ مِنْها بِكَفّارَةٍ أَو حِنْثٍ يوجِبُ الكَفّارَةَ.
ويَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الكَثيبِ تَعَذَّرَتْ***عَلَيَّ، وآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ
الأعلم الشّنتمريّ، شرح ديوان امرئ القيس. ص: 68.
فأَقسَمْتُ بِالرَّحْمنِ لا شَيْءَ غَيْرَهُ***يَمينَ امْرِئٍ بَرٍّ ولا أَتَحَلَّلُلَأَسْتَشْعِرَنْ أَعْلى دَريسَيَّ مُسْلِمًا***لِوَجْهِ الّذي يُحْيي الأَنامَ ويَقْتُلُ
ديوان كعب بن زهير. تح: حنا نصر الحتّي، ص: 62.
"يَقولُ: تَحَلَّلْ مِنْ يَمينِكَ، وغَيْلُ: غَيْلانُ فرُخِّمَ".
المفضل الضبي، أمثال العرب. تح: إحسان عباس، ص: 80.
"ويُقالَ تَحَلَّلَ فُلانٌ مِنْ يَمينِهِ إِذا خَرَجَ مِنْها بِكَفّارَةٍ أَوْ حِنْثٍ يوجِبُ الكَفّارَةَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 300.
"وقَدْ أَقْسَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلى اجْتِنابِ زَوْجاتِهِ، فعاتَبَهُ اللهُ وأَمَرَهُ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ يَمينِهِ".
محمد عزة دروزة، التفسير الحديث. دار الغرب الإسلاميّ، ج: 2، ص: 321.
10 - 8
وــــــــــ في يَميْنِهِ: حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنى مِنْهُ شَيْئًا.
ويومًا عَلى ظَهْرِ الكَثيبِ تَعَذّرَتْ***عَلَيّ وآلَتْ حَلْفَةً لم تَحَلَّلِ
ديوان امرئ القيس وملحقاته. تح: أنور عليان، وآخرين، ص: 191.
وقَوْلي إِذا ما غابَ يَوْمًا بَعيرُهُمْ***يُلاقونَهُ حَتّى يَؤوبَ المُنَخَّلُفيُضْحي قَريبًا غَيْرَ ذاهِبِ غَرْبَةٍ***وأُرْسِلُ أَيْماني ولا أَتَحَلَّلُ
شعر النّمر بن تولب العكليّ. تح: محمّد نبيل طريفي، ص: 99.
"وتَحَلَّلَ في يَمينِهِ، إِذا جَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْها مَخْرَجًا". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، الألفاظ الكتابية. دار الكتب العلميّة، ص: 175.
"ولَمّا وصَلَ المُتّقي إِلى هيتَ لَقِيَه توزونُ فقَبَّلَ الأَرْضَ، ورَأى أَنَّهُ تَحَلَّلَ عَنْ يَمينِهِ بِتِلْكَ الطّاعَةِ".
تاريخ ابن خلدون. تح: خليل شحادة، ج: 4، ص: 299.
10 - 9
وــــــــــ عَنْ فُلانٍ الهَمُّ ونَحْوُهُ: ذَهَبَ وزالَ.
"فلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ حَتّى رَأَيْتُ رَسول اللهَ قَدْ تَحَلَّلَ عَنْهُ بَعْضُ ذلِكَ".
ابن سعد، الطبقات الكبرى. تح: علي محمد عمر، ج: 10، ص: 171.
ولَمْ يَحُلَّكَ مَحْزونٌ بِهِ سَقَمٌ***إلّا تَحَلَّلَ عَنْهُ ذلِكَ الَسَّقَمُ
إبراهيم النّجّار، شعراء عبّاسيّون منسيّون. ج: 6، ص: 131.
10 - 10
وــــــــــ السَّفَرُ بِفُلانٍ: اعْتَلَّ بَعْدَ قُدومِهِ مِنْهُ.
"لمّا انْصَرَفَ النّبيُّ ﷺ إِلى المَدينَةِ بَعْدَ ما قَضى حَجَّةَ التَّمامِ، فتَحَلَّلَ بِهِ السَّيْرُ، وطارَتْ بِهِ الأَخْبارُ لِتَحَلُّلِ السَّيْرِ باِلنَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ اشْتَكى فوَثَبَ الأَسْوَدُ بِاليَمَنِ ومُسَيْلِمَةُ بِاليَمامَةِ".
الطبري، تاريخ الأمم والملوك. دار الكتب العلمية، ج: 2، ص: 204.
"تَحَلَّلَ بِهِ السَّفرُ تَحَلُّلًا، وهُوَ اعْتِلالُ الرَّجُلِ إِذا قَدِمَ فيَأْخُذُه تَكَسُّرٌ، أَوْ يَجِدُ ثِقَلًا مِنَ السَّفَرِ الّذي سارَ، ولا يَكونُ إِلا بَعْدَ قُدومِ الرَّجُلِ بَلْدَةً يُقيمُ بِها". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
أبو زيد الأنصاري، النوادر. تح: عبد القادر أحمد، ص: 517.
10 - 11
وــــــــــ في نَقْلِ الكَلامِ: أَبْرأَ ذِمَّتَهُ منَ احْتِمالِ الخَطَأِ باسْتِدْراكٍ؛ بَأَنْ يَقولَ مَثَلًا في رِوايَةِ الحديث: "أو كما قال ﷺ" ونَحْوَ ذلِكَ.
"وأَتَحَلَّلُ؟".
مسند الدارمي. تح: حسين سليم أسد، ص: 327.
10 - 12
وــــــــــ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ: خَرَجَ مِنْهُ.
"العَفَنُ إِنَّما يَكونُ في البَدَنِ لِامْتِناعِ ما يَتَحَلَّلُ مِنَ البَدَنِ بِسَبَبِ سَدَدٍ، ومِنْ زِيادَةِ حَرارَةٍ، ورُطوبَةٍ عَلى الحالِ الطَّبيعيِّ".
الرازي، الحاوي في الطب. تح: محمد محمد إسماعيل، ص: 2134.
"وهُوَ بارِدٌ رَطْبٌ يَقْمَعُ الحَرارَةَ، ويَحْفَظُ عَلى البَدَنِ رُطوباتِهِ، ويَرُدُّ عَلَيْهِ بَدَلَ ما تَحَلَّلَ مِنْهُ".
ابن قيم الجوزية، الطب النبوي. دار السّلام، ص: 557.
10 - 13
وــــــــــ إِليْهِ: آلَ إِلَيْهِ ورَجَعَ.
"وقَدْ قَدَّمَ: أَنَّ العِلْمَ عامِلٌ في مَوْضِعِ السّاعَةِ، وإِذا عَمِلَ فيهِ، فقَدْ تَحَلَّلَ إِلى مَعْنى الفِعْلِ، وإِذا تَحَلَّلَ إِلى مَعْناهُ، تَمَّ لَهُ مُرادُه الّذي ادَّعاهُ وسُلِّمَ بِزَعْمِهِ".
ابن رشد الجد، فتاوى الإمام ابن رشد. تح: محمد العزازي، ص: 326.
10 - 14
وــــــــــ فُلانٌ فُلانًا: سَألَهُ أنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ أَمْرٍ ما.
«مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مالِهِ، فلْيَتَحَلَّلْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حينَ لا يَكونَ دِينارٌ ولا دِرْهَمٌ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 16، ص: 337.
"فإِنْ تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ ما يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِ المالِ، فعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ المالِ، فإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ فلا بَأْسَ بِهِ، وإِنْ أَبى أَنْ يُحَلِّلَهُ فعَلَيْهِ أَنْ يُكافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ إِنْ كانَ ذلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكافَأَةٌ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 3، ص: 635.
"وهذا الحُكْمُ ثابِتٌ في مَنْ آذى مُسْلِمًا في نَفْسِهِ أَوْ مالِهِ، أَوْ غيرِ ذلِكَ ظالِمًا لَهُ؛ فإِنَّهُ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ لَهُ ويُخْبِرَهُ بِالـمَظْلِمَةِ وقَدْرِها".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 11، ص: 452.
"أمّا التَّحَلُّلُ فهُو مَصْدَرُ تَحَلَّلَ أي: طَلَبَ مِنْ رَبِّ الحَقِّ أنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْهُ".
محمد سالم المَجْلسي، لوامع الدرر. ج: 10، ص: 305.
10 - 15
وــــــــــ الشَّيْءَ: اسْتَباحَهُ.
أَبابْنِ يَزيدٍ وابْنِ زَحْرٍ تُحُلِّلَتْ***دِماءُ تَميمٍ واسْتُبيحَ سَوامُها
شرح ديوان الفرزدق. تح: إيليا الحاوي، ج: 2، ص: 453.
10 - 16
وــــــــــ فُلانًا والأَمْرَ ومِنْهُ: تَخَلَّصَ مِنْهُ وتَرَكَهُ.
أَنا مَنْ تَحَلَّلَهُ الزَّمانُ بِتَرْكِهِ***ولِمُسْتَجيرِكَ بِالأَمانِ تَجَلُّلُعزْبٌ مِنَ النِّعَمِ الجِسامِ مُقَدَّرٌ***بَلْ أَنْ يُقَدَّرَ لي بِهِنَّ تَأَهُّلُ
ديوان ابن الرّوميّ. دار الكتب العلمية، ج: 3، ص: 195.
"وسُئِلَ أَبو عَبْدِ اللهِ بْنُ عَلّاقٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ آخَرَ دَراهِمَ وحَلَفَ، (...)، وهَوَ الآنَ قَدْ شَكَّ هَلْ نَوى بِاليَمينِ أَنْ يَرُدَّ السَّلَفَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، لأَنَّهُ يُريدُ التَّحَلُّلَ مِنْ ذلِكَ الشَّكِّ الّذي دَخَلَهُ".
الونشريسي، المعيار المعرب. تح: محمد حجي، وآخرين، ج: 4، ص: 205.
"ولَمّا ماتَ الفَقيهُ إِسْماعيلُ بْنُ حَسَنٍ النَّهْمِيُّ أَسْنَدَ إِلَيْهِ وصِيَّتَهُ، فاجْتَهَدَ في التَّحَلُّلُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْها".
الشوكاني، البدر الطالع. دار الكتاب الإسلامي، ج: 2، ص: 160.
11. اِسْتَحَلَّ
فعل
11 - 1
* اسْتَحَلَّ فُلانٌ الشَّيْءَ: انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ.
أَضافَتْ إِلَيْهِ طُرْقَةُ اللَّيْلِ ما فتًى***ثُباتًا إِذا ظَلَّ الفَتى وهْوَ أَوْجَلُبَدا بِحَرامِ اللهِ حَتّى اسْتَحَلَّهُ***وكانَ شِفاءً ثَأرُ نَفْسي مُعَجِّلُ
ديوان تأبّط شرًّا وأخباره. تح: علي شاكر، ص: 161.
«سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللهُ وكُلُّ نَبيٍّ كانَ الزّائِدُ في كِتابِ اللهِ، والمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، والمُتَسَلِّطُ بِالجَبَروتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللهُ ويُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ، والمُسْتَحِلُّ لِحُرَمِ اللهِ، والمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتيْ ما حَرَّمَ اللهُ، والتّارِكُ لِسُنَّتي».
سنن الترمذي. تح: بشار عواد، ج: 4، ص: 28.
"فنافَروهُ إِلى كاهِنَةٍ مِنْ كُهّانِ العَرَبِ، فسَجَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَهانَتِها أَنْ لا يَدْخُلَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنينَ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ حُرْمَةِ الكَعْبَةِ".
الماوردي، أعلام النبوة. تح: طه سعد، ص: 179.
"أَيْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرامَ، فاسْتَحَلّوا حُرْمَتَهُ، فاقْتُلوهُمْ، فقَدَ عَلِموا صُنْعَ اللهِ بِمَنِ اسْتَحَلَّ ذلِكَ، وهَتَكَ حُرْمَةَ بَيْتِهِ".
ابن الزبير الثقفي، ملاك التأويل. تح: عبد الغني الفاسي، ج: 1-2، ص: 63.
11 - 2
وــــــــــ الشَّيْءَ: اتَّخَذَهُ، أَوْ عَدَّهُ حَلالًا.
واتَّقوا اللهَ في ضِعافِ اليَتامى***رُبَّما يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الحَلالِ
ديوان صيفي بن الأسلت. تح: حسن باجوده، ص: 86.
«يوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَني وهْوَ مُتَّكِئٌ عَلى أَريكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَديثي، فيَقولُ: بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ كِتابُ اللهِ؛ فما وجَدْنا فيهِ مِنْ حَلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ، وما وجَدْنا فيهِ مِنْ حَرامٍ حَرَّمْناهُ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 28، ص: 429.
وخَلا مَنْزلي فلا شَيْءَ فيهِ***لَسْتُ مِمَّنْ يُخْشى عَلَيْهِ اللُّصوصُواسْتَحَلَّ الأَميرُ حَبْسَ عَطائي***خالِدٌ إِنَّ خالِدًا لَحَريصُ
إبراهيم النّجّار، شعراء عبّاسيّون منسيّون. ج: 4، ص: 311.
"لَوْ أَنَّ شَخْصًا اسْتَحَلَّ الزِّيادَةَ في كِتابِ اللهِ، أَوِ التَّحْريفَ فيهِ، بتَوْحيدِ اللهِ وتَمْجيدِهِ، والثَّناءِ عَلَيْهِ، مُضيفًا ذلِكَ إلى القُرْآنِ، مُعْتَقِدًا نُزولَهُ فيه، كانَ كافِرًا بإِجْماعِ أَهْلِ العَلْمِ".
الرّسعني، رموز الكنوز. تح: دهيش، ج: 3، ص: 588.
"ومَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّمًا فهْوَ كافِرٌ".
سليمان بن عبد الله، أوثق عرى الإيمان. دار القاسم، ص: 20.
11 - 3
وــــــــــ فُلانًا: تَحَلَّلَهُ.
«مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخيهِ مِنْ عِرْضِهِ ومالِهِ، فلْيَسْتَحِلَّهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حينَ لا دينارَ ولا دِرْهَمَ».
صحيح ابن حبان. تح: شعيب الأرناؤوط، ج: 16، ص: 361.
"لَمْ يُعْطِ قَطُّ لَذلِكَ أَرْشًا، ولا اسْتَحَلَّ صاحِبَ الدّارَ، ولا اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ في السِّرِّ، ثُمَّ يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَفْسِهِ في السَّنَةِ إِخْراجَ عَشْرَةِ دَراهِمَ".
الجاحظ، البخلاء. دار الكتب العلمية، ص: 84.
"وكانَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَيّامٍ أَطْلَقَهُ، وفَكَّ قَيْدَهُ، وخَلَعَ عَلَيْهِ، وأَطْلَقَ لَهُ أُلوفَ دَراهِمَ، واسْتَحَلَّهُ فأَحَلَّهُ".
ابن العديم، بغية الطلب. تح: سهيل زكار، ص: 4593.
"ويُقالُ اسْتَحَلَّهُ الشَّيْءَ: سأَلَهُ أَن يُحِلَّهُ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
11 - 4
وــــــــــ الشَّيْءَ: اسْتَباحَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وشُروطِهِ.
«إِنَّ أَحَقُّ الشُرُوطِ أَنْ توفوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُروجَ».
مسند أحمد. تح: شعيب الأرناؤوط وآخرين، ج: 28، ص: 592.
يَنْتابُنا جِبْريلُ في أَبْياتِنا***بِفَرائِضِ الإِسْلامِ والأَحْكامِيَتْلو عَلَيْنا النّورَ فيها مُحْكَمًا***قِسْمًا لَعَمْرُكَ لَيْسَ كالأَقْسامِفنَكونُ أَوَّلَ مُسْتَحِلِّ حَلالِهِ***ومُحَرِّمٍ لِلَّهِ كُلَّ حَرامِ
ديوان حسّان بن ثابت. تح: عبد أ. مهنّا، ص: 230.
"قَدْ يُسَبُّ الرَّجُلُ أَوْ يُرْمى بِشَيْءٍ نُسِبَ إِلَيْهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ ما نُسِبَ؛ لِقَوْلِ أُسَيْدِ: (كَذَبْتَ لَعَمْرِو اللِه؛ فإِنَّكَ مُنافِقٌ تُجادِلُ عَنِ المُنافِقينَ) ولَمْ يَكُنْ سَعْدٌ مُنافِقًا، لَكِنَّ مُجادَلَتَهُ عَنْهُ اسْتَحَلَّ مِنْهُ أُسَيْدٌ أَنْ يَرْمِيَهُ بِالنِّفاقِ".
ابن بطّال، شرح صحيح البخاريّ. تح: ياسر بن إبراهيم، ج: 8، ص: 41.
11 - 5
وــــــــــ العُقوْبَةَ ونَحْوَها: تَسَبَّبَ في حُلولِها ووُقوعِها بِفِعْلِهِ لما لا يَنْبَغي.
"يا أَميرَ المُؤْمِنينَ، لَقَدْ بُؤْتُ إِذًا بِالنَّدَمِ، وتَعَرَّضْتُ لاسْتِحْلالِ النِّقَمِ".
الطبري، تاريخ الأمم والملوك. دار الكتب العلمية، ج: 4، ص: 666.
12. احْتِلال
اسم
12 - 1
* الاحْتِلالُ: احْتِلالُ دَوْلَةٍ لِدَوْلَةٍ أُخْرى أَو جُزْءٍ مِنْها بِالقُوَّةِ. (مح)
"وكانَ مِصْرِيًّا يَكْرَهُ الاحْتِلالَ الإِنْجليزيّ، ووَفْدِيًّا يُحازِبُ سَعْد زَغْلول، وشَرْقِيًّا يَمْقُتُ المَدَنِيَّةَ الغَرْبِيَّةَ، ومُسْلِمًا يَتَعَصَّبُ لِدينِهِ، ويُدافِعُ بِحَماسَةٍ عَنِ الإِسْلامِ والمُسْلِمينَ".
بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث. دار نظير عبود، ص: 377.
13. احْتِلالِيَّة
اسم
13 - 1
* الاحْتِلالِيَّةُ: كَوْنُ قائدٍ أَوْ تَنْظيمٍ ذا طُموحٍ لِاحْتِلالِ بلادِ غَيْرِهِ واغْتِصابِها. (مح)
"الكِيانُ الصُّهْيونِيُّ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعيشَ في سَلامٍ أو في حالَةٍ طَبيعِيَّةٍ إلّا إِذا تَخَلّى عَنْ احْتِلالِيَّتِهِ واسْتيطانِيَّتِهِ، لَكِنَّهُ لَوْ فعَلَ ذلِكَ لَتَخَلّى عَنْ جَوْهَرِهِ ووَظيفَتِهِ".
المؤتمر العام العشرون للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اتحاد الكتاب العرب، 1998م، ص: 302.
14. إِحْلالِيَّة
اسم
14 - 1
* الإِحْلالِيَّةُ: نَهجُ التَّخَلُّصِ مِنَ السُّكانِ الأَصْلِيّينَ، بِالطَّرْدِ أو الإِبادَةِ، حَتَّى يُفْرِغَ المُسْتَعْمِرُ الأَرْضَ مِنْهُمْ ويَحُلَّ هُوَ مَحَلَّهُمْ.
"لا بُدَّ وأَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ إحْلالِيَّةَ الاسْتِعْمارِ الصُّهْيونِيِّ هِيَ نَتيجَةٌ حَتْمِيَّةٌ «لِصُهْيونِيَّتِهِ»، بِلْ إِنَّنا يُمْكِنُ أَنْ نَعْتَبِرَ أَنَّ الإِحْلالِيَّةَ والصُّهْيونِيَّةَ هُما مُترادِفانِ يُعَبِّرانِ عَنِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ".
عبد الوهاب المسيري وآخرون، المشروع الصهيوني في الفكر والتطبيق، دار المستقبل العربي، 1983م، ص: 30.
14 - 2
وــــــــــ (في الاقْتِصادِ): تَوَجُّهُ المُسْتَهْلِكِ إِلى اسْتِبْدالِ سِلْعَةٍ بِغَيْرِها.
"عَلى المُسْتَهْلِكِ أَنْ يَخْتارَ إحْدى السِّلْعَتَيْنِ ويُضَحِّيَ بِالأُخْرى (...) مَعَ مُلاحَظَةِ أَنَّ هذا لَيْسَ مٌمْكِنًا إِلّا إِذا افْتَرَضْنا الإحْلالِيَّةَ بَيْنَ تِلْكَ السِّلَعِ، أَيْ بِمَعْنى أَنَّهُ لا فرْقَ عِنْدَ المُسْتَهْلِكِ مِنَ اسْتِخْدامِ إحْدى السِّلْعَتَيْنِ".
أحمد فراس العوران، اقتصاد الأمن الاجتماعي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2014م، ص: 137.
14 - 3
وــــــــــ: (في اللِّسانيّاتِ) اسْتِبْدالُ لُغَةٍ أُخْرى بِاللُّغَةِ الأولى عِنْدَ الأَطْفالِ.
"يَعْني مُصْطَلَحُ الثُّنائِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ البَديلَةِ، أَوِ الإِحْلالِيَّةِ اسْتِبْدالَ لُغَةٍ أُخْرى بِاللُّغَةِ الأولى عِنْدَ الأَطْفالِ".
مبارك تريكي، فصول في اللسانيات الاجتماعية، مركز الكتاب الأكاديمي، 2019م، ص: 51.
15. إِحْليل
اسم
15 - 1
* الإِحْليلُ: مَخْرَجُ البَوْلِ. (ج) أَحاليلُ.
"حبَّةُ بُرٍّ في إِحْليلِ مُهْرٍ".
ابن عبد ربه، العقد الفريد. تح: عبد المجيد الترحيني، ج: 7، ص: 93.
«لا، إِنَّما ذلِكَ مِنَ الشَّيْطانِ، يَدْخُلُ في إِحْليلِ أَحَدِكُمْ حَتّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الرّيحُ، فإِذا وجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فلا يَقْطَعْ صَلاتَهُ حَتّى يَجِدَ بَلَلًا، أَوْ ريحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا».
مصنف عبد الرزاق. تح: مركز البحوث، ج: 1، ص: 305.
"إِذا جامَعَ الرَّجُلُ ولَمْ يُسَمِّ، انْطَوى الجّانُّ عَلى إِحْليلِهِ فجامَعَ مَعَهُ".
تفسير مجاهد. تح: محمد أبو النيل، ص: 144.
"أَرَأَيْتَ مَنْ قَطَّرَ في إحْليلِهِ دُهْنًا وهُو صائِمٌ، أَيَكونُ عَلَيْهِ القَضاءُ في قَوْلِ مالِكٍ؟".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 270.
"أَدْرَكَهُ في آخِرَ أيّامِهِ مَرَضُ القُروحِ في إِحْليلِهِ".
ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء. تح: نزار رضا، ص: 488.
"لَوْ خَرَجَتِ القُطْنَةُ مِنَ الإِحْليلِ رَطْبَةً انْتَقَضَ لِخُروجِ النَّجاسَةِ".
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار. تح: عادل عبد الموجود وآخر، ج: 1، ص: 281.
15 - 2
وــــــــــ: مَخْرَجُ اللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ والضَّرْعِ.
تَمُرُّ مِثْلَ عَسيبِ النَّخْلِ ذا خُصَلٍ***في غارِزٍ لَمْ تَخَوَّنْهُ الأَحاليلُ
ابن هشام، السيرة النبوية. تح: عمر تدمري، ج: 4، ص: 149.
"والفَشوشُ: النّاقَةُ الواسِعَةُ الإِحْليلِ".
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 6، ص: 222.
"السِّدادُ: بُلْغَةٌ مِنَ العَيْشِ، وما يَبِسَ فِي إحْليلِ النّاقَةِ مِنْ لَبَنٍ".
ابن مالك، إكمال الإعلام. تح: سعد الغامدي، ج: 2، ص: 297.
"والإحليلُ مَجْرى البَوْلِ مِنْ ذَكَرِ الإِنْسانِ، ومَخْرَجُ اللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
15 - 3
وــــــــــ قَناةٌ يَبْلُغُ طولُها عِنْدَ الرَّجُلِ حَوالَي 20 سم، ولا يتَجاوَزُ 4 سم عِنْدَ المَرْأَةِ، وهُوَ يَمْتَدُّ بَيْنَ عُنُقِ المَثانَةِ والفَتْحَةِ الخارِجيَّةِ للإِحْليلِ.
"هُوَ مُؤَلَّفٌ مِنَ الجِلْدِ العامِّ، ومِنَ الجِسْمَينِ المُنْخَرِبَيْنِ، ومِنَ الإِحليلِ وجِسْمَيْهِ الإِسْفِنْجِيَّيْنِ (...) الإحْليلُ أَيْ مَجْرى البَوْلِ هُوَ مَجْرًى غِشائِيٌّ يَمُرُّ مِنَ المَثانَةِ، يَجْتازُ بِداخِلِ الغُدَّةِ القُدّامِيَّةِ والجِسْمِ الإِسْفِنْجِيِّ، فعِنْدَ مُنْتَهى الحَشَفَةِ يَنْبَسِطُ غِشاؤُهُ المُبَطَّنَ فوْقَ الحَشَفَةِ فيَحْدُثُ مِنْهُ الثُّقْبَةُ لِمَجْرى البَوْلِ".
هوبر، كتاب أنيس المشرحين، تر: جان تيتلر، مطبعة ايدوكيشن، ص: 248.
15 - 4
o والإِحْليلَ التَّحْتِيُّ (التَّحْتانِيُّ) أَوِ السُّفْلِيُّ: عَيْبٌ خِلْقِيٌّ يُوْلَدُ بِهِ الجَنينُ الذَّكَرُ، تَكونُ فيهِ فتْحَةُ خُروجِ البَولِ في غَيرِ مَوْضِعِها الطَّبيعِيٍّ؛ عَلى الجانِبِ السُّفْلِيِّ مِنَ القَضيبِ.
"انْفِتاحُ مَجْرى البَوْلِ تَحْتَ القَضيبِ- إحْليلٌ تَحْتانِيٌّ".
محمد شرف، معجم العلوم الطبية والطبيعية، ص: 383.
15 - 5
o والإِحْليلَ الفَوْقانِيُّ أَوِ العُلْوِيُّ: عَيْبٌ خِلْقِيٌّ يُوْلَدُ بِهِ الجَنينُ الذَّكَرُ، تَكونُ فيهِ فتْحَةُ خُروجِ البَولِ في غَيرِ مَوْضِعِها الطَّبيعِيٍّ؛ عَلى الجانِبِ العُلْوِيِّ مِنَ القَضيبِ. (مو)
"كانَ يُعالِجُ بِنَجاحٍ الإِحْليلَ الفَوْقانِيَّ والتَّحْتانِيَّ، وقَدْ ذَكَرَ في كِتابِهِ أنَّ هاتَيْنِ الحالَتَيْنِ مانِعَتانِ لِلإِخْصابِ".
شوكت أحمد الشطي، تاريخ الطب، مطبعة جامعة دمشق، ص: 135.
16. تَحِلَّة
اسم
16 - 1
o وتَحِلَّةُ القَسَمِ: القَليلُ اليَسيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، عَلى وجْهِ التَّشْبِيهِ بِقَدْرِ ما يَبِرُّ بِهِ الحالِفُ؛ وهُو أَدْنى ما يَقَعُ عَلَيْهِ القَسَمُ.
أَرى إِبِلي عافَتْ جَدودَ فلَمْ تَذُقْ***بِها قَطْرَةً إِلّا تَحِلَّةَ مُقْسِمِ
ديوان طفيل الغنويّ. تح: حسّان أوغلي، ج: 1، ص: 105.
«لا يَموتُ لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فتَمَسَّهُ النّارُ، إلّا تَحِلَّةَ القَسَمِ».
مالك بن أنس، الموطأ. تح: محمد مصطفى الأعظمي، ج: 2، ص: 330.
"وأَضْمَرَ في كَلامِهِ مَعْنًى صَحيحًا، وهْوَ أَنَّهُ أَرادَ الدُّخولَ الّذي هُو تَحِلَّةُ القَسَمِ".
محمد بن الحسن، كتاب الكسب. تح: عبد الفتاح أبو غدة، ج: 1، ص: 169.
"وغَرَّهُمْ في دينِهِمْ ما كانوا يَفْتَرونَ مِنْ أَنَّ النّارَ لَنْ تَمَسَّهُمْ إِلّا أَيّامًا قَلائِلَ، أَوْ أَنَّ آباءَهُمُ الأَنْبياءَ يَشْفَعونَ لَهُمْ، أَوْ أَنَّهُ تَعالى وعَدَ يَعْقوبَ عَلَيْهِ السَّلامَ أَنْ لا يُعَذِّبَ أَوْلادَهُ إِلّا تَحِلَّةَ القَسَمِ".
البيضاويّ، أنوار التنزيل. دار إحياء التراث العربي، ج: 2، ص: 11.
"وجَعَلَ ابْنُ هِشامٍ تَحِلَّةَ القَسَمِ كِنايَةً عَنِ القِلَّةِ".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: فادي المغربي، ج: 16، ص: 151.
17. انْحِلالِيَة
اسم
17 - 1
* الانْحِلاليَّةُ (في الكيمياءِ): قابِليَّةُ مادَّةٍ مّا لِلذَّوَبانِ في مُذيبٍ لِتَكوينِ مَحْلولٍ مُتَجانِسٍ.
"الذَّوَبانيَّةُ؛ الذّائِبيَّةُ الانْحِلاليَّةُ: قابِليَّةُ الذَّوَبانِ أَوِ الانْحِلالِ" ".
منير البعلبكي، المورد، دار العلم للملايين، 1967م، ص: 877.
18. تَحَلُّل
اسم
18 - 1
o التَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ أَوِ الثّاني: إتْيانُ الحاجِّ ثَلاثَةِ مَناسِكَ، هِيَ: رَمْيُ الجِمارِ، وطَوافُ الإِفاضَةِ، والحَلْقُ أَوِ التَّقْصيرُ، وبِهِ تَحِلُّ مَحْظوراتِ الإحْرامِ كافَّةً.
"ولِلحَجِّ تَحَلُّلانِ: تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ، وهُوَ رَمْيُ جَمْرَة ِالعَقَبَةِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، (...)، والتَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ هُوَ طَوافُ الإِفاضَةِ يُباحُ مَعَهُ الصَّيْدُ والنِّساءُ وجَميعُ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ".
القاضي عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي. تح: محمد بو خبزة، وآخر، ج: 1، ص: 88.
"والتَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ: طَوافُ الإِفاضَةِ، وهُوَ الّذيْ يُحِلُّ النِّساءَ وجَميعَ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ" ".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 3، ص: 354.
"فإِذا طافَ لِلإِفاضَةِ فإِنَّهُ يَحِلُّ له بِطَوافِها مُقارَبَةُ النِّساءِ بِأَنْواعِ الاسْتِمْتاعِ وطْأً أَوْ غَيْرَهُ، ويَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ في غَيْرِ الحَرَمِ، ولا يُكْرَهُ لَهُ اسْتِعْمالُ الطّيبِ، وهذا هُوَ التَّحَلُّلُ الثّاني الَّذي هُوَ التَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ".
محمد سالم المجلسي، لوامع الدرر. ج: 4، ص: 556.
18 - 2
o والتَّحَلُّلُ الأَصْغَرُ أَوِ الأَوَّلُ: فِعْلُ الحاجِّ اثْنَينِ مِنْ ثلاثَةِ مَناسِكَ: رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، والحَلْقُ أَوِ التَّقْصيرُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ، وبه تَحِلُّ مَحْظوراتُ الإحْرامِ عَدا النِّساءِ والصّيْدِ.
"ولِلحَجِّ تَحَلُّلانِ: تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ، وهُوَ رَمْيُ جَمْرَة ِالعَقَبَةِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، وهذا التَّحَلُّلُ يُبيحُ لُبْسَ المَخيطِ، وإِماطَةَ الأَذى وغَيرَ ذلِكَ ما عَدا قَتْلَ الصَّيْدِ والنِّساءَ، (...)، والتَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ".
القاضي عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي. تح: محمد بو خبزة، وآخر، ج: 1، ص: 88.
"وإذا قُلنا: الحَلْقُ نُسُكٌ، ففَعَلَ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّمْيِ والحَلْقِ والطَّوافِ حَصَلَ التَّحَللُّ الأَوَّلُ، وحَلَّ بِهِ اللُّبْسُ والحَلْقُ والقَلْمُ، وكَذا الصَّيْدُ وعَقْدُ النِّكاحِ في الأَظْهَرِ".
النووي، منهاج الطالبين. تح: محمد طاهر شعبان، ج: 1، ص: 203.
"يَحِلُّ بِطَوافِ الإِفاضَةِ ما بَقِيَ مِنَ المُحَرَّماتِ بِالإِحْرامِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَصْغَرِ، الّذي هُوَ رَمْيُ جَمْرَة العَقَبَةِ، وهُوَ النِّساءُ والصَّيْدُ والطّيبُ".
محمد سالم المجلسي، لوامع الدرر. ج: 4، ص: 556.
19. تَحْلِيل
اسم
19 - 1
* التَّحْليلُ: الأَمْرُ اليَسيرُ مِثْلُ تَحِلَّةِ القَسَمِ.
أَلا أَبْلغْ بَني فهْمِ بْنِ عَمْرٍو***عَلى طُولِ التَّنائِي والمقالَهْ
مَقالَ الكاهِنِ الحامِيِّ لَمّا***رَأَى أَثَري وقَدْ أَنْهَبْتُ مالَهْ
رأى قَدَمَيَّ وقْعُهُما حَثيثٌ***كَتَحْليلِ الظَّليمِ دَعا رِئالَهْ
ديوان تأبّط شرًّا وأخباره. تح: علي شاكر، ص: 98.
تَخْذي عَلى يَسَراتٍ وهْيَ لاحِقَةٌ***ذَوابِلٌ وقْعُهُنَّ الأَرْضَ تَحْليلُ
ديوان كعب بن زهير. تح: حنا نصر الحتّي، ص: 33.
"وضَرَبْتُهُ ضَرْبًا تَحْليلًا، يَعْني شِبْهَ التَّعْزيزِ غَيْرَ مُبالَغٍ فيهِ، اشْتُقَّ مِنْ تَحْليلِ اليَمينِ، ثُمَّ أُجْرِيَ في سائرِ الكَلامِ حَتّى يُقالُ في وصْفِ الإبِلِ إِذا بَرَكَتْ: نَجائِبٌ وقْعُها في الأَرْضِ تَحْليلُ؛ أَيْ: هَيِّنٌ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 350.
أَلَمَّتْ بِنَشْوانَي كَرًى صَرَعَتْهُما***بإِحْدى الفَيافي غَرْبَةٌ وفُتورُ
بَعيدَيْنِ مِنْ مَهْواهُما أَدْرَكَتْهُما***وَفاةٌ لَها تَحْليلَةٌ فَنشورُ
شعر أبي حية النميري. تح: يحيى الجبّوري، ص: 35.
19 - 2
وــــــــــ (في اصْطِلاحِ الفُقَهاءِ): حُكْمُ اللَّهِ تَعالى بِأَنَّ فِعْلًا ما هُوَ حَلالٌ.
"نَعَمْ هاتانِ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ التَّحْليلُ في أَيَّتِهِما شاءَ، فإِذا وَطِئَ واحِدَةً أَمْسَكَ عَنْ الأُخْرى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الَّتي كانَ وَطِئَ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 2، ص: 200.
19 - 3
وــــــــــ: الإِحْليلُ.
"التَّحْليلِ: الإِحْلِيلُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في عَصْرِ الدُّوَلِ والإماراتِ)
الصّغاني، الشوارد. تح: مصطفى حجازي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ص: 39.
19 - 4
o والتَّحليلُ بِالعَکْسِ (في عِلمَ المَنْطِقِ): عَمَلِيَّةُ عَكْسِ المُقَدِّماتِ المَنْطِقِيَّةِ لِبَيانِ كَيْفيَّةِ تَرْكيبِ القَضايا بَحَيْثِ يَحْصُلُ العِلْمُ بِالمَجْهولِ.
"أَمّا عَلى جِهَةِ التَّحْليلِ بِالعَكْسِ، فهذِهِ الأَشْياءُ يَتَبَيَّنُ بِإِيْجازٍ مِنَ القَوْلِ إِنَّهُ لا إِلى فوْقٍ ولا إِلى أَسْفَلَ يُمْكِنُ أَنْ تَكونَ المَحْمولَةُ بِلا نِهايَةٍ في العُلومِ البُرْهانِيَّةِ الَّتيْ عَلَيْها هَذا البَحْثُ، وذلِكَ أَنَّ البُرْهانَ إِنَّما هُوَ جَميعُ الأَشْياءِ المَوْجودَةِ بِذاتِها لِلأُمورِ".
منطق أرسطو (بترجمة إسحق بن حنين). تح: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، 1980م، ص: 399.
"والقِسْمُ الثّالِثُ يَتَبَيَّنُ فيهِ تَرْكيبُ القَضايا حَتّى يَتَأَلَّفَ مِنْها دَلیلٌ عَلى المَجهولِ، وهُو القياسُ، ويَشْتَمِلُ عَليهِ أنولوطيقا ومعناه التَّحليلُ بِالعَکْسِ".
ابن سبعين، الكلام على المسائل الصقلية. تح: محمد شرف الدين، ص: 31.
"يَعْني أَنَّ الحُدودَ الّتي فيها يَكونُ التَّحْليَل بِالعَكْسِ -وهِيَ الحُدودُ المَأْخوذَةُ في حَدِّ الشَّيْءِ- فإِنَّ التَّحْليلَ بِالعَكْسِ يَكونُ، وهذِه هِيَ أَجْزاءُ حَدِّ الشَّيْءِ".
منطق أرسطو. تح: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، 1980م، ص: 399.
19 - 5
وــــــــــ (في عِلْمِ الحِسابِ): العَمَلُ بِعَكْسِ ما أَعْطاهُ السّائِلُ، فإِنْ ضَعَّفَ فنَصِّفْ أَوْ زادَ فانْقُصْ أوْ ضَرَبَ فاقْسِم.
"التَّحْليلُ ويُسَمّى العَمَلَ بِالعَكْسِ: هوَ عِبارَةٌ عَنِ العَمَلِ بِعَكْسِ ما أْعْطاهُ السّائِلُ، فإِنْ ضَعَّفَ فنَصِّفْ أَوْ زادَ فانْقُصْ أوْ ضَرَبَ فاقْسِم".
بطرس البستاني، كشف الحجاب في علم الحساب، مطبعة الأميركان، بيروت، 1887م، ص: 244.
19 - 6
وــــــــــ (في العُلومِ الأَساسِيَّةِ والتَّطْبيقِيَّةِ): فحْصُ بَياناتٍ تتعلَقُ بِشَيْءٍ ما؛ لِلحُصولِ عَلى مَعْلوماتٍ أعْمَق بِشَأَنِهِ، ومُحاوَلَةِ فهْمِهِ.
"حَمَلَهُ كُلٌّ عَلى ما يَشْتَهي، واتَّخَذَ الجَهْلَ مُرْشِدًا إِلى العِلْمِ، ولَمْ يَسْتَشِرْ العِلْمَ نَفْسَهُ في القَصْدِ إِلى العِلْمِ؛ فأَنْفَقَ الكَثيرُ عُمْرَهُ في التَّحْصيلِ والترَّكيبِ والتَّحْليلِ والتَّفْسيرِ والتَّأْويلِ والتَّعْديلِ والتَّحْويلِ" .
محمد عبده، الأعمال الكاملة. تح: محمد عمارة، ج: 2، ص: 442.
20. تَحَلُّلِيَّة
اسم
20 - 1
* التَّحَلُّلِيَّةُ: كَوْنُ مادَّةٍ قابِلَةً لِلتَّحَلُّلِ.
"نَفْرِضُ أَنَّ فوْقَ كُلوراتِ الزِّئْبَقوزِ تَتَأَيَّنُ كامِلًا، والتَّحَلُّلِيَّةُ سَتَتَأَثَّرُ بِالوَقْفِ بِواسِطَةِ الزِّيادَةِ بِوُجودِ بيركُلوراتِ الحِمْضِ".
عبد العليم أبو المجد، التقدير الكمي للعناصر بالإديتا، 2010م، ص: 220.
20 - 2
وــــــــــ: الاضْطِراباتُ الانْفِصامِيَّةُ؛ وهِيَ اضْطِراباتٌ عَقْلِيَّةٌ تَنْطَوي عَلى الشَّعورِ بالانْفِصالِ، وعَدَمِ الاسْتِمْرارِيَّةِ بَيْنَ الأَفْكارِ والذِّكْرياتِ والأَشْياءِ المُحيطَةِ والأَفْعالِ والهُوِيَّةِ.
"يَبْدو أَنّ عُلَماءَ النَّفْسِ العَرَبَ (...) مُحْتاجونَ حالِيًّا لِنِقاشٍ سَيْكولوجِيٍّ لِتَمْييزِ مُتَغيِّراتِ الحَداثَةِ والحَضارِيَّةِ والفَرْدانِيَّةِ والتَّحَلُّلِيَّةِ والتَجْزيئِيَّةِ، مِنَ التَّقْليدِيَّةِ والرّيفيَّةِ والجَمْعَوِيَّةِ والتَّحَكُّمِيَّةِ والكُلِّيَّةِ".
عمر هارون الخليفة، علم النفس والمخابرات، ديبونو للطباعة والنشر، 2010م، ص: 350.
21. حالّ
اسم
21 - 1
o والحالُّ المُرْتَحِلُ: المُواصِلُ لِتِلاوَةِ القُرْآنِ يَخْتِمُهُ ثُمَّ يَفْتَتِحُهُ مِنْ أَوَّلِهِ.
«الحالُّ المُرْتَحِلُ (...) الّذي يَضْرِبُ مِنْ أوَّلِ القُرْآنِ إلى آخِرِهِ كُلَّما حَلَّ ارْتَحَلَ».
سنن الترمذي. تح: بشّار عوّاد، ج: 5، ص: 63.
22. حالِّيَّة
اسم
22 - 1
* الحالِّيَّةُ (في البَلاغَةِ): إِحْدى عَلاقاتِ المَجازِ المُرْسَلِ، يُذْكَرُ فيها الحالُّ ويُرادُ المَحَلُّ.
"قَدْ يُصْرَفُ اللَّفْظُ عَنْ حَقيقَتِهِ إِلى مَجازِهِ لِقَرينَةٍ، كَما لَوْ قالَ: رَهَنْتُ الخَريطَةَ، ولَمْ يَتَعَرَّضْ لِما فيها، وكانَتِ الخَريطَةُ لا يُقْصَدُ رَهْنُها في مِثْلِ هذا الدَّيِنِ، فهَلْ يَجْعَلُ رَهْنًا لِما في الخَريطَةِ -وإِنْ كانَ مَجازًا- للِقَرينَةِ الحالِّيَّةِ؟".
العلائي، المجموع المُذْهَب. تح: محمد بن عبد الغفار، ص: 488.
"يَسْتَعْمِلُ المُحْدَثونَ القَهْوَةَ في المَكانِ الّذي تُشْرَبُ فيهِ، وهُوَ مَجازٌ مُرْسَلٌ عَلاقَتُهُ الحالِّيَّةُ، كقَوْلِهِمْ: نَزَلْنا على ماءِ بَني فُلانٍ، أَيْ على بِئْرِهِمْ، والمُؤْمِنونَ في رَحْمَةِ اللهِ أَيْ في جَنَّتِهِ، وهذا الاسْتِعْمالُ صَحيحٌ يُغْنينا عَنْ كَلِمَةِ المَقْهى الثقيلة".
مجلة الرّسالة، العدد: 932، 1951، مج: 19، ص: 562.
23. حَلال
اسم
23 - 1
* الحَلالُ: ضِدُّ الحَرامِ؛ أَيْ ما أَباحَهُ اللهُ.
"لَوْ كانَ لي مالٌ يَحْمِلُ ذلِكَ لَكُفيتُموهُ، أَلا وإِنّي مُخْرِجٌ مِنْ طيبِ مالي وحَلالِهِ ما لَمْ تُقَطَعْ فيهِ رَحِمٌ، ولَمْ يُؤْخَذْ بِظُلْمٍ، ولَمْ يَدْخُلْ فيهِ حَرامٌ؛ فواضِعُهُ".
الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش وأخبارها. تح: عباس الجراخ، ج: 2، ص: 198.
واتَّقوا اللهَ في ضِعافِ اليَتامى***رُبَّما يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الحَلالِ
ديوان صيفي بن الأسلت. تح: حسن باجوده، ص: 86.
﴿يٰأَيُّها ٱلنّاسُ كُلواْ مِمّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا ولاَ تَتَّبِعواْ خُطْواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبينٌ﴾. (البقرة: 168)
«حَلالٌ بيِّنٌ وحَرامٌ بَيِّنٌ، وشُبُهاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فمَنْ تَرَكَ الشُّبُهاتِ كانَ لِلحَرامِ أَتْرَكُ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 30، ص: 289.
"يَنْبَغي أَنْ يُجَرَّبَ النّاسُ في عَشْرَةِ أَشْياءَ: الجَريءُ في القِتالِ، والحَرّاثُ في العَمَلِ (...) والفَقيرُ بِاجْتِنابِ الإِثْمِ وطَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الحَلالِ".
ابن المقفع، كليلة ودمنة. تح: عبد الوهاب عزّام، ص: 256.
"وهُوَ شَيْخٌ صالِحٌ (...) مُتَقَنِّعٌ بِالحَلالِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ".
ابن العديم، بغية الطلب. تح: سهيل زكار، ص: 788.
"وأَيْنَ بِنْتُ الحَرامِ مِنْ بِنْتِ الحَلالِ؟".
البربير، المفاخرات والمناظرات. تح: الطيان، ص: 43.
23 - 2
وــــــــــ: غَيْرُ المُحْرِمِ ولا المُتَلَبِّسِ بِأَسْبابِ الحَجِّ.
«حِلُّ ما يَحِلُّ لِلحَلالِ مِنَ النِّساءِ والطّيبِ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 23، ص: 203.
"والحِلُّ: الرَّجُلُ الحَلالُ الّذي خَرَجَ مِنْ إِصْراحِهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 350.
"ولا يَحْلِقُ المُحْرِمُ رَأْسَ الحَلالِ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 440.
"واتَّفَقَ العُلَماءُ عَلى جَوازِ قَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ للمُحْرِمِ والحَلالِ في الحِلِّ والحَرَمِ".
النووي، صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة، ج: 8، ص: 163.
"إلّا أَنْ يَكونَ الصَّيْدُ في الحَرَمِ فيَشْتَرِكانِ، أَيْ الحَلالُ والمُحْرِمُ في الجَزاءِ كالحَرِمَيْن؛ لِتَحْريمِ صَيْدِ الحُرُمِ عَلى الحَلالِ والمُحْرِمِ".
مصطفى السّيوطيّ، مطالب أولي النّهى. المكتب الإسلامي، ج: 2، ص: 336.
23 - 3
o والشَّهْرُ الحَلالُ: الّذي يُباحُ فيهِ القِتالُ مِنْ سِوى الأَشْهُرِ الحُرُمِ.
مَنَتْ لَكَ أَنْ تُلاقيَني المَنايا***أُحادَ أُحادَ في الشَّهْرِ الحَلالِ
وما لَبْثُ القِتالِ إِذا التَقَيْنا***سِوى لَفْتِ اليَمينِ عَلى الشِّمالِ
السكري، شرح أشعار الهذليين. تح: فراج، ص: 570.
"مَنْ قَتَلَ في شَهْرٍ حَلالٍ أَو جَرَحَ لَمْ يُقْتَلْ في شَهْرٍ حَرامٍ، حَتّى يَجيءَ شَهْرٌ حَلالٌ".
مصنف عبد الرزاق. تح: مركز البحوث، ج: 7، ص: 520.
"ودِيَةُ المُحْرِمِ المَقتولِ في الحَرَمِ في شَهْرٍ حَلالٍ دِيَةٌ وثُلُثا دِيَةٍ".
محمد الهاشمي، الإرشاد الى سبيل الرشاد. تح: عبد الله التركي، ص: 447.
"مَنْ أَطاعَ اللهَ في الشَّهْرِ الحَرامِ في البَلَدِ الحَرامِ لَيْسَ ثَوابُهُ ثَوابَ مَنْ أَطاعَهُ في الشَّهْرِ الحَلالِ في البَلَدِ الحَرامِ".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 10، ص: 199.
"وذلِكَ أَنَّ العَرَبَ كانَتْ إِذا انْصَرَفَتْ مِنَ المَوْسِمِ فأَرادَتْ حَرْبًا أَوْ غَزْوًا أَتَمَّتِ النَّسيئَةَ، فأَحَلَّتْ لَها شَهْرًا مِنَ الأَشْهُرِ الحُرُمِ، وجَعَلَتْ مَحَلَّهُ شَهْرًا مِنَ أَشْهُر الحِلِّ، لِيُكْمِلوا بِذلِكَ الشَّهْرَ الحَلالَ الّذي حَرَّموهُ".
سيدي المختار الكنتي، فتح الودود. تح: مأمون محمد أحمد، ص: 120.
23 - 4
o والحُلْوُ الحَلالُ مِنَ النّاسِ: الطَّيِّبُ الَّذي لا رِيبَةَ فيهِ.
أَلا هَلَكَ الحُلْوُ الحَلالُ الحُلاحِلُ***ومَنْ عِقْدُهُ حَزْمٌ وعَزْمٌ ونائِلُ
شعراء النصرانية قبل الإسلام. تح: لويس شيخو، ص: 743.
إِذا كانَ أَوْلادُ الرِّجالِ حَزازَةً***فأَنْتَ الحَلالُ الحُلْوُ والبارِدُ العَذْبُ
المستدرك في شعر بني عامر. تح: عبد الرحمن الوصيفي، ص: 299.
"والحُلْوُ الحَلالُ: الرَّجُلُ الّذي لا ريبَةَ فيهِ، عَلى المَثَل، لأَنَّ ذلِكَ يُسْتَحْلى مِنْهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 4، ص: 4.
23 - 5
o والسِّحْرُ الحَلالُ: الكَلامُ البَليغُ المُؤَثِّرُ.
"هذا واللهِ السِّحْرُ الحَلالُ".
رسائل الجاحظ، الرسائل الأدبية. تح: علي أبو ملحم، ص: 484.
فأَيْنَ قَصائِدٌ لي فيكَ تَأْبى****وتَأْنَفُ أَنْ أُهانَ وأَنْ أُذالا
هِيَ السِّحْرُ الحَلالُ لمُجْتَليهِ***ولَمْ أَرَ قَبْلَها سِحْرًا حَلالا
الأعلم الشّنتمريّ، شرح ديوان أبي تمّام. تح: إبراهيم نادن، ج: 1، ص: 214.
"وعَلى الحَقيقَةِ هذا الشِّعْرُ هو السِّحْرُ الحَلالُ كَما يُقالُ".
ابن خَلِّكان، وفيات الأعيان. تح: إحسان عباس، ج: 4، ص: 53.
"فقالَ هذِهِ الأَبْياتَ الّتي هِيَ السِّحْرُ الحَلالُ، وقَدْ غابَ عَنّي أَوَّلُها".
الشوكاني، البدر الطالع. دار الكتاب الإسلامي، ج: 1، ص: 321.
23 - 6
o والحُلْوُ الحَلالُ مِنَ الكَلامِ: اللَّيِنُ الَّذي لَيْسَ فيهِ ما يُكْرَهُ.
تَصَيَّدُ بِالحُلْوِ الحَلالِ ولا تُرى***عَلى مَكْرَهٍ يَبْدو بِها فيَعيبُ
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 4، ص: 136.
24. حِلال
اسم
24 - 1
* الحِلالُ: القَوْمُ المُقيمونَ المُتَجاوِرونَ. (ج) أَحِلَّةٌ.
اللَّهُمَّ إنَّ المَرْءَ يَمْـ***ـنَعُ رَحْلَهُ فامْنَعْ حِلالَكْ
لا يَغْلِبَنَّ صَليبُهُمْ***ومِحالُهُمْ غَدْرًا مِحالَكْ
ابن إسحاق، السيرة النبوية. تح: أحمد المزيدي، ص: 112.
بُدِّلَ الرَّبْعُ وُحوشًا***مِنْ كَبيرٍ وصَغيرِ
ذاكَ مِنْ بَعْدِ حِلالٍ***وأَنيسٍ وعُمورِ
ديوان النابغة الشيباني. ج: 1، ص: 69.
يا حِلالَ التُّرْبِ ما***أَبْلاكُمْ إِلّا ويُبْلي
نَحْنُ نَتْلوكُم وما***السّابِقُ إلّا كالمُصَلِّيْ
ديوان ابن سنان الخفاجيّ. تح: مختار الأحمديّ، وآخرين، ص: 533.
"الحِلالُ، بِالكَسْرِ: القَوْمُ المُقيمونَ المُتَجاوِرونَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 297.
24 - 2
وــــــــــ: مَرْكَبٌ مِن مَراكِبِ النِّساءِ يُشْبِهُ الهَوْدَجَ.
وراكِضَةٍ ما تَسْتَجِنُّ بِجُنَّةٍ***بَعيرَ حِلالٍ راجَعَتْهُ مُجَعْفَلِ
فَقُلْتُ لَها لَمّا رَأْيْنا الَّذي بِها***مِنَ الشَّرِ لا َتَسْتَوْهِلي وتَأَمَّلي
ديوان طفيل الغنويّ. تح: حسّان أوغلي، ج: 1، ص: 92.
"الحِلالُ مَرْكَبٌ مِنْ مَراكِبِ النِّساءِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن قتيبة، كتاب المعاني الكبير. ج: 1، ص: 889.
24 - 3
وــــــــــ: مَتاعُ رَحْلِ البَعيرِ.
فكَأَنّها لَمْ تَلْقَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ***ضُرًّا إِذا وضَعَتْ إِلَيْكَ حِلالَها
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. تح: عبد السلام هارون، ج: 2، ص: 22.
"والحِلالُ: مَتاعُ الرَّحْلِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن قتيبة الدينوري، كتاب الجراثيم. تح: محمد الحميدي، ج: 1، ص: 398.
24 - 4
وــــــــــ: البَيْتُ وأَدَواتُهُ.
نواجٍ يَتَّخِذْنَ اللَّيْلَ خِدْرًا***ولا يَعْدِلْنَ مِنْ مَيَلٍ حِلالا
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 302.
"الحِلالُ: البَيْتُ وأَدَواتُهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الشيباني، كتاب الجيم. تح: الأبياري، ج: 1، ص: 164.
25. حُلالَة
اسم
25 - 1
* الحُلالَةُ: قِطْعَةٌ مِنَ الشَّيْءِ المُذابِ في الماءِ ونَحْوِهِ.
"وقَدْ يَعْرِضُ بَعْدَ الخِضابِ النُّصولُ، وأَجْوَدُ ما يُسْتَعْمَلُ فيهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الخِضابِ مِثْلُ الجَوْزَةِ ويُجَفَّفُ، وخُصوصًا مِنْ خِضابٍ فيهِ قُوَّةٌ غَوّاصَةٌ، وكُلَّما ظَهَرَ النُّصولُ أَوْ كادَ يَظْهَرُ، أُخِذَتْ خَشَبَةٌ كالسِّواكِ وبُلَّتْ، وأُخِذَ عَلى طَرَفِها مِنْ حُلالًةِ ذلِكَ الخِضابِ المَعْقودِ".
ابن سينا، القانون في الطب. تح: محمد الضناوي، ص: 353.
27. حَلالِيَّة
اسم
27 - 1
* الحَلاليَّةُ: نَوْعٌ مِنَ الكوفِيّاتِ. (مو)
"وكَتَبَ إِلَيَّ أَيْضًا في صَدْرِ كِتابٍ بَعَثَهُ، وأَهْدى إِلَيَّ حَلالِيَّةً بَيْضاءَ مِنْ أَنْفَسِ ما يُصْنَعُ بِالشّامِ".
رحلة الخياري (تحفة الأدباء وسلوة الغرباء). تح: رجا محمود السامرائي، ص: 129.
"والعِراقِيّونَ منْ أَهْلِ البادِيَةِ يُسَمّونَ الكوفِيَّةَ الحَلالِيَّة (...) وهذا إِذا كانَتْ مِنْ قُطْنٍ".
مجلة المقتطف، عدد آذار (مارس) 1941م، ج: 98، ص: 247.
27 - 2
وــــــــــ: طَبَقة مِنْ رِجال الدّينِ عِنْدَ الصّابِئَةِ المِنْدائِيَّةِ، وهُم الّذينَ يَسيرونَ في الجَنازاتِ، ويُقيمونَ طُقوسَ الذَّبْحِ لِلعامَّةِ. (مو)
"وإِذا ماتَ الصّابِئُ وُضِعَتْ جُثَّتُهُ عَلى فِراشٍ، (...)، وفي مَطاوي ذلِكَ يَتَقَدَّمُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الحَلالِيَّةِ (أيْ الأَشْكَنْداتِ) مِنَ الّذينَ اشْتُهِروا بِصَلاحِهِمْ".
مجلة المشرق، العدد: 11، حزيران 1902، ص: 489.
27 - 3
وــــــــــ مِنَ السُّفُنِ: سَفينَةُ تاجِرِ اللُّؤْلُؤِ. (مو)
"مَعَ مَظاهِرَ وفَعّالِيّاتٍ مِنْ حَياةِ المَرحومِ خَلَفِ بنِ عَبْدِ اللهِ العتيبَةِ، كانَ واحِدًا مِنْ مُلوكِ اللُّؤْلُؤِ في المِنْطَقَةِ؛ امْتَلَكَ 20 سَفينَةً حَلالِيَّةً، وكانَ يُمَوِّلُ أَكْثَرَ مِنْ 100 سَفينَةٍ أُخْرى سَنَوِيًّا".
عبد الله عبد الرحمن، الإمارات في ذاكرة أبنائها، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ج: 2، ص: 85.
28. حَلّ
اسم
28 - 1
* الحَلُّ: زَيْتُ السِّمْسِمِ.
"والسِّمْسِمُ: حَبُّ دُهْنِ الحَلِّ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 7، ص: 207.
"لا تُدْهِنُ الحادُّ إلّا بالحَلِّ الشَّيْرَجِ، أَوْ بِالزِّيْتِ، ولا تُدْهِنُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَدْهانِ المُزَيِّنَةِ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 2، ص: 15.
"فحينَئِذٍ يُسْتَخْرَجُ الدُّهْنُ مِنَ السِّمْسِمِ فيوزَنُ الثَّجيرُ، فبَعْدَ العِلْمِ بِمِقْدارِ الثَّجيرِ يُعْرَفُ قَدْرُ الحَلِّ".
ابن الهمام، شرح فتح القدير. دار الفكر، ج: 7، ص: 26.
28 - 2
o ويا حامِلُ اذْكُرْ حَلًّا: انْظُرْ في عَواقِبِ ما سَتَفْعَلُهُ.
"يا حامِلُ اذْكُرْ حَلًّا".
أبو حاتم السجستاني، المعمَّرون والوصايا. تح: عبد المنعم عامر، ص: 10.
28 - 3
o وأَهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ: أَولو الرَّأْيِ والمَشورَةِ، ومَنْ بأَيْديهِمْ اتِّخاذُ القَرارِ.
"الإِمامَة لا تَجوز إِلّا بِشُروطِها (...) فإِنْ شَهِدَ لَهُ بِذلِكَ أَهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ مِنْ عُلَماءِ المُسْلِمينَ وثِقاتِهِمْ، أَوْ أَخَذَ هُوَ بِذلِكَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَضِيَهُ المُسْلِمونَ، جازَ لَهُ ذلِكَ".
أحمد بن حنبل، العقيدة رواية الخلال. تح: عبد العزيز السيروان، ص: 124.
"كانَ مِنَ الرُّؤَساء الأَماثِلِ، وأَرْبابِ الحَلِّ والعَقْدِ".
ابن الفُوَطي، مجمع الآداب. تح: محمد الكاظم، ج: 5، ص: 109.
"وصِفَةُ العَقْدِ أَنْ يَقولَ لَهُ كُلٌّ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ: قَدْ بايَعْناكَ عَلى إِقامَةِ العَدْلِ والإِنْصافِ، والقِيامِ بِفُروضِ الإِمامَةِ".
مصطفى السّيوطيّ، مطالب أولي النّهى. المكتب الإسلامي، ج: 6، ص: 266.
29. حُلّ
اسم
29 - 1
* الحُلُّ والحِلُّ: وَقْتُ الإِحْلالِ لِلمُحْرِمِ.
"بِأَطْيَبِ الطّيبِ عِنْدَ حِلِّهِ وحَرَمِهِ".
ابن حزم، المحلّى بالآثار. تح: عبد الغفار البنداري، ج: 5، ص: 73.
"فَعَلَ ذلِكَ في حُلِّهِ وحِلِّهِ جَميعًا، وفي حُرْمِهِ؛ أَيْ في وقْتِ إِحْلالِهِ وإِحْرامِهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن دريد، الجمهرة. تح: بعلبكي، ص: 101.
30. حِلّ
اسم
30 - 1
* الحِلُّ: ما جاوَزَ الحَرَمَ.
وما بَدَأْتُ خَليلًا لي أَخا ثِقَةٍ***بِريبَةٍ لا ورَبِّ الحِلِّ والحَرَمِ
ديوان عدي بن زيد. تح: محمّد المعيبد، ص: 51.
«أَرْبَعٌ كُلُهُنَّ فاسِقٌ، يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والغُرابُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ».
صحيح مسلم بشرح النووي. مؤسسة قرطبة، ج: 8، ص: 160.
"فلَما خَرَجوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلوهُ في الحِلِّ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعوني أُصَلِي رَكْعَتَيْنِ".
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 13، ص: 310.
"يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الخُروجُ إلِى أَدْنى الحِلِّ".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد حلاق، ج: 9، ص: 75.
"فإنْ صادَهُ الحَلالُ في الحِلِّ فأَدْخَلَهُ الحَرَمَ، جازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فيهِ".
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن. تح: عبد الله التركي، ج: 8، ص: 219.
"أَمّا في العُمْرَةِ فيَجِبُ الخُروجُ إلى أَدْنى الحِلِّ كَما سَيَأْتيْ".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد حلاق، ج: 9، ص: 75.
30 - 2
وــــــــــ: الغَرَضُ الّذي يُرْمى إِلَيْهِ.
"والحِلُّ: الغَرَضُ الّذي يُرْمى إِلَيْهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 530.
30 - 3
وــــــــــ (عِنْدَ البَنّائينَ): ما بَيْنَ الحَجَرَيْنِ المُتلاصِقَيْنِ في الحائِطِ.
"والحِلُّ عِنْدَ البَنّائينَ ما بَيْنَ الحَجَرَيْنِ المُتلاصِقَيْنِ في الحائِطِ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
30 - 4
o وحِلٌّ وبِلٌّ: حَلالٌ مُباحٌ، والإِتْباعُ فيهِ لِلتَّأْكيدِ.
"اللّهُمَّ لا أُحِلُّها لِمُغْتَسِلٍ، وهِيَ لِشارِبِها حِلٌّ وبِلٌّ".
الفاكهي، أخبار مكة. تح: عبد الملك دهيش، ج: 2، ص: 14.
"إِنَّ نَصيبي إلى اللهِ وإِلى الزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ، وإِلى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وإنَّهُما في حِلٍّ وبِلٍّ في ما وَلِيا وقَضَيا في تَرِكَتي".
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق. تح: عمر العمروي، ج: 33، ص: 183.
"يا بُنَيِّ: كُنْتَ هِبَةَ ماجِدٍ، وعَطِيَّةَ واحِدٍ (...) فأَتْحَفَني اللَّهُ عَلَيْكَ الأَجْرَ، ولا حَرَمَني فيكَ الصَّبْرَ، وأَنْتَ فِي حِلٍّ وبِلٍّ مِنْ قِبَلي".
محيي الدين بن أحمد القرشي، ترتيب الأمالي الخميسية، تح: محمد حسن إسماعيل، ج: 2، ص: 416.
"فإِنْ كانَ هذا المَلِكُ شُجاعًا ناهِضًا فلْيُرِنا هِمَّتَهُ في أَعْداءِ اللهِ الكُفّارِ، ويُجاهِدْهُمْ، ويَتَلَصَّصْهُمْ، ويُعْمِلِ الحيلَةَ في أَخْذِ أَمْوالِهِمْ حِلًّا وبِلًّا، ويَدَعْ عَنْهُ أَذيَّةَ المُسْلِمينَ".
ابن طولون، نقد الطالب لزَغَل المناصب. تح: محمد أحمد دهمان وآخر، ص: 27.
30 - 5
o ويا حالِفُ اذْكُرْ حِلًّا: انْظُرْ في عَواقِبِ ما سَتَفْعَلُهُ.
"يا حالِفُ اذْكُرْ حِلًّا". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الجوهري، الصحاح. تح: عطار، ج: 4، ص: 1673.
31. حَلّال
اسم
31 - 1
* الحَلّالُ: صاحِبُ مِهْنَةِ حَلِّ الحَريرِ.
"والصَّمْدَةُ أَيْضًا عِنْدَ العامَّةِ مِنْ أَدَواتِ حَلّالَةِ الحَريرِ، وهِيَ اللَّوحَةُ الّتي يَجْلِسُ عَلَيْها الحَلّالُ حينَ يُديرُ الدّولابَ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 518.
32. حَلّالَة
اسم
32 - 1
* الحَلّالَةُ: آلَةُ حَلِّ الحَريرِ. (مح)
"الحَلّالَةِ: ما يُحَلُّ عَلَيْهِ الحَريرُ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 186.
"لا يَزالُ النَّشاطُ الصِّناعيُّ عَظيمًا في حَلّالاتِ الحَريرِ في السُّوَيْديَّةِ وجَبَلِ موسى، وفي مَعامِلِ الصّابونِ في أنْطاكيَّةَ، وفي المَطاحِنِ".
محمد كرد عليّ، خطط الشّام. مكتبة النوري، ج: 4، ص: 263.
33. حُلّان
اسم
33 - 1
* الحُلّانُ: الباطِلُ دَمُهُ. (وانْظُرْ: ح ل م).
كُلُّ قَتيلٍ فِي كُلَيْبٍ حُلاّنْ***حَتّى يَنالَ القَتْلُ آلَ شَيْبانْ
ديوان المهلهل. تح: أنطوان القوال، ص: 84.
"قَتيلٌ حُلاّنٌ وحُلاّمٌ: أَيْ باطِلٌ دَمُهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن عباد، المحيط. تح: آل ياسين، ج: 2، ص: 316.
33 - 2
وــــــــــ: الجَدْيُ. (ج) حَلالينُ. (وانْظُرْ: ح ل م).
"عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضى في الأَرْنَبِ بِحُلّانٍ".
البيهقي، السنن الكبرى. تح: محمد عطا، ج: 5، ص: 301.
"والحُلاَّنُ: الجَدْيُ، ويُجْمَعُ حَلالَيْنَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 351.
33 - 3
وــــــــــ: أَلّا يَقْدِرَ المَرْءُ عَلى ذَبْحِ الشّاةِ وغَيْرِها، فيَطْعَنَها مِنْ حَيْثُ يُدْرِكُها.
"والحُلّانُ: أَلّا تَقْدِرَ عَلى ذَبْحِ الشّاةِ وغَيْرِها، فتَطْعَنَها مِنْ حَيْثُ تُدْرِكُها". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في عَصْرِ الدُّوَلِ والإماراتِ)
الصغاني، التكملة. دار الكتب المصرية، ج: 5، ص: 324.
33 - 4
o وحُلّانُ اليَمينِ: كَفّارَتُها.
"أَعْطِهِ حُلّانَ يَمينِهِ؛ أَيْ ما يُحَلِّلُ يَمينَهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 528.
34. حَلَّة / حِلَّة
اسم
34 - 1
* الحَلَّةُ والحِلَّةُ: الجِهَةُ والمَقْصِدُ. (ج) حِلالٌ، وأَحِلَّةٌ.
سَرى بَعْدَ ما غارَ الثُّرَيّا وبَعْدَ ما***كَأَنَّ الثُّرَيّا حِلَّةَ الغَوْرِ مُنْخُلُ
سيبويه، الكتاب. تح: عبد السلام هارون، ج: 1، ص: 405.
"يُقالُ هُوَ حِلَّةُ الغَوْرِ أَيْ قَصْدُهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
سيبويه، الكتاب. تح: عبد السلام هارون، ج: 1، ص: 405.
34 - 2
* الحَلَّةُ: الوِعاءُ الكَبيرُ مِنَ القَصَبِ يُجْعَلُ فيهِ الطَّعامُ. (ج) حِلَلٌ.
لا يَنْظُرُ العَشْوَةَ المُلْتَخَّ غَيْهَبُها***ولا تَضيقُ عَلى زُوّارِهِ الحِلَلُ
ديوان الكميت. تح: محمّد نبيل طريفي، ص: 330.
"والحَلَّةُ، في اصْطِلاحِ أَهْلِ بَغْدادَ، كهَيْئَةِ الزِّنْبيلِ الكَبيرِ مِنَ القَصَبِ يُجْعَلُ فيهِ الطَّعامُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الصغاني، التكملة. دار الكتب المصرية، ج: 5، ص: 324.
34 - 3
وــــــــــ: إناءٌ مَعْدِنِيٌّ يُطْهى فيهِ الطَّعامُ. (ج) حِلَلٌ.
"الحَلَّةُ في اصطِلاحِ مِصْرَ يُطْلَقُ على قِدْرِ النُّحاسِ، لِأنَّهُ يُحَلُّ فيها الطَّعامُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
الزبيدي، تاج العروس. دار الهداية، ج: 28، ص: 320.
"واستعارَ حَلَّةً كَبيرةً مِنْ جارِهِ، ثُمَّ أَعادَها إِلَيْهِ وفيها حَلَّةٌ صَغيرَةٌ".
العقاد، جحا الضاحك المضحك، مؤسسة هنداوي، ص: 97.
34 - 4
وــــــــــ: الحَيُّ، ومَنْزِلُ القَوْمِ.
"فكانَ يَسيرُ مِنْ حِلَّةٍ إِلى حِلَّةٍ بِالبادِيَةِ في لَيْلَةٍ وبَيْنَهُما مَسيرَةُ ثَلاثٍ، فيَأْتي ماءً ويَغْسِلُ يَدَيْهِ ووَجْهَهُ ورِجْلَهُ، ثُمَّ يَأْتي أَهْلَ تِلْكَ الحِلَّةِ فيُخْبِرُها عَنِ الحِلَّةِ الّتي فارَقَها، ويُريهِمْ أنَّ الأَرْضَ طُوِيَتْ لَهُ".
ابن العديم، بغية الطلب. تح: سهيل زكار، ص: 651.
"والحَلَّةُ: قَرْيَةٌ بِناحِيَةِ دُجَيْلٍ مِنْ بَغْدادَ (...) والزِّنْبيلُ الكَبيرُ مِنَ القَصَبِ، والمَحَلَّةُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
الفيروزابادي، القاموس. تح: العرقسوسي، ص: 986.
"والبَرْقَلُ، وهِيَ حَلَّةٌ عامِرَةٌ عَنْ يَمينِ النّيلِ".
نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، دار عزة، ص: 104.
34 - 5
وــــــــــ: القِطْعَةُ مِنَ الحَرَّةِ السَّوْداءِ.
"والحَلَّةُ: القِطْعَةُ مِنَ الحَرَّةِ السَّوْداءِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن عباد، المحيط. تح: آل ياسين، ج: 2، ص: 316.
35. حُلّة
اسم
35 - 1
* الحُلَّةُ: الإِزارُ مَعَ القَميصِ والرِّداءِ، أَوْ أَحَدِهِما. (ج) حُلَلٌ، وحِلالٌ.
فطارَ بِقِحْفِ ابنَةِ الجِنِّ ذو***سَفاسِقَ قَدْ أَخْلَقَ المِحْمَلا
إِذا كَلَّ أَمْهَيْتُهُ بِالصَّفا***فحَدَّ ولَمْ أُرِهِ صَيْقَلا
عَظاءَةَ قَفْرٍ لَها حُلَّتا***ن مِنْ ورَقِ الطَّلْحِ لَمْ تُغْزَلا
ديوان تأبّط شرًّا وأخباره. تح: علي شاكر، ص: 165.
«خَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ، وخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الكَبْشُ الأَقْرَنُ».
سنن أبي داود. تح: شعيب الأرناؤوط، وآخرين، ج: 5، ص: 69.
"كَسَوْتَنيها وقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلْتَ؟".
البخاري، الصحيح. تح: العطّار، ص: 211.
"الحُلَّةُ إزارٌ ورِداءٌ بُرْدٌ أَوْ غَيْرُهُ، ولا يُقالُ لَها حُلَّةٌ حَتّى تَكونَ ثَوْبَيْنِ، وفي الحَديْثِ تَصْديقُهُ، وهْوَ ثَوْبٌ يَمانيٌّ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: هنداوي، ج: 1، ص: 350.
لَيْسَ الفَتى بالمُسْمِنِ المُخْتالِ***ولا الّذي يَرْفُلُ في الحِلالِ
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 530.
"وهذِه ِالجَزائِرُ فيها رَئيسٌ يَجْمَعُهُمْ ويَذُبُّ عَنْهُمْ ويُهادِنُ عَلى قَدْرِ طاقَتِهِ، وزَوْجَتُهُ تَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ (...) وهِيَ تَلْبَسُ حُلَّةَ الذَّهَبِ المَنْسوجِ، وعَلى رَأْسِها تاجُ الذَّهَبِ".
ابن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار. تح: إحسان عباس، ج: 1، ص: 237.
35 - 2
وــــــــــ: الثَّوْبُ.
لا يَعْتَري شُربَنا اللِّحاءُ وقَدْ***توهَبُ فينا القِيانُ والحُلَلُ
ديوان الأسود بن يعفر. تح: نوري القيسي، ص: 68.
"هل رَضيتَ الحُلَّةَ؟".
الآجري، كتاب الشريعة. تح: عبد الله الدميجي، ج: 5، ص: 2230.
"فالحِكْمَةُ كَنْزٌ لا يَفْنى عَلى إِنْفاقٍ، وذَخيرَةٌ لا يُضْرَبُ لَها بِالإِمْلاقِ، وحُلَّةٌ لا تَخْلَقُ جِدَّتُها".
ابن المقفع، كليلة ودمنة. المطبعة الأميرية، ص: 29.
اتْرُكِ الحُظوظَ واجَّرَّدْ***واذْهَبْ لِلتَّخَلّي
واقْطَعِ العَلائِقَ تُكْسى***حُلَّةَ التَّجَلّي
ديوان أبي الحسن الششتري. تح: علي سامي النشار، ص: 155.
"أَلَمْ أَعُدَّكَ وأَنْتَ في ضَنا المَحْوِ والمَحاقِ، وأُعِدَّكَ لِلوُجودِ بَعْدَ الفَنا والاحْتِراقِ، وأكْسُكَ بَعْدَ التَّجَرُّدِ حُلَّةَ البَهاءِ؟".
البربير، المفاخرات والمناظرات. تح: الطيان، ج: 1، ص: 66.
35 - 3
وــــــــــ: السِّلاحُ.
*يا عَينُ بَكّي هَمَلًا عَلَى هَمَلْ*
*عَلى يَزيدَ ويزيدَ بْنِ حَمَلْ*
*قَتّالُ أبْطالٍ وجَرّارُ حُلَلْ*
عبد العزيز محمّد الفيصل، شعراء بني عُقيل وشعرهم في الجاهليّة والإسلام. ج: 1، ص: 168.
"ولَبِسَ فُلانٌ حُلَّتَهُ أَيْ سِلاحَهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الأزهري، تهذيب اللغة. الدار المصرية، ج: 3، ص: 444.
جِلْدٌ عَلَيْهِ مِنْ نُقوشٍ جُمْلَهْ***كَما تَرى في حُلَّةِ القِرابِ
ابن مالك، الإعلام بمثلث الكلام. مطبعة الجمالية، ص: 62.
35 - 4
وــــــــــ: البَدْلَةُ، وهِيَ ثَوْبٍ لِلرِّجالِ يَتأَلَّفُ مِنْ سُتْرَةٍ وسِرْوالٍ، ولَهُ صِدارٌ (صَدْرِيَّةٌ) أَحْيانًا. (مح)
"بَدْلَةٌ: حُلَّةٌ".
أحمد رضا العاملي، متن اللغة، دار مكتبة الحياة، ج: 1، ص: 126.
36. حِلّة
اسم
36 - 1
* الحِلَّةُ: شَجَرَةٌ شائِكَةٌ تَنْبُتُ في غِلَظِ أَرْضِ الحِجازِ. (ج) حِلٌّ، وحِلالٌ، وأَحِلَّةٌ.
مَررْنَ عَلى الحِلِّ ما ذُقْنَهُ***وعالَجْنَ مِنْ مَرِّ لَيْلاً طَويلا
الشعراء الجاهليون الأوائل. دار المشرق، ص: 291.
يَأْكُلُ مِنْ خِصْبٍ سَيالٍ وسَلَمْ***وحِلَّةٍ لَمّا تُوَطِّئْها قَدَمْ
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 9، ص: 251.
وَلي لَدى الحِلَّةِ الفَيْحاءِ غُصْنُ نَقًى***يَهْفو فيَجْذِبُهُ خَفْقٌ فيَنْجَذِبُ
ديوان عفيف الدّين التّلمسانيّ. تح: يوسف زيدان، ص: 95.
36 - 2
وــــــــــ: جَماعَةُ بُيوتِ النّاسِ، أَوْ مِئَةُ بَيْتٍ. (ج) حِلالٌ، وأَحِلَّةٌ، وحِلَلٌ.
فصَبَّحْنَ مِنْ حَيِّ الأَراقِمِ حِلَّةً***صَباحَ ثَمودٍ غِبَّ أُمِّ فَصيلِ
الحسن الهمداني، الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير. تح: محب الدين الخطيب، ص: 95.
وَجَدْنا بِهِ العَمْرَيْنِ عَمْرَو عُدَيَّةٍ***وعَمْرَو بْنَ عَمْرٍو في حِلالِ صُلاطِحِ
شعرعمرو بن معدي كَرِبَ. تح: مطاع الطّرابيشيّ، ص: 74.
"وهُمْ أَصْحابُ حِلالٍ ورِعْيَةٍ ويَسارٍ".
مجموعة مؤلفين، نوادر المخطوطات. تح: عبد السلام هارون، ج: 2، ص: 429.
"الحِلَّةُ: بُيوتٌ مُجْتَمِعَةٌ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن مالك، إكمال الإعلام. تح: سعد الغامدي، ج: 1، ص: 159.
"وما زالَ يَنْتَقِلُ مِنْ حِلَّةٍ إلى أُخْرى، ومِنْ مَنْهَلٍ إلى مَنْهَلٍ، حَتّى بَدَتْ لَهُ مَعالِمُ الكوفَةِ".
علي الجارم، سلاسل الذهب. دار الشروق، ص: 223.
36 - 3
وــــــــــ: مَكانُ نُزولِ القَوْمِ واجْتِماعِهِمْ.
فسَقى مَنازِلَها وحِلَّتَها***قَرِدُ الرَّبابِ لِصَوْتِهِ زَجَلُ
ديوان عمرو بن قميئة. تح: شايرلز لايل، ص: 28.
لَأُحِبُّ الحِجازَ مِنْ حُبِّ مَنْ فيهِ***وأَهْوى حِلالَهُ مِنْ حِلالِ
ديوان وضاح اليمن. تح: محمّد خير البقاعيّ، ص: 74.
"والحِلَّةُ: مُجْتَمَعُ القَوْمِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 526.
36 - 4
وــــــــــ: النّازِلونَ جَماعَةً بِمَكانٍ.
لَقَدْ كانَ في شَيْبانَ لوْ كُنْتَ راضيًا***قِبابٌ وحَيٌّ حِلَّةٌ وقَنابِلُ
ديوان الأعشى الكبير. تح: محمد محمد حسين، ص: 183.
"والحِلَّةُ: قَوْمٌ نُزولٌ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 3، ص: 26.
36 - 5
وــــــــــ: مَجْلِسُ القَوْمِ.
"والحِلَّةُ: مَجْلِسُ القَوْمِ؛ لأَنَّهُمْ يَحُلّونَهُ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن سيده، المحكم. تح: هنداوي، ج: 2، ص: 526.
36 - 6
o وقَوْمٌ حِلَّةٌ: لا يَتَشَدَّدونَ في دينِهِم.
أَجْذِمْ إِلَيْكَ إنَّها بَنو عَبْسْ***المُعْشَرُ الحِلَّةُ في القَوْمِ الحُمُسْ
ابن هشام، السيرة النبوية. تح: عمر تدمري، ج: 1، ص: 227.
"كانَتِ العَرَبُ عَلى دينَيْنِ، حِلَّةٍ وحُمْسٍ".
الأزرقي، تاريخ مكة. تح: رشدي الصالح ملحس، ج: 1، ص: 179.
"وكانَ سائِرُ العَرَبِ مِنَ الحِلَّةِ والحُمْسِ لا يَعْدونَ في الأَشْهُرِ الحُرُمِ عَلى أَحَدٍ".
الأزرقي، أخبار مكة. تح: عبد الملك دهيش، ج: 1، ص: 627.
"الحِلَّةَ: وهُمْ ما عَدا الحُمْسَ؛ كانوا يَطوفونَ عُراةً إنْ لَمْ يَجِدوا ثِيابَ أَحْمَسَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تح: دارالفلاح للبحث العلمي، ج: 11، ص: 416.
37. حُلول
اسم
37 - 1
* الحُلولُ: الاعتِقادُ بِحلولِ اللهِ في الأَجْسامِ.
"وأَجازَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الحُلولَ في الأَجْسامِ، وأَصْحابُ الحُلولِ إِذا رَأَوا إِنْسانًا يَسْتَحْسِنونَهُ لَمْ يَدْروا لَعَلَّ إِلَهَهُمْ فيهِ".
أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين. تح: نعيم زرزور، ص: 171.
"أَيْ أَفَلا يَتوبونَ بِالانْتِهاءِ عَنْ تِلْكَ العَقائِدِ والأَقْوالِ الزّائِغَةِ، ويَسْتَغْفِرونَهُ بِالتَّوْحيدِ والتَّنْزيهِ عَنِ الاتِّحادِ والحُلولِ بَعْدَ هَذا التَّقْريرِ والتَّهْديدِ".
تفسير البيضاوي. تح: محمّد صبحي وآخر، ج: 1، ص: 454.
"فكْمْ عالِمٍ زاغَ في العَمَلِ والعَقْدِ، وراغَ في جَميعِ أَحْوالِهِ عَنْ سَبيلِ القَصْدِ، وكَثيرٌ مِنْ أَبْنائِهِ ذَوو زَنْدَقَةٍ وإِلْحادٍ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقولُ بالحُلولِ والاتِّحادِ".
أحمد البربير، المفاخرات والمناظرات. تح: الطيان، ص: 200.
37 - 2
o والحُلولُ الجِواريُّ: كَوْنِ جِسْمٍ ظَرْفًا لجِسْمٍ آخَرَ.
"وكَيْفَ يَسوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقولَ: إِنَّهُ بِكُلِّ مَكانٍ عَلَى الحُلولِ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلى العَرْشِ اسْتَوى﴾، أَيِ: اسْتَقَرَّ؛ كَما قالَ: ﴿فَإِذا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ومَنْ مَعَكَ عَلى الفُلْكِ﴾ أَي: اسْتَقْرَرْتَ".
ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث. تح: محمد الأصفر، ج: 1، ص: 394.
"الحُلولُ الجِواريُّ عِبارةٌ عَنْ كَوْنِ أَحَدِ الجِسْمَيْنِ ظَرْفًا للِآخَرِ، كَحُلولِ الماءِ في الكوزِ".
الشريف الجرجاني، معجم التعريفات. تح: محمد صديق المنشاوي، ص: 82.
37 - 3
o والحُلولُ الحَيِّزِيُّ: وُجودُ جِسْمٍ في مَكانٍ.
"لَوْ جازَ حُلولُ الحاصِلِ في الحَيِّزِ في غَيْرِ الحاصِلِ فيهِ؛ لَكانَ يَجِبُ تَجْويزُ أَنْ يُقالَ: العالَمُ حالٌّ في البارِئِ تَعالى! مَعَ أَنَّ العالَمَ غَنِيٌّ بِالحَيِّزِ، والبارِئُ يَسْتَحيلُ اخْتِصاصُهُ بِالحَيِّزِ".
الفخر الرازي، نهاية العقول في دراية الأصول. تح: سعيد فودة، ج: 4، ص: 34.
"لَمْ يَلْزَمْ مِنْ حُلولِ الجِسْمِ في الحَيِّزِ أَنْ يَكونَ الحَيِّزُ مُتَعَدِّدًا مُنْقَسِمًا في نَفْسِهِ".
ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية. تح: محمد اللاحم، ج: 4، ص: 218.
"والحُلولُ الحَيِّزِيُّ كَحُلولِ الأَجْسامِ في الأَحْيازِ".
بطرس البستاني، (1883م)، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
37 - 4
o والحُلولُ السَّرَيانيُّ: اتِّحادُ الجِسْمَينِ، بِحَيْثُ تَكونُ الإِشارَةُ إِلى أَحَدِهِما إِشارَةً إِلى الآخَرِ.
"والغَرَضُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْن حُلولِ المَعانِ بِالذَّواتِ حُلولَ الاتِّصافِ، وبَيْنَ حُلولِ المُتَمَكِّنِ في المَكانِ، بِمَعْنى تَماسِّهِما بِسَطْحَيْهِما، وبَيْنَ حُلولِ السَّرَيانِ كَحُلولِ الجِسْمِ وسَرَيانِهِ في الأَبْعادِ؛ فالتَّفْسيرانِ الأَخيرانِ مِنْ عَوارِضِ الأَجْسامِ".
الفخر الرازي، معالم أصول الدين. تح: نزار حمادي، ج: 1، ص: 228.
"ارْتِسامُ الشَّيْءِ في غَيْرِهِ أو الحُلولُ فيهِ قَد يَكونُ عَلى سَبيلِ السَّرَيانِ كارْتِسامِ الصّورَةِ عَلى سَطْحِ المِرْآةِ".
نصير الدين الطوسي، بقاء النفس بعد فناء الجسد. ص: 40.
"والحُلولُ السَّرَيانِيُّ كَحُلولِ الصّورَةِ في الهُيولى، وكَحُلولِ الأَعْراضِ النَّفْسانِيَّةِ في النَّفْسِ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
37 - 5
o والحُلولُ الوَصْفِيُّ: حلولُ عَرَضٍ غَيْرِ مادِّيٍ بِالجِسْمِ صِفَةً لَهُ كاللَّوْنِ.
"لمّا كانَ حُلولُ صِفاتِ الخَمْرِ في العَصيرِ عِلَّةً في تَحْريمِهِ وتَنْجيسِهِ، وجَبَ إِذا ارْتَفَعَتْ مِنها تِلْكَ الصِّفاتُ الّتي هِيَ العِلَّةُ في التَّحْريمِ والتَّنْجيسِ أَنْ يَزولَ الحُكْمُ بِزوالِ العِلَّةِ".
سحنون، المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية، ج: 5، ص: 239.
"ذاتُ الجَوْهَرِ مَعْقولَةٌ كالحُصولِ فيهِ أَعْني حُلولَ الأَعْراضِ في ذاتِ الجَوْهَرِ".
الشريف الجرجاني، شرح المواقف للإيجي. تح: محمود الدمياطي، ج: 5، ص: 26.
"والحُلولُ الوَصْفِيُّ كَحُلولِ السَّوادِ في الجِسْمِ".
بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، ص: 189.
38. حُلولِيَّة
اسم
38 - 1
* الحُلولِيَّةُ: طائِفَةٌ تَدينُ بِالحُلولِ، وهُوَ القَوْلُ أَنَّ اللهَ حالٌّ ومَوجودٌ في كُلِّ شَيْءٍ.
"فإِنّي أُحَذِّرُ إِخْواني مِنَ المُؤْمِنِينَ مَذْهَبَ الحُلولِيَّةِ الَّذينَ لَعِبَ بِهِمُ الشَّيْطانُ، فخَرَجوا بِسوءِ مَذْهَبِهِمْ عَنْ طَريقِ أَهْلِ العِلْمِ. مَذاهِبُهُمْ قَبيحَةٌ، لا يَكونُ إِلّا في كُلِّ مَفْتونٍ هالِكٍ، زَعَموا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ حالٌّ في كُلِّ شَيْءٍ".
الآجري، كتاب الشريعة. تح: عبد الله الدميجي، ج: 3، ص: 1074.
"في قُلوبِهِمْ: بَيانٌ لِمَكانِ الإِشْرابِ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿إِنَّما يَأْكُلونَ فِي بُطونِهِمْ نارًا﴾ ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ بِسَبَبِ كُفْرِهِمِ؛ وذلِكَ لِأَنَّهُمْ كانوا مُجَسِّمَةً، أَوْ حُلوليّةً، ولَمْ يَرَوا جِسْمًا أَعْجَبَ مِنْهُ، فتَمَكَّنَ في قُلوبِهِمْ ما سَوَّلَ لَهُمُ السّامِريُّ".
البيضاويّ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج: 1، ص: 94.
"وجُوِّزَ أَنْ يَكونَ مِنَ الحُلوليَّةِ القائِلينَ بِحُلولِ الرَّبِّ سُبْحانَهَ وتَعالى في بَعْضِ الذَّواتِ، ويَكونُ مُعْتَقِدًا حُلولَهَ عَزَّ وجَلَّ فيهِ، ولِذلِكَ سَمّى نَفْسَهُ إِلَهًا".
الآلوسيّ، روح المعاني. تح: ماهر حبّوش، ج: 19، ص: 166.
39. حَليل
اسم
39 - 1
* الحَليلُ: الزَّوْجُ مُذَكّرًا أو مُؤَنَّثًا. (ج) أَحِلّاءُ، وحَلائِلُ. وهِيَ بِتاءٍ. (ج) حَلائِلُ.
لَعَمْرُ أَبيكَ ما يُغْني مَقامي***مِنَ الفِتْيانِ أَنْجيَةٌ حُفولُ
يَرومُ ولا يُعَلِّصُ مُشْمَعِلًّا***عَنِ العَوراءِ مَضْجَعُهُ ثَقيلُ
تَبوعٌ لِلْحَليلَةِ حَيْثُ كانَتْ***كَما يَعتادُ لِقْحَتَهُ الفَصيلُ
ديوان أحيحة بن الجلاح. تح: حسن باجوده، ص: 76.
﴿وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ (النساء: 23).
«ثُمَّ أَنْ تُزاني حَليلَةَ جارِكَ».
مسند أحمد. تح: الأرناؤوط، ج: 7، ص: 416.
أَلا مَنْ مُبْلِغٌ أَسْماءَ عَنّي***ولَوْ حَلَّتْ بيُمْنٍ أوْ جُبارِ
بِأَنَّ حَليلَها دَرَهَتْ عَلَيْهِ***خُطوبٌ لا تُفَرَّجُ بِالسِّرارِ
ديوان عامر بن الطفيل. دار صادر، ص: 74.
أَلَسْتَ كُلَيْبيًّا إِذا سيمَ خُطَّةً***أَقَرَّ كَإِقْرارِ الحَليلةِ لِلبَعْلِ
شعر البعيث المجاشعيّ. تح: عدنان محمّد أحمد، ص: 77.
"أَيْ: مِنْ قَضائِهِ وقَدَرِهِ وخَرْقِهِ لِلعاداتِ، وأَنْتِ حَليلَةُ الخَليلِ تُشاهِدينَ مُعْجِزاتِهِ وتُعايِنينَ آياتِهِ؟".
الرّسعني، رموز الكنوز. تح: عبد الملك دهيش، ج: 3، ص: 196.
"والمَوْطوءَةُ بِالزِّنا لا يَصْدُقُ عَلَيْها أَنَّها مِنْ نِسائِهِمْ، ولا مِنْ حَلائِلِ أَبْنائِهِمْ".
الشوكاني، فتح القدير. دار المعرفة، ج: 1، ص: 285.
39 - 2
وــــــــــ: الجارُ، مُذَكّرًا ومُؤَنَّثًا. وهِيَ بِتاءٍ.
ولَسْتُ بأطْلَسِ الثَّوْبَيْنِ يُصْبي***حَليلَتَهُ إذا هَجَعَ النِّيامُ
ديوان أوس بن حجر. تح: محمّد يوسف نجم، ص: 115.
صَحا القَلْبُ عَنْ أَهْلِ الرِّكاءِ وفاتَهُ***عَلَى مَأْسَلٍ خِلاَّنُهُ وحلاَئِلُهْ
ديوان ابن مقبل. تح: عزة حسن، ص: 178.
"لَمْ يُرِدْ بِالحَليلَةِ ههُنا امْرَأَتَهُ، إنَّما أرادَ جارَتَهُ؛ لِأَنَّها تُحالُّهُ في المَنْزِلِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
الأزهري، تهذيب اللغة. الدار المصرية، ج: 3، ص: 440.
"وحَليلَتُكَ: امرَأَتُكَ وأَنتَ حَليلُها، ويُقالُ للمُؤَنَّثِ: حَليلٌ أَيضًا، وحَليلَتُكَ جارَتُكَ".
الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز. تح: محمد علي النجار، ج: 2، ص: 493.
39 - 3
وــــــــــ: الحَلالُ (ضِدُّ الحَرامِ).
"والحَلالُ والحَليلُ والحِلُّ: الحَلالُ بِعَيْنِهِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن عباد، المحيط. تح: آل ياسين، ج: 2، ص: 315.
39 - 4
وــــــــــ (في الكيمياءِ): المادَّةُ الَّتي يُرادُ تَحْليلُها. (مح)
"حَليلةٌ (ج حَلائِلُ): المادَّةُ الَّتي يُرادُ تَحْليلُها".
محمد هيثم الخياط، المعجم الطبي الموحد، ص: 58.
40. مِحْلال
اسم
40 - 1
* المِحْلالُ: المِحْراثُ.
"والمِفْأَدُ المِحْراثُ وهُوَ المِحْلالُ".
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 6، ص: 50.
41. مَحَلّ
اسم
41 - 1
* المَحَلُّ: المَنْزِلَةُ. (ج) مَحالُّ.
وأَلْفَيْتُ أَسْناهُمْ مَحَلًّا ومَنْصِبًا***رَشيدًا عَنِ الفَحْشاءِ والإفْكِ ناهيًا
الشعراء الجاهليون الأوائل. دار المشرق، ص: 242.
"هذا إِلى تَشْريدِكَ بِأُمِّ المُؤْمِنينَ عائِشَةَ، وإِحْلالِها مَحَلَّ الهونِ".
أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب، المكتبة العلمية، ص: 367.
"وكانَ أَبو الشّيصِ مِنْ شُعَراءِ عَصْرِهِ، مُتَوَسِّطَ المَحَلِّ فيهِمْ، غَيْرَ نابِهِ الذِّكْرِ؛ لِوُقوعِهِ بَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ الوَليدِ وأَشْجَعَ وأَبي نُواسٍ".
الأصبهاني، الأغاني. تح: إحسان عباس وآخرين، ج: 16، ص: 279.
"صَحِبَ أَبا بَكْرٍ بْنَ مُجاهِدٍ واخْتَصَّ بِهِ، ولَطُفَ مَحَلُّهُ مِنْهُ".
ابن الأبار، التكملة. تح: بشارعواد، ج: 2، ص: 26.
"ولَها رَسائِلُ كَثيرَةٌ تُحِلُّها مَحَلًّا رَفيعًا بَيْنَ مَشاهيرِ الكَتَبَةِ".
زينب العاملي، الدر المنثور. المطبعة الأميرية، ص: 882.
41 - 2
وــــــــــ: المَكانُ والمَوْضِعُ.
ومَوْلًى ضَعيفِ النَصْرِ ناءٍ مَحَلُّهُ***جَشَمْتُ لَهُ ما لَيْسَ مِنّيَ جاشِمُهْ
إِذا ما رَآني مُقبِلًا شَدَّ صَوْتَهُ***عَلى القِرْنِ واعْلَولى عَلى مَنْ يُخاصِمُهْ
ديوان عمرو بن قميئة. تح: شايرلز لايل، ص: 36.
ويَأْبى الذَّمَّ لي أَنّي كَريمٌ***وأَنَّ مَحَلِّيَ القَبَلُ اليَفاعُ
شعر ربيعة بن مقروم الضبيّ. تح: تماضر حرفوش، ص: 33.
"وعَلِمَ أَنَّهُ مَحَلٌّ لِكَشْفِ الأَسْرارِ الجَليلَةِ الخَطيرَةِ، وأَنَّهُ مَأْمونٌ عَلى ما يُسْتَوْدَعُ مِنْ ذلِكَ".
آثار ابن المقفع. دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 34.
"ويُعَبَّرُ بِالعَيْنِ عَنْ إِدْراكِ المُبْصِراتِ؛ لِأَنَّها مَحَلُّ الإِدْراكِ".
العز ابن عبد السَّلام، الإمام في بيان أدلة الأحكام. تح: رضوان مختار، ص: 239.
"والمَذْهَبُ المَشْهورُ عِنْدَ الأَصْحابِ أَنَّ مَحَلَّ الاسْتِجْمارِ نَجِسٌ".
عبد العزيز بن حمد آل معمر، منحة القريب المجيب. تح: محمد السكاكر، ص: 34.
41 - 3
وــــــــــ (في النَّحْوِ): ما يَسْتَحِقُّهُ اللَّفْظُ الواقِعُ فيهِ مِنَ الإِعْرابِ لَوْ كانَ مُعْرَبًا؛ فيُقالُ مَثَلًا: في مَحَلِّ رَفْعٍ كَذا.
"﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ﴾، إِيّاكَ: في مَحَلِّ النَّصْبِ، بِرُجوعِ ما في الفِعْلِ عَلَيْهِ".
الخليل، الجمل في النحو. تح: فخر الدين قباوة، ص: 91.
"فقَوْلُهُ سِواكَ" مُبْتَدَأٌ في مَحَلِّ رَفْعٍ، خَرَجَ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ".
علي بن أبي الفرج، الحماسة البصرية. تح: عادل سليمان، ص: 2240.
"أَلَها مَحَلٌّ مِنَ الإِعْرابِ أَوْ لا؟" ".
محمد السنباوي، ثمر الثمام. تح: عبد الله العتيق، ص: 117.
41 - 4
وــــــــــ: نَوْعٌ مِنَ السَّمَكِ.
"هذِهِ الاثْنا عَشَرَ نَوْعًا مِنَ الحوتِ الّتي ذَكَرْناها، هِيَ: البوري، والقاجوجُ، والمَحَلُّ...".
الإدريسي، نزهة المشتاق. مكتبة الثقافة الدينية، ص: 289.
42. مَحَلّاتِيَّة
اسم
42 - 1
* المَحَلّاتِيَّةُ (في عِلْمِ اللِّسانِيّاتِ): عَدَدُ المَحَلّاتِ الَّتي يَأْخُذُها مَحْمولٌ ما ونَوْعُها. (مو)
"ولا يَرِدُ الحَمْلُ الدّالُّ عَلى غَيْرِ عاقِلٍ مَفْعولًا لِمَحْمولٍ ثُلاثِيِّ المَحَلّاتِيَّةِ".
أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربية، منشورات عكاظ، ص: 106.
43. مَحَلّانِيَّة
اسم
43 - 1
* المَحَلّانِيَّةُ: جَعْلُ الأَمورِ في الثَّقافَةِ والتَّوْظيفِ والإِدارَةِ ونَحْوِ ذلِك أَكْثَرَ مَحَلِّيَّةً، بِإخْضاعِها لِسَيْطَرَةِ أَوْ هَيْمَنَةِ أَوْ تَأْثيرِ الأَشْخاصِ الأَصْلِيِّيْنَ. (مح)
"إِنَّ التَّيّاراتِ القَوِيَّةِ لِلمَحَلّانِيَّةِ والنَّشِطَةَ في العالَمِ، تَسْخَرُ مِنَ التَّوَقُّعاتِ الغَرْبِيَّةَ بَأَنَّ الثَّقافَةَ الغَرْبِيَّةَ سَتُصْبِحُ ثَقافَةَ العالَمِ".
نادية محمود مصطفى، التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي، رابطة الجامعات الإسلامية، ص: 110.
44. مَحَلَّة
اسم
44 - 1
* المَحَلَّةُ، والمَحِلَّةُ: المَوْضِعُ يَنْزِلُهُ القَوْمُ. (ج) مَحالُّ.
وأَنا الّذي بَيَّتُّكُمْ في فِتْيَةٍ***بمَحِلَّةٍ شَكْسٍ ولَيْلٍ مُظْلِمِ
السكري، شرح أشعار الهذليين. تح: عبد السّتار فراج، ج: 2، ص: 687.
أَشاقَكَ مِنْ عَهْدِ الخَليطِ مَغانِ***عَفَتْ مُنْذُ أَحْوالٍ خَلَوْنَ ثَمانِ
أَأَنْ أبْصَرَتْ عَيْناكَ دارًا مَحَلَّةً***بِجِزْعِ الحَلا عَيْناكَ تَبْتَدِرانِ
ديوان أبي بكر الصِّدِّيق. تح: راجي الأسمر، ص: 49.
"والجِواءُ: فُرْجَةٌ بَيْنَ مَحَلَّةِ القَوْمِ وسْطَ البُيوتِ".
الخليل، العين. تح: المخزومي وآخر، ج: 6، ص: 196.
"والجَنابُ بِالفَتْحِ الفِناءُ، وما قَرُبَ مِنْ مَحَلَّةِ القَوْمِ".
الرازي، مختار الصحاح. تح: يوسف الشيخ، ص: 48.
حَيِّ المَنازِلَ بِالكَديدِ الأَحْمَرِ***بِالجَنْبِ مِنْ طَوْدِ الحِصانِ الأَيْسَرِ
أَمْسى الكَديدُ طَوامِسًا أَعْلامُهُ***قَفْرَ المَحِلَّةِ يا لَهُ مِنْ مُقْفِرِ
ديوان محمد الطلبة. تح: محمد بن الشبيه بن ابوه، ص: 227.
44 - 2
و المَحَلَّةُ: الحارَةُ، أو الحَيُّ المُتَّصِلُّ المَنازِلِ في المَدينَةِ.
"فعَمَدَ مَنْ بَقِيَ مِنَ المَطْعونينَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ المَحَلَّةِ إلى بابِ تِلْكَ الدّارِ فسَدَّهُ".
الجاحظ، كتاب الحيوان. تح: عيون السود، ج: 1، ص: 334.
"وبِهذِهِ الدّارِ سُمِّيَتِ المَحَلَّةُ الّتي بِبابِ أَنْطاكْيَةَ (الدّارَيْنِ)؛ إِحدى الدّارَيْن هذِهِ، والدّارُ الأُخْرى بَناها قَبْلَهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ صالِحٍ".
ابن العديم، زبدة الحلب. دار الكتب العلمية، ص: 46.
"قَوْلُهُ: (إِذْ أَذانُ الحَيِّ يَكْفيهِ) لِأَنَّ أَذانَ المَحَلَّةِ وإِقامَتَها كَأَذانِهِ وإِقامَتِهِ؛ ِلأَنَّ المُؤَذِّن نائِبُ أَهْلِ المَصْر ِكُلِّهِمْ".
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار. تح: عادل عبد الموجود وآخر، ج: 2، ص: 63.
44 - 3
وــــــــــ: الجَيْشُ، أَوِ الفَيْلَقُ مِنْهُ.
"كانَ قَدْ بويِعَ لَهُ بِقُرْطُبَةَ، وهُوُ المَقْتولُ بِها، المُحَمَّلُ رَأْسُهُ إِلى مَحَلَّةِ العَدوِّ المُرابِطينَ، المُحاصَرَةِ لِأَبيهِ بِإِشْبيليَةَ".
لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة. تح: يوسف طويل، ج: 2، ص: 26.
"وبَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَتْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ، وسَعَوا في تَحْصِيلِ مَرْضاتِ اللهِ (...) فقابَلْناهُمْ بِما أَزالَ دَهْشَتَهُمْ وفَزَعَهُمْ، وكَشَفَ جَزَعَهُم.. إِلى أَنْ خَيَّمْنا عَلَيْهِمْ بِأَوْطاطَ، فأَظْهَروا مِنْ حُسْنِ الامْتِثالِ والطّاعَةِ ما وصَلوا بِهِ إِلى الغايَةِ، وقاموا بِواجِبِ المَحَلَّةِ السَّعيدَةِ مِنَ الضّيافاتِ والمَبَرَّةِ".
أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا. تح: جعفر الناصري وآخر، ج: 9، ص: 203.
44 - 4
وــــــــــ: القَوْمُ يُسافِرونَ في وُجْهَةٍ واحِدَةٍ. (ج) مَحَلّاتٌ.
"والمَحَلَّةُ: القَوْمُ يُسافِرونَ في وُجْهَةٍ واحِدَةٍ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
الزبيدي، التكملة والذيل والصلة. تح: مصطفى حجازي وآخرين، ج: 6، ص: 69.
45. مُحِلَّة
اسم
45 - 1
* المُحِلَّةُ: كُلُّ أَداةٍ تَلْزَمُ للمُكوثِ والإقامَةِ؛ أَشْهَرُها: القِدْرِ، والرّحى، والدَّلوُ، والشَّفْرَةُ، والفَأَسُ، والقَدّاحَةُ.
لا تَعْدِلَنَّ أَتاوِيّينَ تَضْرِبُهُمْ***نَكْباءُ صِرٌّ بِأَصْحابِ المُحِلاّتِ
[الأَتاوِيّونَ: الغُرباءُ. نَكْباءُ صِرٌّ: ريحٌ بارِدَةٌ]
"والمُحِلَّتانِ: القِدْر والرَّحى، فإِذا قُلْتَ: المُحِلّات؛ فهِيَ القِدْرُ والرَّحى والدَّلْوُ والقِرْبَةُ والجَفْنَة والسِّكّينُ والفَأْسُ والزَّنْدُ؛ لِأَنَّ مَنْ كانَتْ هذِهِ مَعَهُ حَلَّ حَيْثُ شاءَ، وإِلا فلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَن يُجاوِرَ النّاسَ يَسْتَعيرُ مِنْهُمْ بَعْضَ هذِهِ الأَشْياءِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 297.
45 - 2
o والتَّلْعَةُ المُحِلَّةُ: تَلْعَةٌ تَضُمُّ بَيْتًا أَوْ بَيْتَيْنِ.
"قيلَ لِأَعْرابِيٍّ: أَيُّ مَطَرٍ أَصابَكَ؟ قالَ: مُطَيْرَةٌ كَسيلِ شِعابِ السَّخْبَرِ، وتُرَوّي التَّلْعَةَ المُحِلَّةَ".
المرزوقي، الأزمنة والأمكنة. تح: خليل المنصور، ص: 360.
"وتَلْعَةٌ مُحِلَّةٌ: تَضُمُّ بَيْتًا أَوْ بَيْتَيْنِ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في العَصْرِ الحَديثِ)
ابن منظور، اللسان. تح: أمين محمد وآخر، ج: 3، ص: 297.
46. مُحِلَّتان
اسم
46 - 1
* المُحِلَّتانِ: القِدْرُ والرَّحى.
"والمُحِلَّتانِ: القِدْرُ والرَّحى، فإِذا قيلَ: المُحِلَّاتُ، فهِيَ: القِدْرُ، والرَّحى، والدَّلْوُ، والشَّفْرَةُ، والفَأْسُ، والقَدّاحَةُ؛ أَيْ مَنْ كانَ عِنْدَهُ هَذا حَلَّ حَيْثُ شاءَ". (وهذِهِ الدَّلالَةُ سَجَّلَتْها المَعاجِمُ في بَقِيَّةِ العُصورِ)
ابن السكيت، إصلاح المنطق. تح: شاكر وهارون، ص: 398.
47. مُحَلِّل
اسم
47 - 1
* المُحَلِّلُ: الفَرَسُ الثّالِثُ الّذي يُحَلِّلُ الرِّهانَ عَلى فرَسَيْنِ؛ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ صاحِبُهُ الرِّهانَ، وإِنْ سُبِقَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ.
"لَيْسَ بِرِهانِ الخَيلِ بَأْسٌ، إِذا دَخَلَ فيها مُحَلِّلٌ، فإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ، وإِنْ لَم يَسْبِقْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ".
مالك بن أنس، الموطأ. تح: محمد مصطفى الأعظمي، ج: 2، ص: 666.
"في السِّباقِ إِذا كانَ الرَّهنُ مِنْ مُتَسابِقٍ جازَ، فإِذا أَدْخَلا المُحَلِّلَ بَينَهما ووَضَعا رَهْنَينِ دونَ المُحَلِّلِ، أَيُّهُما سَبَقَ أَخَذَ الرَّهْنَيْنَ، وإِنْ سَبَقَ المُحَلِّلُ أخَذَهُما، وإِنْ سُبِقَ فلا شَيْءَ عَليهِ: فهُوَ طَيِّبٌ".
الزمخشري، الفائق. تح: البجاوي وآخر، ج: 2، ص: 148.
"فإِنْ شُرِطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُما فلَهُ عَلى الآخَرِ كَذا (...) لم يَصِحَّ إلّا بمُحَلِّلٍ فرَسُهُ كُفْءٌ لفَرَسَيْهِما".
النووي، منهاج الطالبين. تح: محمد طاهر شعبان، ج: 1، ص: 541.
"المُرادُ بِالمَعِيَّةِ مَعِيَّةِ القَصْدِ إِلى الخَيرِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكونَ قامَ مَقامَ المُحَلِّلِ فيَخْرُجُ السَّبَقُ مِنْ عِنْدِهُ أو لا يَخْرُجُ ".
الشوكاني، نيل الأوطار. تح: محمد حلاق، ج: 14، ص: 460.
47 - 2
o ومُحَلِّلُ الرِّياحِ: شَجَرُ الرّازيانجِ.
"مُحَلِّلُ الرِّياحِ: شَجَرٌ يُقالُ لَهُ الرّازيانجُ؛ لِأَنَّهُ يُحَلِّلُ الرِّياحَ، وهُوَ حارٌّ في الدَّرَجَةِ الثّانيةِ يابِسٌ في الأولى (...) وهُوَ يَطْرُدُ الرّياحَ ويُذْهِبُها، ويَفْتَحُ السَّدَدَ ويُدِرُّ البَوْلَ والطَّمْثَ".
نشوان الحميري، شمس العلوم. تح: حسين العمري وآخرَين، ج: 3، ص: 1298.
48. مُحَلَّلِيَّة
اسم
48 - 1
* المُحَلَّلِيَّةُ (عِنْدَ الفُقهاءِ): كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا في تَحْليلِ أَمْرٍ كانَ مَمْنوعًا.
" "ومُحَلَّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثّاني بِحَديْثِ العُسيلَةِ، لا بَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾".
النسفي، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 33.
"فإنَّ هذا الحَديثَ غَيْرُ مَسوقٍ لِبَيانِ مُحَلَّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثّاني".
اللكنوي، قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار. تح: محمد شاهين، ص: 38.
49. مُحَلِّلات
اسم
49 - 1
* المُحَلِّلاتُ: كائِناتٌ حَيَّةٌ مِثْلُ البِكْتيريا وبَعْضِ الفِطْريّاتِ، تُحَلِّلُ أَجْسامَ الكائِناتِ الحَيَّةِ بَعْدَ مَوْتِها، فَتُساهِمُ في تَحْويلِها إِلى مَوادَّ بَسيطَةٍ تُضافُ لِلتُّرْبَةِ. (مح)
"ومِنَ المُؤَكَّدِ عِلْميًّا أَنَّ الأَحياءَ جَميعًا (...) تَتَرابَطُ فيما بَيْنَها في شَبَكَةٍ مِنَ العَلاقاتِ المُعَقَّدَةِ ولِكُلِّ مَجْموعَةٍ مِنْ هذا المُجْتَمَعِ دَوْرٌ هامٌّ تُؤَدّيهِ لأَفرادِ المَجْموعاتِ الأُخْرى (...) ثُمَّ هُناكَ المُحَلِّلاتُ كالبِكْتيريا والفِطْريّاتِ لِدَوْرِها في تَحَلُّلِ الأَحْياءِ بَعْدَ مَوْتِها".
مجلة عالم الفكر، العدد: الرابع، ج: 7، 1977، ص: 131.
50. مَحَلِّيّ
اسم
50 - 1
* المَحَلِّيُّ: ما يَنْسِبُهُ المُتَكَلِّمُ إِلى دَوْلَتِهِ الَّتي يَنْتَمي إِلَيْها، أو مَكانٍ مُعَيَّنٍ فيها كالمُحافَظَةِ أَوِ المَدينَةِ. (مح)
"أَمّا باقي الأَصْنافِ التِّجاريَّةِ التي تُصَدَّرُ مِنَ اللّاذِقِيَّةِ فمِنْها ما هُوَ مِنَ الحَواصِلِ المَحَلِّيَّةِ كالإِسْفِنْجِ والشَّرانِقِ، ومِنْها ما هُوَ مَخْتَلِطٌ مِنَ المَحَلِّيَّةِ ومِنْ حَواصِلِ جِهاتِ جِسْرِ الشُّغورِ وإِدْلِبَ، كالقُطْنِ والصّوْفِ والحُبوبِ".
إلياس صالح اللاذقي، آثار الحقب في لاذقية العرب. تح: إلياس جرير، ص: 181.
51. مَحَلِّيَة
اسم
51 - 1
* المَحَلِّيَّةُ: كَوْنُ الشَّيْءِ مَحَلًّا لِشَيْءٍ آخَرَ.
"نَظيُر الأَوَّلِ بَيْعُ الحُرِّ والمَيْتَةِ والدَّمِ؛ فإِنَّ عَدَمَ المَحَلِّيَّةِ يَمْنَعُ انْعِقادَ التَّصَرُّفُ عِلَّةً لِإِفادَةِ الحُكْمِ".
الشاشي، أصول الشاشي. تح: محمد أكرم الندوي، ج: 1، ص: 374.
"أَلا تَرى أَنَّ نِكاحَ المَحارِمِ لَمّا انْتَسَخَ ولَمْ يَبْقَ مَشْروعًا لَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبًا لِلحِلِّ أَصْلًا؛ لَمْ يَصِرْ حَتَّى شُبْهَةً في سُقوطِ الحَدِّ عِنْدَهُما، مَعَ بَقاءِ المَحَلِّيَّةِ في حَقِّ الأَجْنَبِيِّ".
عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج: 2، ص: 81.
"لا تَقَعُ الفُرْقَةُ بَيْنَ المُكاتِبِ وزَوْجَتِهِ إِذا اشْتَراها لِقيامِ الرِّقِّ (...) ولِأَبي يُوْسُفَ أَنَّ الفُرْقَةَ وقَعَتْ بِمُلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صاحِبَهُ أَوْ بِتَبايُنِ الدّارَيْنِ؛ فخَرَجَتِ المَرْأَةُ مِنْ مَحَلِّيَّةِ الطَّلاقِ، وبِالعِدَّةِ لا تَثْبُتُ المَحَلِّيَّةُ كَما في النِّكاحِ الفاسِدِ".
ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار. تح: عادل عبد الموجود وآخر، ج: 4، ص: 454.
51 - 2
وــــــــــ (في البَلاغَةِ): إِحْدى عَلاقاتِ المَجازِ المُرْسَلِ، يُذْكَرُ فيها المَحَلُّ ويُرادُ الحالُّ. (مو)
"هذا التّأْويلُ مَبْنِيٌّ عَلى اسْتِعارَةِ لَفْظِ البَيْتِ لِلمَدينَةِ (...) وقَوْلُه (أَوْ بَيْتُهُ فيها) بِناء عَلى أَنَّ التَّعْبيرَ عَنْها بِالبَيْتِ عَلى وجْه المَجازِ المُرْسَلِ؛ يَعْني لَمّا كانَتْ بَيْتَهُ في المَدينَةِ، كانَتْ المَدينَةُ كَأَنَّها بَيْتُهُ، لِعَلاقَةٍ بَيْنَهُما في الحالِّيَّةِ والمَحَلِّيَةِ".
عصام الدين إسماعيل وآخر، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي. تح: عبد الله محمود، ج: 9، ص: 14.
"أَمّا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نادِيَهُ﴾ (...) المَقْصودُ بِهِ في الآيَةِ الكَريمَةِ مَنْ في هذا المَكانِ مِنْ عَشيرَتِهِ ونُصَرائِهِ، فهُوَ مَجازٌ أُطْلِقَ فيهِ المَحَلُّ وأُريدَ الحالُّ؛ فالعَلاقَةُ المَحَلِّيَّةُ".
علي الجارم وآخر، البلاغة الواضحة، دار المعارف، ص: 110.
51 - 3
وــــــــــ: كَوْنُ الشَّيْءِ مَحَلِّيّا؛ أَيْ مُنْتَسِبًا إِلى إقْليمٍ أَوْ دَوْلَةٍ.
"لَقَدْ أَحْسَنَتْ نَشْرَةُ الاشْتِراكِيِّ صُنْعًا بِأَنْ فتَحَتِ البابَ لِلتَّفْكيرِ في وَحْدَةٍ فِكْرِيَّةٍ لِلمُثَقَّفينَ العَرَبِ، (...) وكانَتْ نُقْطَةُ المَحَلِّيَّةِ والعالَمِيَّةِ مِنَ هذِهِ المَسائِلِ الفَرْعِيَّةِ الّتي أَشارَتْ إِلَيْها".
سهير القلماوي، مجلة الفكر المعاصر، العدد 11 (يناير) 1966م، ص: 17.
52. مَحْلول
اسم
52 - 1
* المَحْلولُ مِنَ الأَراضي والإقْطاعاتِ ونَحْوِ ذلِكَ: الّتي آلَتْ مِلْكِيَّتُها لِلدَّوْلَةِ لِوَفاةِ صاحِبِها مِنْ دونِ وارثٍ أَوْ لِهُجْرانِها أَوْ مُصادَرَتِها.
"فسارَ في نَواحي كورَةِ إِصْطَخْرَ ومَدَّ يَدَهُ إِلى كُلِّ مَوجودٍ في الإِقْطاعاتِ المَحلولَةِ، وصارَ إِلى السِّيرجانِ، وأَقامَ بِها خَمْسَةَ أَيّامٍ".
مسكويه، تجارب الأمم. تح: سيد كسروي حسن، ج: 7، ص: 27.
"وأُمِّرَ في يَوْمِ الخَميسِ الثّاني والعِشْرينَ مِنَ الشَّهْرِ اثْنانِ بِطَبْلَخاناة، أَحَدُهُما: عَلى ما بَقِيَ مِنَ الإِقْطاعِ المَحْلولِ عِنْدَ تَنَقُّلِ الأُمَراءِ، والثّاني: عَلى إِقْطاعِ الأَميرِ سَيْفِ الدّينِ".
النويري، نهاية الأرب. تح: مفيد قميحة وآخرين، ج: 33، ص: 140.
52 - 2
وــــــــــ: مَزيجٌ مُتَجانِسٌ مُكوَّنٌ مِنْ مادّةٍ مُذيبَةٍ وأُخْرى مُذابَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.
"إِذا وُضِعَ الزَّيْبَقُ في مَحْلولِ البي كلورور في الماءِ صارَ لَوْنُ الزَّيْبَقِ أَغْبَشَ، وتَعَكَّرَ المَحْلولُ".
بيرون الحكيم، الجواهر السنية في الأعمال الكيماوية، تر: محمد بن عمر التونسي، مطبعة بولاق، ص: 168.
53. مَحْلولِيّة
اسم
53 - 1
* المَحْلولِيَّةُ (في القانونِ): كَوْنُ أَمْلاكٍ كالأَرْضِ أَوِ العَقارِ ونَحْوِ ذلِكَ مَحْلولَةً؛ أَيْ آلَتْ لِلدَّوْلَةِ لِهُجْرانِها مُدَّةً مُعَيَّنَةً، أو لِمَوتِ صاحِبِها بِلا وارثٍ.
"احْتَفَظَ المَشْروعُ بِمَبْدَأِ المَحْلولِيَّةِ، وسُقوطِ حَقِّ التَّصَرُّفِ فيما إِذا تَرَكَ المُتَصَرِّفُ العَقاراتِ الأَميريَّةَ الزِّراعِيَّةَ بِدونِ حَرْثٍ أَوْ زَرْعِ بِلا عُذْرٍ مُدَّةَ ثَلاثِ سَنَواتٍ".
القانون المدني السوري، مكتبة محمد حسين النوري، ص: 7.
62. حِلالَة
اسم
62 - 1
* الحِلالَةُ: مِهْنَةُ اسْتِلالِ خُيوطِ الحَريرِ مِنْ شَرانِقِ القَزِّ. (مو)
"ويُمْكِنُ القَوْلُ إِنَّ أَدَواتِ الحِلالَةِ وآلاتِ المَعامِلِ تَتَحَسَّنُ شَيْئًأ فشَيْئًا".
مجلة المشرق، العدد: 06، حزيران 1930، ص: 470.